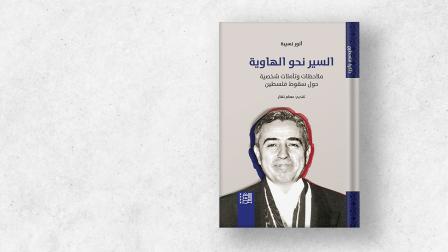تستكمل رواية "الأحقافي الأخير" (دار سؤال، 2020) للكاتب العُماني محمد الشحري موضوعة ثورة ظفار (1965 - 1975) من دون أن يأتي كاتبها على ذكر اسم "ظفار" أو يأتي حتى على أسماء الأماكن التي شهدت أحداثها. ومع ذلك ستضجّ هذه الرواية بأحداثٍ واقعية شهدتها ظفار بالتحديد في سنوات الثورة على الرغم من أن الكاتب يستعير لها اسم "بلاد الأحقاف" المعروفة في التراث العربي، ويسمّي البلدان المجاورة بغير أسمائها الحقيقية، فيحل اسم "الشاردة" محل الشارقة، و"أم الضب" محل أبو ظبي... وهكذا. وقُل مثل ذلك عن أسماء المدن والتضاريس الأرضية المغيَّبة وراء أسماء مستعارة. وحتى الاسم، الأحقافي الأخير، من الواضح أنه حلّ محلّ الاسم الطبيعي المقصود وهو "الظفاري الأخير".
السبب بالطبع هو أنه بعد أن لُجمت ثورة "الحفاة" هذه، حسب تعبير ضابط بريطاني، لُجم الكلام عنها أيضاً. أصبحت تاريخاً من الممنوع الخوض فيه أو توثيقه أو حفظه، أُبعدت وعُزلت، ولم تعد ماثلةً لا في الوعي ولا على صفحات الصحف، إلّا من كتابَين أو ثلاثة كتبها كتّاب عرب من لبنان والعراق عن تاريخها، وإلّا من قصص وروايات كتبها العُماني أحمد الزبيدي (1945 - 2018)، ولجأ فيها في البداية إلى الرمز، ثم أزال هذا الحاجز في رواية "امرأة من ظفار" (2013). وهو ذاته الذي صدّر الشحري روايته بإهدائها إليه بوصفه صديقاً وكاتباً، في إيماءةٍ ربما من طرف خفيّ إلى أنه يستكمل بروايته هذه ما بدأه الزبيدي.
كلّ هذا الإحجام عن تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، مدناً ومناطق وأشخاصاً، سيكون له أثره بالطبع في إحساس القارئ أنه يسير في طرقات الرواية بلا خريطة. وربما سيتخيّل غير الملمّ بطرفٍ من حكاية ثورة ظفار الفريدة من نوعها في منطقة معزولة وسط مربَّع الخوف والجهل والفقر والمرض آنذاك، أنها حكاية متخيَّلة، وربما أفقدها هذا صفة الكتاب الذي رأى فيه صديقه الزبيدي "مدخلاً إلى الحقيقة والتحرُّر". ولكن ما إن يتغلغل القارئ في فصول الرواية، ويجذبه التشويق المعتاد في روايات الإثارة؛ الغموض المتعمَّد، وتأجيل الكشف عن حقيقة تظلُّ معلَّقةً فصلاً بعد آخر، حتى يجد نفسه في قلب مأساة لا تقلّ عُنفاً عن أيّ مأساةٍ إغريقية محكوم على أبطالها، بكلّ جلالهم وعظمتهم، بالسقوط إن عاجلاً أو آجلاً في نهاية مواجهتهم لأقدارهم، السقوط الذي يعرفون أنه آت لا محالة، ومع ذلك لا تنحني قاماتهم.
يتلامح محتوى هذه المأساة منذ الصفحة الأولى في إهداء الكاتب روايته:
"إلى من لا قبور لهم ولا مزارات
هذه الصفحات قبوركم
والكلمات نصبٌ وشواهد".
مع لمسة الغموض هذه التي تهبّ في وجهنا على غير توقُّع، نجد أنفسنا أمام مأساة، لا مجرّد حكاية ثورة، تتجلّى فصولها تدريجياً كلّما أوغلنا في القراءة. فمن هم هؤلاء الذين لا قبور لهم ولا مزارات؟ أيّ هؤلاء الذين يغرقهم الأحياءُ في العدم المطلق من دون حتى إشارة تدل على أنهم كان لهم وجود ذات يوم؟
تبدأ الرواية بتقديم شخص رجل أمن يحتل منصب عميد في دولة تُسمّى "دولة الساحل المتحد"، يتلقّى وشاية من قريب له تتعلّق بمواطن يناقضه حسب قوله في كلّ شيء، في الفكر والثقافة والذوق، يُدعى "نشوان الحمرمي". ونعرف من الحديث بين العميد والواشي في بيت صحراوي أننا في حضرة أحداث معاصرة. يقول الواشي: "بالله يا ولد العم، تعرف الفوضى اللي دخلناها بعد ما يُسمّى بالربيع العربي، أو الخراب العربي بأيدي جماعة الإخوان، ولذلك أتوجّس من بعض المواطنين في الدولة، وميولهم".
 وإثر هذا، يُثار اهتمام العميد بالحمرمي، ويبدأ بالبحث عن كل ما يتعلّق بسيرته. ويضعه تحت مجهر يتقصّى كلّ تفصيل من تفاصيل ماضيه. وينقل هذا البحث القارئ إلى الماضي، إلى سنوات الثورة تحديداً. فنشوان هذا كما يتبيّن العميد مواطن "يماني" الجنسية، حصل بطريقة ما على جنسية دولة الساحل المتحد؛ عمل طيّاراً وأستاذاً جامعياً قبل أن يتقاعد ويتفرّغ للقراءة. ونعرف من عناوين كتب لديه، ومن صور روزا لوكسمبرغ ولوكاتش، أنه يساري النزعة. إلّا أنّ ما يلفت نظر رجل الأمن هو أنه "يشتري سمكاً من بائع من بلاد الأحقاف"، وأنه يحوّل شهرياً مبلغاً من المال إلى حساب من تُدعى "أوفير الأحقافي".. فما علاقته بها؟ ويبرز أمام العميد من يُدعى علي سعيد الأحقافي، فمن هو؟ بهذه الطريقة ينثر الكاتب المزيد من عناصر التشويق، فيعرف القارئ أنَّ هذا الأحقافي شابٌ من قبيلة رعاة أغنام يسافر إلى الخليج للعمل، وينضمّ إلى قوّة الساحل المتحد التي يُشرف عليها الجيش البريطاني.
وإثر هذا، يُثار اهتمام العميد بالحمرمي، ويبدأ بالبحث عن كل ما يتعلّق بسيرته. ويضعه تحت مجهر يتقصّى كلّ تفصيل من تفاصيل ماضيه. وينقل هذا البحث القارئ إلى الماضي، إلى سنوات الثورة تحديداً. فنشوان هذا كما يتبيّن العميد مواطن "يماني" الجنسية، حصل بطريقة ما على جنسية دولة الساحل المتحد؛ عمل طيّاراً وأستاذاً جامعياً قبل أن يتقاعد ويتفرّغ للقراءة. ونعرف من عناوين كتب لديه، ومن صور روزا لوكسمبرغ ولوكاتش، أنه يساري النزعة. إلّا أنّ ما يلفت نظر رجل الأمن هو أنه "يشتري سمكاً من بائع من بلاد الأحقاف"، وأنه يحوّل شهرياً مبلغاً من المال إلى حساب من تُدعى "أوفير الأحقافي".. فما علاقته بها؟ ويبرز أمام العميد من يُدعى علي سعيد الأحقافي، فمن هو؟ بهذه الطريقة ينثر الكاتب المزيد من عناصر التشويق، فيعرف القارئ أنَّ هذا الأحقافي شابٌ من قبيلة رعاة أغنام يسافر إلى الخليج للعمل، وينضمّ إلى قوّة الساحل المتحد التي يُشرف عليها الجيش البريطاني.
ثم يدخلنا الكاتب في مناخ ظفار الفعلي، وفي دواخل هذا الأحقافي حين يعود إلى موطنه، فيتزوج "تماضر" راعية الأغنام، ثم يطلّقها، ويلتحق بثورة "الأحقاف"، ويشكل فصيلاً مستقلّاً. وسنعرف أنّ له أختاً متزوّجة من ابن عمّه راعي الأغنام الذي سيقتله الثوار بتهمة "العمالة للإمبريالية" التي تمنّى أن يعرّفوه بمعناها فقط. ونعرف من خلال سرد للكاتب، وسرد بضمير المتكلّم (الأحقافي)، أهداف هذه الثورة، والصراع بين مكتبها السياسي والثوّار على الأرض. يقول: "مشروعنا السياسي.. لا يقتصر على الأحقاف وحدها، بل يشمل كافّة شعوب الجزيرة العربية التي ترغب في التمتّع بحقوقها السياسية والمدنية والعمل لأجلها". ويتصاعد هذا السرد المباشر، ويصل إلى مستوى التأمّلات التي تستبق الأحداث، فيقول الأحقافي كأنه يتنبّأ بالمستقبل: "ونحن الذين قرّرنا أن نخوض آخر المعارك، نريد أن نقول كلمتنا ونمضي، ونترك للرواة وأصحاب الخيالات المبتورة أن يقولوا كلمتهم، ولا يهمّنا ما يقولون عنّا؛ المهم أننا لم ننتظر ولم نقف في طابور العاجزين".
ويتقاطع مع هذا فصلٌ يكشف فيه "نشوان الحمرمي" عن كونه كان طياراً إيرانياً (أشرف شاهراني) أسقط الثوّار طائرته وأسروه، وعاش معهم لمدة سنتين، فيتعاطف معهم. ونعرف أنه خلال طلعاته الجوية ضرب أُسرة أخت الأحقافي بصاروخ وقتل أطفالها، ولم تسلم إلّا الابنة "أوفير". المهم أن الأحقافي لا يعرف هذا، ويطلق سراحه، ويتوسّط لدى اليمنيّين لمنحه الجنسية.
وفي فصل آخر، يُقدّم الكاتب سرداً عن خطط الضبّاط البريطانيّين في مواجهة الثورة، فيقول أحدهم: "كيف تجرّأ هذا الشعب الحافي غير المنظَّم على إشعال أوّل وأطول ثورة في التاريخ الحديث في الخليج؟ عليه أن يدفع ثمن المحاولة". ويستعين في هذا السياق بالأرشيف البريطاني الذي يكشف سرَّ الصراعات الدموية التي دارت في صفوف الثوّار؛ التصفيات وتخلّي بعضهم عن الثورة.... تقول وثيقة بريطانية: "حينما وصل رجالُنا إلى مراكز التنفيذ في الثورة، أصبحنا نتحكّم بكل مفاصلها، نغيّب من نشاء ونكتب الحياة لمن نشاء".
وأخيراً تتجمع في الفصل السابع خيوط الشبكة التي بدأ العميد الأمني بإلقائها منذ الفصل الأول، باحثاً ليُجيب عن أسئلة من نوع من هذا ومن هذه، فنكتشف أنّ علي سعيد الأحقافي بعد أن طلّق راعية الأغنام "تماضر" يتزوّجها زميله في "فرقة الساحل المتّحد" حميد بن راشد الآنفي، وأن ابنها من الأحقافي الذي نشأ على أنّ الآنفي والده، هو ذاته العميد الأمني. يعرف هذا من أمّه شخصياً فتقول له: "نعم، والدك هو علي سعيد الأحقافي... أنت أحقافي. في البداية كنّا نود أن نخبرك، أنا وعمك حميد، لكن مرضه أجّل مصارحتك... وكنت متردّدة هل أخبرك أم لا؟". فيقول رجل الأمن: "كنت أبحث عن فتاة اسمها أوفير الأحقافي، فإذا بي أعثر على نفسي.. ربما كانت هذه الفتاة أختي".
أمّا بائع السمك من بلاد الأحقاف الذي كشف له أن نشوان الحمرمي كان يشتري منه السمك، فسيعرفنا هذا الأخير به في الفصل الأخير حين يقوم بعد أربعين سنة مرّت على تبدّد الثورة بزيارة إلى الأحقاف بحثاً عن "أوفير" التي كان يرسل لها المال شهرياً تكفيراً عن جريمة قتل أُمّها وإخوتها بصاروخ طائرته قبل أن يسقط بيد الثوّار. وهناك يلتقي ببائع السمك، ويعرف أنه من كان يسمّيه الناس "البطل الأسطوري"، أو سالم بن سلم توأم الأحقافي. فيعرّفه بنفسه، ويسمع منه حكاية اللحظات الأخيرة التي تحصّن فيها الثلاثة، هو والأحقافي ورفيق ثالث في كهف فوق رأس جبل، وخاضوا معركتهم الأخيرة رافضين الاستسلام للبريطانيين. ويحمل نشوان معه وهو يعود من بلاد الأحقاف كلمات الأحقافي الأخيرة التي نقلها له البطل الأسطوري، الناجي الوحيد من تلك المعركة بسبب أنه جُرح، وحين طلب من الأحقافي أن يطلق عليه الرصاص رفض وجرى أسره وسجنه.
تقول كلمات الأحقافي الأخيرة: "على المقاتل الأخير أن يحطّم بنادقنا، البنادق التي لم يسلّمها أصحابها وجب تكسيرها، نهايتها مثل نهاية رفاقها".