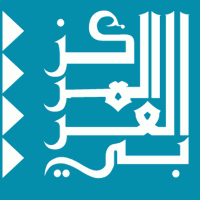آفاق تصعيد المواجهة الشعبية الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي
حجارة الفلسطينيين ضد جنود الاحتلال شمال رام الله (أكتوبر/2015/أ.ف.ب)
أعادت حالة الغليان الشعبي في الأراضي الفلسطينية، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المقدسات واستمرار الاستيطان وفشل مساعي إنهاء الاحتلال وفق إطارٍ زمني محددٍ عن طريق الأمم المتحدة، أعادت طرح سؤال: هل يشهد الوضع السياسي الفلسطيني بوادر انتفاضة شعبية ثالثة؟
وقد شهدت الشهور القليلة الماضية تنامياً في عدد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وتزايد مستواها، كما ترافقت مع إقرار الحكومة الإسرائيلية رزمة من القوانين، لمواجهة أي ردّ فعلٍ فلسطيني محتملٍ على هذه الاعتداءات. وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية بإصدار تصريحاتٍ لم تجد لها صدىً، وقراراتٍ لم تجد طريقها إلى التنفيذ، تنامت خيبة الأمل الشعبية، بعد خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ كان متوقعاً أن يتضمن قرارات أو إجراءات للردّ على ممارسات الاحتلال وسياساته، وذلك بعد أن روّجت جهاتٌ في السلطة الفلسطينية أنّ الخطاب سيكون بمنزلة "قنبلة".
أولًا: أسباب المواجهة الشعبية ودوافعها
تضافرت مجموعة من الأسباب والدوافع التي أدى تزامنها إلى تنامي حالةٍ من الإحباط الشعبي، وتصاعد مستوى المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، أهمها:
1. انسداد الأفق السياسي الفلسطيني
يواجه المشروع الوطني الفلسطيني أزمة انسداد الأفق السياسي، والتي يفاقمها الانقسام المستمر بين حركتي فتح وحماس، على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة بينهما، وتشكيل حكومة وفاقٍ وطني، برئاسة رامي الحمد الله في عام 2014. وفي الوقت نفسه، تبدو خيارات السلطة الفلسطينية محدودة جدًا، إذا بقيت ماضية بالتزامها الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وذلك في ظل واقعٍ إقليمي ودولي، يعزز هذا الانصياع، الأمر الذي يجعلها تراوح مكانها؛ فلا هي تحرز تقدماً، كنتيجة لهذه الاتفاقيات، ولا تتخذ خياراتٍ نضالية تخرج عن إطارها.
وبعد فشل خطة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لاستئناف المفاوضات في إطار ما كان يعرف بـ "اتفاقية الإطار"، وفشل المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، ينتهي في عام 2017، اتخذت السلطة الفلسطينية مجموعةً من الإجراءات ردًا على ذلك، كان أبرزها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي أصبحت عضواً رسمياً فيها في إبريل/نيسان 2015، وأصبح في وسعها إقامة دعاوى ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. كما اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، في الشهر نفسه، ولم يجرِ تطبيقه عملياً بسبب عدم رغبة السلطة في تنفيذه أصلاً؛ ما قوّض جدية هذا القرار حتى باستخدامه تهديداً. ولا تشكو إسرائيل حالياً من أي خللٍ في التنسيق الأمني؛ إذ ظلت السلطة تناور في إطار الاتفاقيات، من دون أن تصل إلى مستوى تحديها جوهرياً، وكلما حانت ساعة المواجهة، كانت السلطة تعود إلى تأكيد التزامها هذه الاتفاقيات.
وقد عوّل الفلسطينيون على مواقف أكثر جديةً في خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتيجة تنامي موجة الاعتداءات الإسرائيلية التي بلغت ذروتها على الأراضي والمقدسات الفلسطينية في هذه الفترة. لكنّ الخطاب جاء مخيبًا للآمال، بعد أن سادت توقعات بأن يعلن عباس عن إلغاء اتفاقيات أوسلو، أو على الأقل العمل بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير وقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل. ولم يأت الخطاب دون المتوقع أو المأمول فحسب، بل انتهى أيضًا إلى عباراتٍ تنمّ عن المناشدة والاستجداء بدل التحدي. كما لم تظهر فيه مواقف وطنية، كان ينتظر الفلسطينيون من قيادتهم الإعلان عنها من منبر الأمم المتحدة. وفضلًا عن ذلك، أعلن عباس قبوله العودة إلى المفاوضات على أساس المشروع الفرنسي؛ ما يحصر دور السلطة الفلسطينية في منع وقوع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوّات الاحتلال في مناطق التماس، والحيلولة دون تطور الأحداث باتجاه مواجهة شاملة مع الاحتلال، تفضي إلى انتفاضة ثالثة.
وقد حذّر عباس في لقائه مع عددٍ من القادة الأوروبيين، قبيل توجهه لإلقاء الخطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنّ عدم العودة إلى المفاوضات واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية قد تفضي إلى انتفاضة "لا تريدها" السلطة الفلسطينية، بعد عشر سنوات من ضبطها الأوضاع. وبعد تفجّر الأوضاع في الضفة الغربية، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية كلها خبر زيارة شخصية إسرائيلية كبيرة محمود عباس الذي وعد، بعد اللقاء، بأنه سيقف ضد انتفاضة ثالثة. وهذا ما صرّح به فعلًا مسؤولون فلسطينيون، عندما تحدثوا عن جر إسرائيل الفلسطينيين إلى مواجهة لا يريدونها. وبهذا يكون مسار السلطة، بقيادة عباس، قد اتضح، وليس من المتوقع أن تصدر عنه مفاجآت، على الرغم من التصعيد الكلامي لبعض معاونيه، من حين إلى آخر.
2. انفلات المستوطنين
بالتوازي مع انسداد الأفق السياسي، كثّف المستوطنون هجماتهم على القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية؛ إذ رصد مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 282 اعتداءً خلال ثمانية أشهر، كان أبشعها الاعتداء على أسرة الدوابشة في قرية دوما في محافظة نابلس، والذي أدى إلى قتل الطفل الرضيع علي الدوابشة وأبويه في حريقٍ متعمّد في منزلهم في يوليو/تموز 2015، فيما نجا طفلٌ وحيد للعائلة يرقد حالياً في المستشفى، ويعاني حروقًا شديدةً. وقد تنوّعت اعتداءات المستوطنين؛ فشملت إحراق المنازل، وعمليات دهس، ورشق الحجارة على سيارات فلسطينيين، والاعتداء على الممتلكات. ونُفِّذ بعض هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال، وكان يمرّ بعضها الآخر من دون عقاب أو محاسبة، إذ أفرجت السلطات الإسرائيلية عن المستوطنين المتهمين بحرق أسرة الدوابشة بعد أقل من 24 ساعة على اعتقالهم. كما قامت قوات الاحتلال بإعدام ميداني لكلٍ من ضياء عبد الحليم وهديل الهمشلون وفادي علوان، بتهمة الشك في محاولاتهم تنفيذ عمليات ضد الجيش على الحواجز الإسرائيلية المقامة على مداخل المدن الفلسطينية.
وعملت حكومة نتنياهو أيضاً على تنظيم اقتحامات المستوطنين والجنود المتطرفين والحاخامات اليهود ووزراء من الحكومة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وتمويل ذلك وتشجيعه؛ وبلغت 45 اعتداءً في الربع الثالث من عام 2015، وكان أبرزها اقتحام نائب رئيس الكنيست، موشيه فيغلن، الحرم القدسي وتحطيم الأبواب والنوافذ التاريخية للمسجد. ونتيجة سياسة الاقتحامات وسياسات المنع التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه من يدخلون المسجد الأقصى، أصبح مشروع القرار الذي يُتيح تقاسم المسجد الأقصى، زمانيًا ومكانيًا، بين اليهود والعرب أمراً واقعاً على الرغم من أنّ المشروع لم يجرِ التصويت عليه، ومن ثمّ لم يجرِ إقراره في الكنيست حتى الآن.
3. استمرار "المقاومة الفردية"
استمرت "المقاومة الفردية"، أو ما يسميها التقرير الإستراتيجي السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي لعامي 2014-2015، ظاهرة "الذئاب المنفردة"، وشكّلت قفزةً في التعبير عن الغضب الشعبي عبر الفعل الوطني المقاوم، وذلك في ظل حالة التردي الحزبي الفصائلي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية. وأقرّت الحكومة الإسرائيلية إجراءات وقوانين، في محاولة للتصدي لهذا التطور النوعي في عمل المقاومة الشعبية الفلسطينية، أبرزها السعي إلى تشريع قانون سحب حق الإقامة من سكان القدس الذين ينفذون عمليات ضد إسرائيل، وكذلك سحب إقامة أهاليهم، وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية، وتصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي في نهاية ديسمبر/كانون أول 2014 على خطة لتكثيف الوجود العسكري بشكلٍ دائمٍ في مدينة القدس المحتلة، والحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب فيها. وتنصّ الخطة على تعزيز قوات الشرطة بـ 400 عنصرٍ، وتحديث الوسائل التكنولوجية التي في حوزتها؛ إذ لم تعد الوسائل التقليدية القائمة على المعلومات الاستخباراتية وسيلة ناجعة في مواجهة هذه الأعمال التي يصعب التنبؤ بها، أو السيطرة عليها.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات المترافقة مع رفع مستوى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، جرى تنفيذ عمليات داخل مدينة القدس منذ بداية عام 2015، وكان آخرها عملية الشهيد مهند حلبي. وأهم ما يميّز هذا النوع من مقاومة الاحتلال، عدا صعوبة رصده وتوقعه، أنه يجري خارج نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية التي تحول دون وقوع انتفاضة شعبية.
وقد شجعت عمليات المقاومة الفردية في القدس على القيام بعمليات نوعية أيضًا ضد المستوطنين داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، مثلما حدث في عملية مستوطنة إيتمار قرب مدينة نابلس. ورافقت ذلك هباتٌ جماهيرية واشتباكات بالحجارة على حدود المدن الفلسطينية التي تشكّل مناطق تماسٍ مع القوات الإسرائيلية، والمستعمرات المقامة على أطراف المدن (رام الله، ونابلس، وطولكرم، وجنين وغيرها)؛ إذ شهدت رام الله مواجهات قرب مستعمرة بيت إيل القريبة من مقر المقاطعة؛ الأمر الذي كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمنعه في الماضي القريب. وترافق هذا الفعل الجماهيري في الضفة الغربية والقدس مع عمل جماهيري مكمّلٍ وموازٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في عدد من المدن والبلدات (مثل يافا والناصرة والجليل والطيبة) ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.
ثانيًا: ردود الأفعال على تصاعد المقاومة واحتمالات تطورها
سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة حالة الغليان في الضفة الغربية والقدس، وكانت جراءات العقابية، أبرزها: تسريع سياسة هدم منازل منفذي العمليات، والدفع بقوات كبيرة إلى مدينة القدس وأحيائها تحت شعار "لن تكون هناك حصانة لأحد في أي مكان"، ومطالبة نتنياهو بالتحقيق مع التجار المقدسيين الذي كانوا في محالهم التجارية، عند تنفيذ عملية قتل المستوطنين التي نفذها مهند الحلبي في البلدة القديمة. وقد حصل ذلك كله في وقتٍ لم تخرج فيه القرارات الرسمية الفلسطينية عن إطارها التقليدي، فقد أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن تأييدها الكامل للإستراتيجية الفلسطينية التي أعلنها عباس في خطابه، بما يشمل تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني من وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال، وضرورة تأمين الحماية للشعب الفلسطيتني واستمرار الجهد لإنهاء الانقسام.
وبناء عليه، وفي ظل تنامي حالة الإحباط وتصاعد مستوى الغضب الشعبي، واستمرار إسرائيل ومستوطنيها في الاعتداء على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وعجز السلطة الفلسطينية عن الاستجابة للمطالب الشعبية بالخروج من متاهة المفاوضات الفاشلة وانتظار التسوية المزعومة، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، ومنع أعمال المقاومة، يبدو المشهد السياسي الفلسطيني أمام أحد الاحتمالات التالية:
- أن تتوسّع حركة الاحتجاج الشعبية لتشكّل هبةً شاملةً تضم الأراضي الفلسطينية كافة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وهنا، تقف السلطة الفلسطينية أمام خيارين؛ مواجهة هذه الحالة بقبضة أمنية شديدة وتنسيق أمني عالي المستوى مع إسرائيل، كما هو معهود، ترجمةً لما صرّح به مسؤولون فلسطينيون، في مقدمتهم رئيس السلطة، بأنهم لن يقبلوا باندلاع انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية، ويعني ذلك امتداد المواجهة لتطول السلطة الفلسطينية نفسها، في ظل عدم تغير المعطيات على الأرض. ويتمثل الخيار الثاني في دعم السلطة الانتفاضة كما فعلت عام 2000، لوضع إسرائيل أمام واقع فلسطيني جديد، ووضع العالم أمام مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والسماح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. ويبدو هذا مستبعدًا حالياً لأنّ السلطة الفلسطينية الحالية تعارض تماماً نهج ياسر عرفات في الانتفاضة الثانية وتعدّه كارثيًا، كما أنّ عقيدة أجهزة الأمن ليست عقيدة مواجهة مع إسرائيل، بل "مكافحة الإرهاب".
- انحسار حركة الاحتجاج وتراجعها أمام القبضة الأمنية الشديدة للسلطة الفلسطينية والاحتلال الذي بدأ باتّباع أساليب عقابية جديدة ضد الفلسطينين. لكنّ هذا الأمر لا ينهي الأزمة؛ فالشباب الفلسطيني الذين يقاومون، حالياً، قد ولدوا بعد اتفاقية أوسلو، وهم يقاومون في أصعب الظروف، وهم يتحدّون حالةً عربية وفلسطينية رسمية أبعد ما تكون عن المواجهة مع إسرائيل.
- استمرار شكل المقاومة الحالي، واتساع نطاقه على شكل أعمال فردية وصدامات مع المستوطنين في نقاط التماس؛ لأنّ السلطة الفلسطينية وانعدام وحدة العمل الفلسطيني يحولان دون تطور هذه المواجهات إلى انتفاضة شعبية، ولأنّ الصمت على فشل المسار السياسي بموازاة التصعيد الاحتلالي أصبح غير ممكن.
ويعني هذا أنّ مرور الوقت لا يحلّ القضية ولا يخمد المقاومة الفلسطينية. ونحن نرى أنّ تدمير حلّ الدولتين بالاستيطان الإسرائيلي لا يحوّل السلطة الفلسطينية إلى دولة، وفي الوقت نفسه، فهي ترفض أن تتصرف كحركة تحرر؛ ما يدفع إلى أنماطٍ نضالية جديدة في ظروف نظام فصلٍ عنصري (أبارتهايد)، وسوف يدفع حتماً إلى برامج سياسية جديدة، تتجاوز الخطاب المأزوم السائد حاليًا.