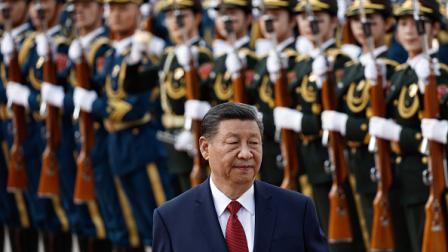أقرّ مورو بالحاجة إلى تعديل الدستور (أمين الأندلسي/الأناضول)
خمس سنوات مرّت على كتابة الدستور التونسي والتصويت عليه بأغلبية ساحقة من المجلس الوطني التأسيسي، مع ذلك، وعلى الرغم من الأبعاد التقدمية التي رحبت بها الأوساط الديمقراطية في العالم، إلى جانب التغييرات الهامة التي أحدثها الدستور الجديد في النظام السياسي وفي حياة التونسيين، إلا أن أطرافاً عدة رأت أن "تونس تمرّ حالياً بأزمة حكم، وأن الدستور مسؤول عن ذلك، وأن الوقت قد حان للعمل على تعديله، حتى لا تصل تونس إلى الفوضى السياسية الشاملة".
أسباب عدة أدت إلى طرح فكرة مراجعة الدستور، لكن في السياق الراهن هناك عاملان أساسيان استند عليهما أصحاب هذه الرغبة. العامل الأول متعلق بالصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وهو صراع له أسباب متعددة، في مقدمتها الصلاحيات الكبرى التي وفّرها الدستور لرئيس الحكومة، مما حدّ من سلطة رئيس الجمهورية الذي وجد نفسه مقيداً وغير قادر على التحكم في رئيس الحكومة، ظناً منه أنه سيبقى خاضعاً لسلطته المعنوية. لهذا السبب، عبّر الرئيس الباجي قائد السبسي، في أكثر من مناسبة، عن نقده للدستور، لكونه جعل رئيس الدولة المنتخب مباشرة من الشعب غير قادر على ممارسة الحكم، بسبب تغوّل مهام رئيس الحكومة غير المنتخب.
أما العامل الثاني الذي يقف وراء المطالبة اليوم بمراجعة الدستور، فمتعلق بحركة النهضة، أكبر أحزاب البلاد، كونها تواجه رغبة واسعة من أطراف سياسية واجتماعية للحدّ من نفوذها والعمل على إخراجها من السلطة. ويعتبر الهدف الرئيسي الذي يمكن أن يوحّد هؤلاء الخصوم، بما في ذلك حزب رئيس الوزراء يوسف الشاهد (تحيا تونس)، هو خلق أغلبية برلمانية تُمكّن قيام حكومة، من دون اللجوء إلى حركة النهضة. ويعتبر الداعون إلى مراجعة الدستور أن "جوانب عدة في النص الدستوري تحتاج إلى تعديل، حتى يمكن حشر النهضة في المعارضة أو الدفع بها نحو الانفراد بالحكم لفترة معينة، يجعلها تتورط فيما سيترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية قد لا تكون قادرة على تحمّلها. وهو ما من شأنه أن يؤلب عليها الرأي العام الداخلي وكذلك الأطراف الدولية".
واعتبر مورو، أحد أركان حركة "النهضة"، أن "الهدف من الدستور كان الحدّ من سلطة الدكتاتور، في حين أن المطلوب هو تقوية السلطتين التشريعية والقضائية، مع إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني لتعزيز الرقابة، من دون اللجوء إلى تقسيم السلطة التنفيذية". ولفت إلى أنه "أحدثنا مؤسسات جديدة ومكنّاها من الصلاحيات، لكنها متضاربة". وضرب مثالاً على ذلك بالقضاء الذي أصبح سلطة مستقلة مالياً وإدارياً، حتى بدا وكأنه دولة داخل الدولة. والأمر نفسه حصل مع هيئات أخرى مثل "الإعلام، أو هيئة الحقيقة والكرامة، التي عملت من دون مراقبة".
ومع تأكيده احترامه للقضاة والإعلاميين وتمسّكه بالعدالة الانتقالية، إلا أن مورو أبدى خشيته من "أن تؤدي التجربة إلى تضارب المؤسسات، بسبب كوننا لم نعتمد الواقعية عند وضعنا لنص الدستور، فجاءت التجربة لتكشف عدم صلتنا بالواقع، وبأهمية المحافظة على وحدة الدولة وتكامل المؤسسات المنضوية تحتها".