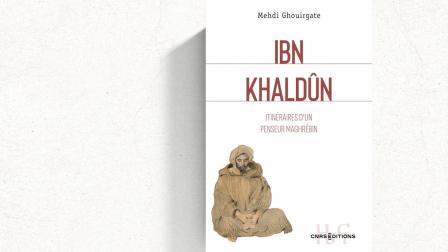في روما، ذهبت إلى حديقة فيلا بورغيزي لمشاهدة تمثال أحمد شوقي. لم تكن في روما فيَلة تجوب الشوارع والمقاهي، أو سعادين تنط في الساحات. فقط، شربت الإكسبرسّو في "مقهى باريس"، وانطلقت أبحث عن العمارة الرومانية القديمة... عن ربطات العنق والبابيون الكشمير بألوانها القرمزية والزرقاء والبنّية، وأتفرّج على أغلفة وجلود الكتب الجديدة في واجهات المكتبات.
وفي فيتربو زرت حديقة بومرثو، لغز عصر النهضة، بآلهتها الحجرية الخالدة للصمت منذ قرون. بومرثو الشاهدة على عصور الغرب الملحمية. بومرثو صنوة تاج محل، فقد شيّدها صاحبها تخليداً لذكرى حب مرير.
وفي قرطاجنّة ذهبت ذات ظهيرة إلى ذاك الركن السرّي فوق ربوة بيرصة حيث معبد زحل الذي كان يزوره أعضاء المحفل الماسوني في تونس أوائل القرن العشرين؛ المحفل المتشكل من إيطاليين وفرنسيين وتونسيين لأداء طقوسهم السرية في ليالي محاق القمر. قال لي القاضي المازري: "لم يكن في تونس بين الحربين من يتولى الوزارة دون الانتماء إلى الماسونية"، ثم عقّب وهو يخفض صوته: "بورقيبة ماسوني".
في معبد زحل، وجدوا اللوحة الوحيدة في العالم التي تروي قصة المستكشف الفينيقي حنون في القرن الرابع قبل الميلاد الذي أبحر من الميناء البونيقي حتى خليج السوس جنوبي المغرب. وقرطاجنة مرتبطة بصورة الطوفيت؛ مقبرة الأطفال المُسجّين في ظلال الأشجار الداكنة. الأطفال الذين كانوا يحرقونهم تقرباً للآلهة الفينيقية، هكذا ادعى المؤرّخون اليهود.
في إسطنبول، وفي تلك الأمسية الزرقاء، نزلتُ وسط الجموع إلى كنيسة القديسة إيرين تحت الأرض في حدائق قصور توبكابي (الباب العالي). كانت فرقةٌ سيمفونية تعزف ألحاناً دينية لباخ. ويعودني كالحلم مجمع المياه الذي بناه قسطنطين وجعل رأس الميدوزا المنقلب حارساً لذلك المكان العجائبي وسط المياه المظلمة. آه صور غرائبية تتداخل في الذاكرة.
مشهد القاهرة ليلاً عندما وصلت بالقطار اليوغسلافي القادم من الإسكندرية إلى محطة باب الحديد. أوّل شيء باغتني اكتظاظ الشوارع بالمارّة وأضواؤها البرتقالية وإسفلتها شديد السواد وسيارات التاكسي فيات نصر الصغيرة البيضاء والسوداء.
وأستعيد كما في الحلم المرأة السمراء فارعة الطول ذات ملامح "بنات بحري" نساء الرسام محمود سعيد؛ المرأة ذات الوجه الوسيم المتعب تجلس كامل الوقت في قاعة استقبال فندق مينيرفا الذي اتخذته سكناً، والتي لا تكفّ عن التدخين وإرسال الأوامر بفرنسية متعالية إلى السفرجية تذكرني بسلمى التونسية، في ليالي الصيف، في قصرها بسيدي بوسعيد، وهي تغيب لحظة ثم تدخل علينا الصالون مرتدية الزي الرسمي الذي كان يرتديه أبوها الياوران في المناسبات الرسمية بنياشينه وبأزراره و تطريزه الذهبي، والذي يغطي كامل الصدر في مشهد سريالي وتقرأ علينا قصيدتها الفريدة؛ "الناقة البيضاء"، وهي في حالة ذهول. استمرت المرأتان في العيش في عصرهما الكولونيالي المتخيل.
وزغوان القرية الأندلسية أحب أن أذهب إليها وأن أزور معبد المياه في مساءات الخريف عندما تمتزج حمرة الشمس بغيوم الغروب الزرقاء الداكنة وتهبّ ريح في تلك البراري التي تقطعها الحنايا الرومانية. لا أزال أذكر البطاقة البريدية القديمة بالأسود والأبيض تمثل صورة البدوي فوق حماره وطرف عمامته المهتز في الريح وسط مراعي "أفريكا" تحت السحب التي شهدها "يوما" أبوليوس المداري وهي تعبر الوهاد الخضراء...
* شاعر من تونس