08 فبراير 2019
الزواج الديني قاعدة و"المدني" استثناء
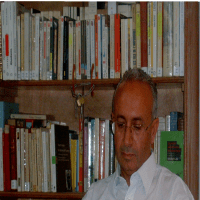
ناجي الخطيب
باحث وأكاديمي فلسطيني يعيش في فرنسا وإيطاليا. كتبَ عشرات المقالات الصحافية والبحوث وآخر كتابين صدرا له هما: "التعددية الفكرية والمنهجية: المنقذ من الضلال"، 2016 و"الجندر أو النوع الاجتماعي المعولم"، 2015.
زفاف مدني جماعي لإسرائيليين وروس في قبرص (19/6/2015/فرانس برس)
قدّم برنامج "الحملة من أجل دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين"، والذي نُشر في أغسطس/ آب 2018 تصوراً عاماً لقضايا الحقوق الفردية والجماعية، والتي سوف تتكفل الدولة الدستورية المنشودة بحمايتها. ويتضمن إشارة مهمةً إلى تفصيل قد يبدو عابراً، وإن يكتسب، على ضوء النقاش الحالي في لبنان بخصوص الزواج المدني، أهمية استثنائية.
تقول تلك الإشارة الدالّة: "… وبالإضافة إلى الزواج الديني، توفّر الدولة إمكانيات للزواج المدني لمن يرغب بذلك". هكذا هي إذن، الدولة الديمقراطية الواحدة سوف تعتمدُ أساساً مؤسسات وقوانين الزواج الديني، وبكرم ديمقراطي حاتمي واضح، سوف توفر مؤسسةً وقانوناً وتشريعاً للزواج المدني "لمن يرغب بذلك". هذا بالضبط ما فعله لبنان، باعتماد الزواج الديني والطائفي قاعدةً مع تسهيلات لمن يرغب بالزواج المدني خارج لبنان، باعتماد عقد الزوجية المدني الأجنبي جزءاً من العقود الرسمية المُعترف بها لبنانياً، وبالسماح لمن يُزيل من أوراقه الثبوتية بند ديانته، لكي يتمكّن من توفير مصاريف الانتقال إلى الخارج، ولعقد قرانه وقرانها داخل البلاد.
صحيح أن قبرص للزواج المدني هي على المسافة نفسها من لبنان وفلسطين. لكن ولضرورات ديمقراطية ما، سوف تعمل الدولة الواحدة على توفير إمكانيات إبرام عقود الزوجية المدنية داخل حدود الدولة الديمقراطية، من دون تكبد عناء السفر وتكاليفه، أو التنازل عن إشهار ديانته ومذهبه وطائفته في أوراقه الثبوتية أمام القاضي، أو مختار الحي أو الكاتب العدل (إذا ما كان سوف يُشار لها ويا للهول كما في الحالة اللبنانية، وهذا ما نستبعده لحسن الحظ بقوة)!
عقد هذه الصلة ما بين نص برنامج "الحملة" وما يشهده لبنان، يسترعي الانتباه، ويطرح جملةً من الاستفسارات التي لا بدّ من أن توضحها "الحملة"، لكي لا تتحول "الدولة الديمقراطية
الواحدة" إلى "لبنان" جديد، ولبنان بلدٌ كان يُقالُ زوراً بأنه ديمقراطي فيما لم يكن أكثر من كونفدرالية طوائف.
ما يشهده لبنان، منذ بعض الوقت، وما بات يُعرف بأزمة الزواج المدني في مواجهة الزواج الديني – الطائفي، القاتل للحريات الفردية، باسم الدفاع عن الحقوق الجماعية للطوائف والمجموعات الدينية المختلفة، ليس سوى تعبير عن سيطرة ممثلي الطوائف على مقدّرات أبناء طوائفهم وبناتها ومصائرهم، فهو ليس حق الطوائف، وإنما بالأحرى حق نخبها، الناطقة باسمها، في ضبط سلوك أفرادها، وردعهم ومنعهم من مزاولة حقوقهم الإنسانية الأساسية بالحب وبالارتباط برفيقٍ وبرفيقة درب في مؤسسة الزوجية وتكوين العائلة، عماد المجتمع وركيزته الأولى.
هنا، من الطرافة بمكان أن تجد تعبيرات من هذا القبيل في برنامج "الحملة من أجل دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين"، وهي، وإن صيغْت ضمن شروطٍ مختلفة، تظلُ متقاطعةً معها في الجوهر، في معرض الحديث عن الدفاع عن الحقوق الجماعية، وعن تلك الحقوق الفردية، وكأن "الحقوق" يمكن أن تتجزأ، حقوق تتعارضَ فيها هذه "الجماعة - الطائفة" مع تلك، جارّة أفرادها إلى النأي بذواتهم عن فردانيتهم (واحتياجاتهم العاطفية) باسم الدفاع عن جماعتهم، وتماسكها في مواجهة أفراد الجماعة المواجِهة، وإن كان هؤلاء "الأغراب" موضوعاً لعواطفهم الجياشة، ولرغباتهم في تكوين أسرةٍ سعيدةٍ معهم ومعهن.
في "مجتمع الحرب الأهلية الدائمة" هذا، أين هو موقع الدولة، أين هي "دولة جميع مواطنيها"، أم نحن أمام دولةٍ طائفيةٍ رثّة وفاشلة؟ لا يمكن أن تتجاوز الحقوق الخصوصية للجماعات حقوقاً ثقافية ومعتقدية، ولا يمكن ترجمتها بحقوقٍ تسمحُ ببناء مؤسسات وأجهزة وتنظيمات وقوانين خصوصية بها، إذ لا موقع لهذه الأشكال التحزبية الضيقة في دولة القانون الذي يعلو فوق مكوّنات المجتمع المختلفة، وهذا هو جوهر الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، دولة يتساوى فيها الأفراد، بصفتهم الفردية والجمعية - الخصوصية في بوتقة المواطنة المشتركة، والتي لا تضع تمايزاً ما بينهم، وفقاً لانتماءاتهم الجنسية والجندرية، الدينية، الطائفية، المعتقدية، الثقافية أو العرقية.
بالطبع، لا يتحدث برنامج "الحملة" صراحةً عن وجود تعارض ما بين الحقوق الجمعية
والحقوق الفردية، وإنما يُميّز ما بينهما في معرض حديثه عن حمايتهما، ما يجعل منهما كأنهما في تعارض ما. وتعارضهما هذا لا يتصل من قريب أو بعيد ببنية دولةٍ حديثةٍ ديمقراطيةٍ بحق. الدولة الديمقراطية تحمي حقوق الفرد بصفته فرداً، كما تحمي حقوق الجماعة بصفتها تلك، وبصفتها مجموعةً بشريةً لأفرادٍ يتقاسمون هوية ثقافية خصوصية.
هذه الهوية الثقافية، وما تتضمنه من "تمثلات" لمفاهيم الحريات والحقوق والواجبات التشاركية والفردية تجد في الدولة الديمقراطية أرضيتها الجمعية الصلبة، وتتعزّز بمزيدٍ من القوة في ظل النظام الاجتماعي العلماني، والذي هو بمثابة "أسمنت" ولُحمة أواصر العيش المشترك (فيما قد تتحول هذه الهويات في نظام استبدادي إلى هوياتٍ متقاتلةٍ وقاتلة). ترتبط البنية السياسية لدولة ديمقراطية عضوياً بالفكرة العلمانية (توكڤيل). وهذا هو جذر المبدأ الديمقراطي في المواطنة المتجرّدة من الخصوصيات الطائفية، الدينية والقومية في ظِلِ دولةٍ ذات نظام سياسي ديمقراطي تعاقدي، ونظام علماني اجتماعي (قانون الأحوال الشخصية المدني واحد، وليس هناك قوانين خصوصية لكل مجموعة دينية أو قومية، الكلمة الأخيرة والصلاحيات الواسعة للمحاكم المدنية، وليس للمحاكم الشرعية، الكنسية والحاخامية).
الدولة الديمقراطية لا يمكنها أن تكون ديمقراطية حقة من دون أن تكون علمانيةً أيضاً، وهذا من شأنه حماية الأقليات، بصفتها الجمعية والفردية، ومنحها حقوقها الثقافية وحرية ممارسة شعائرها الدينية من دون أن تسمح لها بإقامة تنظيماتٍ سياسيةٍ، حصرية الانتماء الديني و/أو القومي. وعندما يتحدّث برنامج "الحملة" عن "حرية التنظيم" الذي يكفله الدستور للمجموعات الخصوصية والأقليات، ما كان إلا أن يُفهَمُ منه سوى حرّيتها في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية الناطقة باسمها.
بمواجهة هذا النقد للبرنامج في هذه النقطة (وهو ما عبرتُ عنه في رسالتي المنشورة على صفحة "فيسبوك" للحملة)، كان الرد بالنفي، إذ جرى شرح القصد بخصوص ذلك بأن "البرنامج ينص على حرية التنظيم، على أسسٍ قومية... ولكن ليس المقصود تنظيماً سياسياً، حزبا أو حركة سياسية قومية، أو إثنية، أو دينية، إنما احترام الخلفية الثقافية للمجموعات
والأفراد، مثل اللغة والعادات وغيرها". هنا، هل هي الدلالة السياسية الحصرية لعبارة "حرية التنظيم" هي المسؤولة عن هذا الالتباس؟ ولكن وإن افترضنا ذلك، تظلُ عبارة "حرية التنظيم" تعبيراً مشحوناً بدلالاتٍ سياسية، ولا ترتبط بقضاياً ثقافية، ومن النادر أن نتحدّث عن "حرية التنظيم الثقافي"، أو اللغوي، فيما قد نتحدث عن "تنظيم الأقليات لحياتها الثقافية، التربوية، المسرحية…" وما هما بِسِيَّان.
لا نعود إلى نقد برنامج الحملة لتضمّنه خبايا وجهة نظر في "ثنائية القومية للدولة المنشودة" تحت ستارٍ كثيفٍ من الحديث عن الثقافة والتعدّدية الثقافية، والتي لا بدّ من أن تحترمها الدولة الديمقراطية الواحدة. وهذه القفزة من "السياسة" إلى "الثقافة"، بخصوص حرية المجموعات الخصوصية، تُعيدنا إلى ما بدأت به هذه المقالة: هل مؤسسة الزواج الديني كقاعدة و/أو كاستثناء هي قضية سياسية أم ثقافية؟ هذا هو السؤال المركزي، المتمنّى من القائمين على "الحملة" توضيحه.
من الحق أن يُقال إن ليس هناك من مشكلةٍ مع منح التجمعات اليهودية الكبرى، عندما تكون أكثرية متجانسة في منطقة ما، شكلاً من أشكال الحكم الذاتي الثقافي، لكي يمارس المواطنون فيها لغتهم وثقافتهم الخاصة، إذ لا يصح إلزامهم بتغيير اللغة المتداولة في هذا الحي أو ذاك.
"الدولة العلمانية الديمقراطية في فلسطين" هي الدولة التي سَتُقر بهذا الحق المبدئي لهذه المجموعة المميزة، والتي هي، وعلى الرغم من تمايزها الثقافي، تبقى عنصراً تكوينياً لدولة مواطنة قائمة على مبدأ منح جميع مواطنيها حقوقهم، بما فيها حقوقهم الثقافية واللغوية والمعتقدية، ولن تقوم بعملية "تعريب قسري" لهم.
الاعتراف باللغة العبرية (إلى جانب اللغة العربية لدولة فلسطين العلمانية) هو اعتراف بالحق بممارستها في الحياة الثقافية، وفِي الإنتاج الأدبي، وفِي معاملاتهم فيما بينهم في حياتهم اليومية. وبالتالي، هذا يعني اعترافاً بهوية ثقافية خصوصية لمجموعة من المواطنين من رعايا الدولة العلمانية. بالطبع، ليس الحديث هنا عن هذه التجمعات الخصوصية، ثقافياً ولغوياً، كمجموعاتٍ "قومية" أو كشعب أو شعوب، بل عن مجموعاتٍ من المواطنين، ممن هم ذوو الحق باختيار لغتهم وثقافتهم (إذا ما اختار الأشكناز اللغة العبرية المستحدثة، قد يختار بعض اليهود العرب المزاوجة بين اللغتين، أو اختيار واحدة منهما، بما يحمل هذا من احتمال اختيار اللغة العربية).
المساواة ما بين المواطنين من دون تمييز ما على أرضية اللون، أو المعتقد الديني، أو اللغة، أو الثقافة، هي أيضاً مساواة تقوم على الاعتراف بالتمايز والاختلاف، وليس طمساً أو تغييباً قسرياً للتمايز، وهذا ما يعطيها طابعها التقدّمي. الإقرارُ بالاختلاف وبالتعدّدية، والنظر إلى المساواة على أرضيتهما، يجعل من الحق بالمساواة، في الوقت نفسه، الحق بالخصوصية المتمايزة.
تعبير "الحكم الذاتي الثقافي" هو من وجوه الديمقراطية الحداثية المتخلصة من المقاربة "اليعقوبية" للديمقراطية، تلكَ المستمدة من تراث الثورة الفرنسية. هذه الديمقراطية الحداثية
لامركزية، ولا تسعى أصلاً إلى استقطاب مكوناتها المجتمعية وصهرها ضمن قوالب مركزية أحادية ومتجانسة، من حيث اللغة والثقافة.
من شأن هذه الممارسة السياسية (والبنية اللامركزية للدولة وللمجتمع) أن تتيح لجميع مكونات المجتمع المدني ممارسة ثقافاتها ولغاتها "محلياً. وهذا لا يعني إطلاقاً منحها حقوق انفصال عن المجتمع الكلي، أو عن الدولة. وبالتالي، ليس "الحكم الذاتي الثقافي" حكما ذاتياً سياسياً مانحاً لها الحق بتقرير المصير، وصولاً إلى الحق بالاستقلال السياسي، وبناء كياناتٍ دولتية - إثنية، وإنما هو منح هذه التجمعات المحلية حقوقاً ثقافية، لا هي سياسية، ولا يمكن لها أن ترتقي إلى مبادئ الحق بتقرير المصير.
على سبيل المثال لا الحصر، مدرسة في حي يهودي، لها الحق باستخدام اللغة العبرية شكلاً من أشكال الحكم الذاتي في حقل التعليم. مسرح يهودي في حي يهودي، إدارته المتمتعة بقراراتها "السيادية" بخصوص اختيار ألوانها المسرحية وفرقها وخياراتها "الجمالية"، هو من أشكال ممارسة الحق بالحكم الذاتي المحلي. حضور إعلام وصحافة وسينما وقنوات تلفزيونية بالعبرية هو من أشكال هذه الممارسة العملية للحق بالحكم الذاتي الثقافي. هذا هو ما يمكن أن تكون عليه "الثقافة" في مجتمع تعدّدي، ديمقراطي في ظل نظام سياسي اجتماعي علماني…
استطراداً، من الضرورة بمكان أن تكون هناك إجابة شافية فيما يخص "قانون الأحوال الشخصية"، فهل هو معطىً ثقافي أم سياسي؟ وهل ستكون لكلِ مجموعة خصوصية قانونها الخاص لتنظيم شؤونها الشخصية؟ وهل ستطبق الدولة الديمقراطية نظام المحاكم الطائفية اللبناني، بتنوعاته المختلفة، لكي تتعايش المحاكم الشرعية مع المحاكم الكنسية والحاخامية؟ وكيف ستتعاطى هذه الدولة، إن لم تكن علمانية الجوهر، مع حقوق النساء المهضومة في الخلية الأسرية، وهل ستطبق اتفاقية سيداو على العائلة المسلمة، كما على العائلة المسيحية، والعائلة اليهودية (ولاية الأمر، الطلاق، الإرث، التبنّي، النفقة، حضانة الأطفال بعد الطلاق…)؟ وهل ستغضّ النظر عن اضطهاد النساء في تجمعاتهن القومية و/ أو الدينية، بحجة احترام خصوصيات ثقافية مفروضة بقوة "الدستور"، والذي قد يكون في الغالب ذكورياً بامتياز؟
أخيراً، حريّ القول إن "المنظومة المعيارية للقوانين" سياسية بالدرجة الأولى، وهي الإطار الأيديولوجي للممارسة الحقوقية للجهاز القضائي: أحد أعمدة الدولة والمجتمع.
الإجابة على جملة التساؤلات هذه، ضرورة حيوية، لكي لا تبدو "الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين" إعادة إنتاج لنموذج لبناني طائفي فاشل، ولا يَمُتُ إلى الديمقراطية بصلة.
صحيح أن قبرص للزواج المدني هي على المسافة نفسها من لبنان وفلسطين. لكن ولضرورات ديمقراطية ما، سوف تعمل الدولة الواحدة على توفير إمكانيات إبرام عقود الزوجية المدنية داخل حدود الدولة الديمقراطية، من دون تكبد عناء السفر وتكاليفه، أو التنازل عن إشهار ديانته ومذهبه وطائفته في أوراقه الثبوتية أمام القاضي، أو مختار الحي أو الكاتب العدل (إذا ما كان سوف يُشار لها ويا للهول كما في الحالة اللبنانية، وهذا ما نستبعده لحسن الحظ بقوة)!
عقد هذه الصلة ما بين نص برنامج "الحملة" وما يشهده لبنان، يسترعي الانتباه، ويطرح جملةً من الاستفسارات التي لا بدّ من أن توضحها "الحملة"، لكي لا تتحول "الدولة الديمقراطية
ما يشهده لبنان، منذ بعض الوقت، وما بات يُعرف بأزمة الزواج المدني في مواجهة الزواج الديني – الطائفي، القاتل للحريات الفردية، باسم الدفاع عن الحقوق الجماعية للطوائف والمجموعات الدينية المختلفة، ليس سوى تعبير عن سيطرة ممثلي الطوائف على مقدّرات أبناء طوائفهم وبناتها ومصائرهم، فهو ليس حق الطوائف، وإنما بالأحرى حق نخبها، الناطقة باسمها، في ضبط سلوك أفرادها، وردعهم ومنعهم من مزاولة حقوقهم الإنسانية الأساسية بالحب وبالارتباط برفيقٍ وبرفيقة درب في مؤسسة الزوجية وتكوين العائلة، عماد المجتمع وركيزته الأولى.
هنا، من الطرافة بمكان أن تجد تعبيرات من هذا القبيل في برنامج "الحملة من أجل دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين"، وهي، وإن صيغْت ضمن شروطٍ مختلفة، تظلُ متقاطعةً معها في الجوهر، في معرض الحديث عن الدفاع عن الحقوق الجماعية، وعن تلك الحقوق الفردية، وكأن "الحقوق" يمكن أن تتجزأ، حقوق تتعارضَ فيها هذه "الجماعة - الطائفة" مع تلك، جارّة أفرادها إلى النأي بذواتهم عن فردانيتهم (واحتياجاتهم العاطفية) باسم الدفاع عن جماعتهم، وتماسكها في مواجهة أفراد الجماعة المواجِهة، وإن كان هؤلاء "الأغراب" موضوعاً لعواطفهم الجياشة، ولرغباتهم في تكوين أسرةٍ سعيدةٍ معهم ومعهن.
في "مجتمع الحرب الأهلية الدائمة" هذا، أين هو موقع الدولة، أين هي "دولة جميع مواطنيها"، أم نحن أمام دولةٍ طائفيةٍ رثّة وفاشلة؟ لا يمكن أن تتجاوز الحقوق الخصوصية للجماعات حقوقاً ثقافية ومعتقدية، ولا يمكن ترجمتها بحقوقٍ تسمحُ ببناء مؤسسات وأجهزة وتنظيمات وقوانين خصوصية بها، إذ لا موقع لهذه الأشكال التحزبية الضيقة في دولة القانون الذي يعلو فوق مكوّنات المجتمع المختلفة، وهذا هو جوهر الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، دولة يتساوى فيها الأفراد، بصفتهم الفردية والجمعية - الخصوصية في بوتقة المواطنة المشتركة، والتي لا تضع تمايزاً ما بينهم، وفقاً لانتماءاتهم الجنسية والجندرية، الدينية، الطائفية، المعتقدية، الثقافية أو العرقية.
بالطبع، لا يتحدث برنامج "الحملة" صراحةً عن وجود تعارض ما بين الحقوق الجمعية
هذه الهوية الثقافية، وما تتضمنه من "تمثلات" لمفاهيم الحريات والحقوق والواجبات التشاركية والفردية تجد في الدولة الديمقراطية أرضيتها الجمعية الصلبة، وتتعزّز بمزيدٍ من القوة في ظل النظام الاجتماعي العلماني، والذي هو بمثابة "أسمنت" ولُحمة أواصر العيش المشترك (فيما قد تتحول هذه الهويات في نظام استبدادي إلى هوياتٍ متقاتلةٍ وقاتلة). ترتبط البنية السياسية لدولة ديمقراطية عضوياً بالفكرة العلمانية (توكڤيل). وهذا هو جذر المبدأ الديمقراطي في المواطنة المتجرّدة من الخصوصيات الطائفية، الدينية والقومية في ظِلِ دولةٍ ذات نظام سياسي ديمقراطي تعاقدي، ونظام علماني اجتماعي (قانون الأحوال الشخصية المدني واحد، وليس هناك قوانين خصوصية لكل مجموعة دينية أو قومية، الكلمة الأخيرة والصلاحيات الواسعة للمحاكم المدنية، وليس للمحاكم الشرعية، الكنسية والحاخامية).
الدولة الديمقراطية لا يمكنها أن تكون ديمقراطية حقة من دون أن تكون علمانيةً أيضاً، وهذا من شأنه حماية الأقليات، بصفتها الجمعية والفردية، ومنحها حقوقها الثقافية وحرية ممارسة شعائرها الدينية من دون أن تسمح لها بإقامة تنظيماتٍ سياسيةٍ، حصرية الانتماء الديني و/أو القومي. وعندما يتحدّث برنامج "الحملة" عن "حرية التنظيم" الذي يكفله الدستور للمجموعات الخصوصية والأقليات، ما كان إلا أن يُفهَمُ منه سوى حرّيتها في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية الناطقة باسمها.
بمواجهة هذا النقد للبرنامج في هذه النقطة (وهو ما عبرتُ عنه في رسالتي المنشورة على صفحة "فيسبوك" للحملة)، كان الرد بالنفي، إذ جرى شرح القصد بخصوص ذلك بأن "البرنامج ينص على حرية التنظيم، على أسسٍ قومية... ولكن ليس المقصود تنظيماً سياسياً، حزبا أو حركة سياسية قومية، أو إثنية، أو دينية، إنما احترام الخلفية الثقافية للمجموعات
لا نعود إلى نقد برنامج الحملة لتضمّنه خبايا وجهة نظر في "ثنائية القومية للدولة المنشودة" تحت ستارٍ كثيفٍ من الحديث عن الثقافة والتعدّدية الثقافية، والتي لا بدّ من أن تحترمها الدولة الديمقراطية الواحدة. وهذه القفزة من "السياسة" إلى "الثقافة"، بخصوص حرية المجموعات الخصوصية، تُعيدنا إلى ما بدأت به هذه المقالة: هل مؤسسة الزواج الديني كقاعدة و/أو كاستثناء هي قضية سياسية أم ثقافية؟ هذا هو السؤال المركزي، المتمنّى من القائمين على "الحملة" توضيحه.
من الحق أن يُقال إن ليس هناك من مشكلةٍ مع منح التجمعات اليهودية الكبرى، عندما تكون أكثرية متجانسة في منطقة ما، شكلاً من أشكال الحكم الذاتي الثقافي، لكي يمارس المواطنون فيها لغتهم وثقافتهم الخاصة، إذ لا يصح إلزامهم بتغيير اللغة المتداولة في هذا الحي أو ذاك.
"الدولة العلمانية الديمقراطية في فلسطين" هي الدولة التي سَتُقر بهذا الحق المبدئي لهذه المجموعة المميزة، والتي هي، وعلى الرغم من تمايزها الثقافي، تبقى عنصراً تكوينياً لدولة مواطنة قائمة على مبدأ منح جميع مواطنيها حقوقهم، بما فيها حقوقهم الثقافية واللغوية والمعتقدية، ولن تقوم بعملية "تعريب قسري" لهم.
الاعتراف باللغة العبرية (إلى جانب اللغة العربية لدولة فلسطين العلمانية) هو اعتراف بالحق بممارستها في الحياة الثقافية، وفِي الإنتاج الأدبي، وفِي معاملاتهم فيما بينهم في حياتهم اليومية. وبالتالي، هذا يعني اعترافاً بهوية ثقافية خصوصية لمجموعة من المواطنين من رعايا الدولة العلمانية. بالطبع، ليس الحديث هنا عن هذه التجمعات الخصوصية، ثقافياً ولغوياً، كمجموعاتٍ "قومية" أو كشعب أو شعوب، بل عن مجموعاتٍ من المواطنين، ممن هم ذوو الحق باختيار لغتهم وثقافتهم (إذا ما اختار الأشكناز اللغة العبرية المستحدثة، قد يختار بعض اليهود العرب المزاوجة بين اللغتين، أو اختيار واحدة منهما، بما يحمل هذا من احتمال اختيار اللغة العربية).
المساواة ما بين المواطنين من دون تمييز ما على أرضية اللون، أو المعتقد الديني، أو اللغة، أو الثقافة، هي أيضاً مساواة تقوم على الاعتراف بالتمايز والاختلاف، وليس طمساً أو تغييباً قسرياً للتمايز، وهذا ما يعطيها طابعها التقدّمي. الإقرارُ بالاختلاف وبالتعدّدية، والنظر إلى المساواة على أرضيتهما، يجعل من الحق بالمساواة، في الوقت نفسه، الحق بالخصوصية المتمايزة.
تعبير "الحكم الذاتي الثقافي" هو من وجوه الديمقراطية الحداثية المتخلصة من المقاربة "اليعقوبية" للديمقراطية، تلكَ المستمدة من تراث الثورة الفرنسية. هذه الديمقراطية الحداثية
من شأن هذه الممارسة السياسية (والبنية اللامركزية للدولة وللمجتمع) أن تتيح لجميع مكونات المجتمع المدني ممارسة ثقافاتها ولغاتها "محلياً. وهذا لا يعني إطلاقاً منحها حقوق انفصال عن المجتمع الكلي، أو عن الدولة. وبالتالي، ليس "الحكم الذاتي الثقافي" حكما ذاتياً سياسياً مانحاً لها الحق بتقرير المصير، وصولاً إلى الحق بالاستقلال السياسي، وبناء كياناتٍ دولتية - إثنية، وإنما هو منح هذه التجمعات المحلية حقوقاً ثقافية، لا هي سياسية، ولا يمكن لها أن ترتقي إلى مبادئ الحق بتقرير المصير.
على سبيل المثال لا الحصر، مدرسة في حي يهودي، لها الحق باستخدام اللغة العبرية شكلاً من أشكال الحكم الذاتي في حقل التعليم. مسرح يهودي في حي يهودي، إدارته المتمتعة بقراراتها "السيادية" بخصوص اختيار ألوانها المسرحية وفرقها وخياراتها "الجمالية"، هو من أشكال ممارسة الحق بالحكم الذاتي المحلي. حضور إعلام وصحافة وسينما وقنوات تلفزيونية بالعبرية هو من أشكال هذه الممارسة العملية للحق بالحكم الذاتي الثقافي. هذا هو ما يمكن أن تكون عليه "الثقافة" في مجتمع تعدّدي، ديمقراطي في ظل نظام سياسي اجتماعي علماني…
استطراداً، من الضرورة بمكان أن تكون هناك إجابة شافية فيما يخص "قانون الأحوال الشخصية"، فهل هو معطىً ثقافي أم سياسي؟ وهل ستكون لكلِ مجموعة خصوصية قانونها الخاص لتنظيم شؤونها الشخصية؟ وهل ستطبق الدولة الديمقراطية نظام المحاكم الطائفية اللبناني، بتنوعاته المختلفة، لكي تتعايش المحاكم الشرعية مع المحاكم الكنسية والحاخامية؟ وكيف ستتعاطى هذه الدولة، إن لم تكن علمانية الجوهر، مع حقوق النساء المهضومة في الخلية الأسرية، وهل ستطبق اتفاقية سيداو على العائلة المسلمة، كما على العائلة المسيحية، والعائلة اليهودية (ولاية الأمر، الطلاق، الإرث، التبنّي، النفقة، حضانة الأطفال بعد الطلاق…)؟ وهل ستغضّ النظر عن اضطهاد النساء في تجمعاتهن القومية و/ أو الدينية، بحجة احترام خصوصيات ثقافية مفروضة بقوة "الدستور"، والذي قد يكون في الغالب ذكورياً بامتياز؟
أخيراً، حريّ القول إن "المنظومة المعيارية للقوانين" سياسية بالدرجة الأولى، وهي الإطار الأيديولوجي للممارسة الحقوقية للجهاز القضائي: أحد أعمدة الدولة والمجتمع.
الإجابة على جملة التساؤلات هذه، ضرورة حيوية، لكي لا تبدو "الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين" إعادة إنتاج لنموذج لبناني طائفي فاشل، ولا يَمُتُ إلى الديمقراطية بصلة.
دلالات
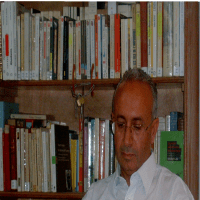
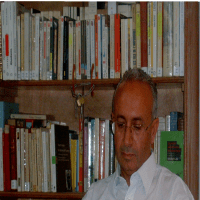
ناجي الخطيب
باحث وأكاديمي فلسطيني يعيش في فرنسا وإيطاليا. كتبَ عشرات المقالات الصحافية والبحوث وآخر كتابين صدرا له هما: "التعددية الفكرية والمنهجية: المنقذ من الضلال"، 2016 و"الجندر أو النوع الاجتماعي المعولم"، 2015.
ناجي الخطيب
مقالات أخرى
30 نوفمبر 2018
