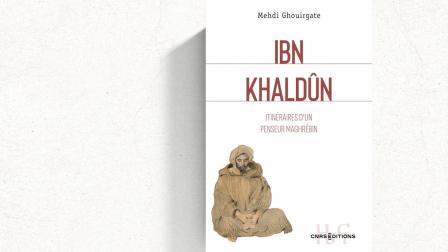ظلّ المسرح العربي – كغيره من ضروب الأدب الأخرى - مجالاً تتصادى فيه النظريات، التي كانت تظهر في الغرب، قبل أن تعرف طريقها إلى العالم العربي، بل حتى بدايات المسرح في منطقتنا كانت مرتبطة أحياناً بالمستعمر.
ورغم ذلك، كانت هذه التوجّهات تأخذ أشكالها الخاصة من خلال انسجامها التام مع البيئة العربية، مما جعلها في النهاية مسرحاً عربياً لا يدين غالباً لتلك النظريات سوى بحظّها في السبق.
ومن بين التوجهات، التي احتضنها المسرح العربي بحرارة كبيرة، موضوع السياسة، فاعتنى بها وطوّرها، وفاق تلقّيه لها مختلف نظريات المسرح الأخرى. حتى وإن كان هذا اللون حاضراً في بعض النصوص التراثية، التي وجدت لها امتدادات كبيرة، فهي لم تكن باالتأصيل نفسه والوضوح المفاهيمي الذي ظهر في الغرب بعد اضطراباته السياسية الكبرى؛ إذ جاء هذا بأسئلة جديدة كانت وليدة سياقات حديثة ومختلفة وغير مألوفة. ولعل هذه الظروف كانت شبيهة بما كان يحدث في الأقطار العربية، حيث كانت الدوافع متشابهة.
ففي الغرب، ظهر بحسب توماس ديكسون "دافع جديد بعد الحرب، جعل المسرح أداة في يد الطبقات المغبونة". وفي المشرق، كان همّ المسرحيين إيجاد قوالب مسرحية وصيغ تحريضية ضدّ الاستعمار، ثم ضدّ الحاكم الطاغية، ومختلف القضايا السياسية كالقمع والحرية والفقر.
وكان لحضور السياسة كموضوع خيوط مشتتة سرعان ما اتضحت أكثر مع مرور الزمن والاحتكاك بالثقافة الغربية، حيث التقط المسرحيون العرب وقائع الحياة السياسية واضطراباتها واشتغلوا عليها بهدف التغيير. وأصبح الجمهور في أمسّ الحاجة إلى رؤية انعكاس مشاكله الاجتماعية والسياسية فوق الخشبة.
هنا راهن المسرحيون على الجمهور كعنصر فاعل ومهم في العرض المسرحي، مثلما نظّر لذلك برتولت بريشت الذي كان يرى "أن المسرح من دون جمهور لا معنى له"؛ فحضور المتلقي كعنصر مهم في حلقة التواصل فرض على المخرج ابتكار وسائل جديدة، كالتحام الخشبة بالصالة واعتماد قنوات متعددة لتمرير المعنى بطرق بادية تارة وخافية تارة أخرى.
طرق تدفع الجمهور ليس فقط إلى أن يفهم معاناة الشخصية، بل إلى أن يلتقط رسالة العرض بهدف صناعة متفرج منفعل وقادر على فهم رسائل التغيير المُتضمنة في العرض لأنه المعني الأول بها.
عاد مسرح السياسة ليتّقد أكثر بعد الثورات والانتفاضات العربية، واسترجعت ذاكرة الخشبة مفهوم الثورة بقوة تلائم حجم هذا الحدث التاريخي الكبير وتطلعاته. لكن في مسرح الثورة علينا دائماً أن نميز بين العمل الذي ساهم في هذه الثورة واستشرفها، وبين العمل المسرحي الذي اشتغل على موضوعها، وساير في ذلك الكلام المردّد عنها.
وهذا الصنف الثاني هو الطاغي على الأعمال المسرحية بعد 2011، لأن الثورة وإن كانت تفرض انخراط المثقف فيها، فهي أيضاً تتطلب تقديم أعمال فنية برؤية واضحة وحقيقية، وهو أمر يصعب علينا الإمساك به في ظل النتائج التي لم تستقر، ولم تأخذ أصلاً شكل الحلم الذي رسمه خيال المثقف في البداية.
فالمسرح بعد 2011 يواجه حروباً متعددة الجبهات قد تكون أصعب من تلك التي خاضها في الماضي؛ إذ إنّه ملزم أولاً بأن يوازي الثقافة السطحية والتدجين التي تساهم فيها الحكومات ومؤسساتها، بثقافة أخرى فنية جادة، وهذه المؤسسات التي وإن ساهمت في تمويل العروض المسرحية أو تنظيم مهرجاناتها فهي تشكل ضغطاً رقابياً مهماً تُغلّفه شعارات مفخخة عن الحرية، إضافة إلى زحف الميديا وتضييقها على المسرح.
في وسط هذه الظروف كلها، ما زال المسرح يتنفس ويواصل طريقه، وما زال المسرحيون يقدّمون عروضهم رغم كل شيء، مبدّدين كل النبوءات الكاذبة عن النهاية، لأن الاستمرار هو أحد مهام المسرح الكبرى.