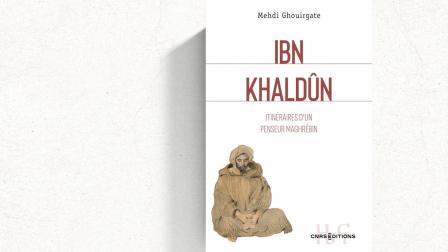وقد بدا احتقار الكلمة في الثقافة العربية ذات يوم، اكتشافاً سعيداً للعشرات من "الشعراء" والصحافيين. وإذا كانت شاعرة مثل فدوى طوقان قد انزلقت إلى ازدراء الكلمة، كي تمتدح الشهيد، فإن شعراء آخرين من العرب أرادوا من ذلك امتداح الرصاصة. وذلك في الزمن العربي الذي قسم الثقافة إلى تيارين: الأول هو تيار الرصاصة، وهم الأكثرية، والثاني هو تيار الكلمة: وهم الأقلية.
وأما تيار الرصاصة فقد كان صوته هو الأعلى، والأكثر انتشاراً في المحيط العربي. وفيه كان أنصاره يهتفون قائلين إن شوالاً من الشعر والروايات، أو من الكلمات لا يساوي رصاصة واحدة (يستخدم السوريون لفظ " الفشكة" بدل الرصاصة، للتعبير عن رخص المقابل) وكانوا هم المتفوقون في النقاشات الدائرة. فأثر الرصاصة يمكن أن نتلمسه، ونراه، ونتحقق من فعاليته. فيما يحتاج أثر الكلام إلى بضع سنوات أو عقود، أو قرون أيضاً.
ولعل المتأمل للتاريخ العربي الحديث، سوف يرى أن المسألة كانت تشير إلى أن ذلك التقسيم إنما ابتكره أنصار الرصاصة، أو أنصار العسكر الذين استولوا على جميع أنظمة الحكم في العالم العربي، واحتقروا التفكير الذي تمثّله الكلمة. أو عملوا على تدجين المفكر، أو الكاتب، أي من يمثّل الكلمة. مستعينين بجوقات من كتبة المناسبات، الذين ساروا في أهازيج التصفيق للعسكري الحاكم.
فإذا خاض العسكري معركة صغيرة، فإنه يتهم الكلمة في الانتصار التافه بالتقصير، وإذا خاض معركة كبيرة فإنه يتهم الكلمة في الهزيمة الماحقة بالعجز. بينما ظلّ أنصار الكلمة أو المثقف في حالة الدفاع عن النفس، وقد وصلت العدوى إلى القوى السياسية كافة.
يعرف الذين كانوا في صفوف الأحزاب اليسارية من المثقفين، أن قياديي تلك الأحزاب كانوا ينظرون إليهم بحذر. ويشككون غالباً في القيم الفنية التي قد يسعى الكتّاب لتدوينها. وقد أمنوا تغطية أيديولوجية من باب آخر، هو التبجيل المنافق للعمال والفلاحين. يساعدهم في ذلك تخاذل بعض المثقفين ممن كانوا ينتفعون من فيء مظلاتهم، ومنافع مزارعهم.
كان الهدف غير المعلن من ذلك كله هو إلحاق الكلمة بالرصاصة، أو منعها من القول الحر. ولكنه في لحظة الحقيقة، أي حين أرادت الكلمة فيها أن تقول شيئاً لا يوافق عليه العسكري، كالمطالبة بالحرية، أو الكرامة أو العيش الكريم. اندفع لقتلها بالرصاصة.