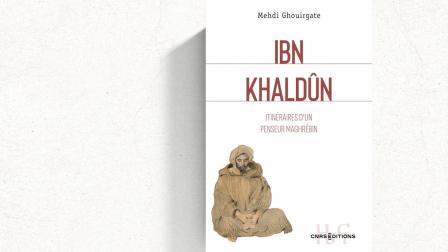اعتاد أحد أساتذة الفلسفة أن يقول لنا حين كنّا طلّاباً إنه لا يحب الأدب، وكان يعتبر كل الأنواع الأدبية، من رواية وقصة ومسرح وشعر، وسائل لإلهاء الناس عن شغلهم الرئيسي، وهو التفكير في حياتهم والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة للمشكلات التي تعترضها، وذلك بميلها إلى تأكيد الخيال والعواطف بدلاً من تشغيل العقل. ولهذا، كان الأستاذ يمجّد الفلسفة التي تطرح الأسئلة عن الوجود، كما يمجّد الصناعة والزراعة. وكان كلّما تكلّم عن الشعر، يضع في الميزان المتخيَّل كيساً منه مقابل صناعة إبرة.
لكن الفلسفة نفسها لم تكن موفّقةً في بلادنا، فاحتقار الأدب لم يخلق أي ذريعة لتمجيد الفلسفة، إذ كانت تُهان أيضاً في اللسان العربي، وثمّة من يقول للآخر: "بلا فلسفة"، موحياً بأن كلام الآخر تافه، أو عبثي. وكان محمود أمين العالم قد وضع عنواناً شبيهاً بهذا لمقالته الأولى في كتابه "معارك فكرية" هو "بلاش فلسفة". غير أنه هناك كان يدعو لأن نستخدم هذا التعبير في مواجهة الفلسفات المثالية التي كان يعتبرها مفسدة للحياة، بينما يرشّح الفلسفة المادية للقيام بمهام إصلاحها، بل تغييرها.
وبالعودة إلى الأستاذ، فمن الراجح أنه يعلم أن الجيل كلّه لا يقرأ كلا الحقلين، فلا الأدب نافس الفلسفة في تشكيل الوعي، ولا الفلسفة زحزحت الأدب من مواقع التأثير في الرأي، ونصيب الشباب من قراءة الفلسفة لم يتعدّ في سورية المقرّرات المدرسية. وفي أيامنا كان لدينا كتابان مقرَّران في البكالوريا؛ أحدهما يدرس مشكلة المعرفة، أمّا الآخر فيدرس مشكلة العمل.
لكن كل ذلك التعليم وكل تلك المعلومات ذهبت سدى، ولم تنفع مشكلة المعرفة في حل أي قضية معرفية، ولا أفادت مشكلة العمل في تدبر أمر العمل والعمّال، وبدا كأن المسألة لا تزيد عن قيمة الورق والحبر. فلم يتابع معظم أبناء الجيل التساؤل عن معنى المعرفة، أو معنى أي من تلك المعارف هي التي يمكن أن تساعدنا في الحياة. إذ أن أكثرهم ينقطعون عن دراسة الفلسفة أو قراءتها، في المجتمع، وفي السنوات الجامعية التالية، عدا قسم الفلسفة طبعاً. ولهذا فإن المثالية لم تخُض أي صراع مع المادية، لا في الحياة العامة، ولا في ساحات القراءة، فالجدل نفسه كان ممنوعاً، ولم يكن الصراع بينها سبباً في تدهور الأوضاع المعيشية، أو حلّاً ممكناً لها.
وليس الأدب، الخيالي أو الواقعي، السبب في تعميق التخلُّف، أو إعاقة التقدُّم الصناعي أو الزراعي. وبعكس ذلك، فإن المناهج المدرسية لم تعمل على تقديم الأدب للطلّاب، فلم يكن بين أيديهم غير مقتطفات مجتزأة باهتة مسحوبة من النصوص الأصلية بمصافي مؤلّفي الكتب الموجَّهة من الأعلى، والتي لا تقدّم أي فائدة عملية. وأذكر أنني لم أر، طوال عهدي بالتعليم، مكتبة مدرسية واحدة تضم كتباً ذات قيمة علمية، أو أعمالاً أدبية هامة، أو تنشئ علاقة تفاعلية مع الطلّاب. لقد كنّا، كما يقول أستاذ لطلّابه، في فيلم شاهدته منذ يومين، نعلّم الكلمات ولا نسأل عن المعاني.