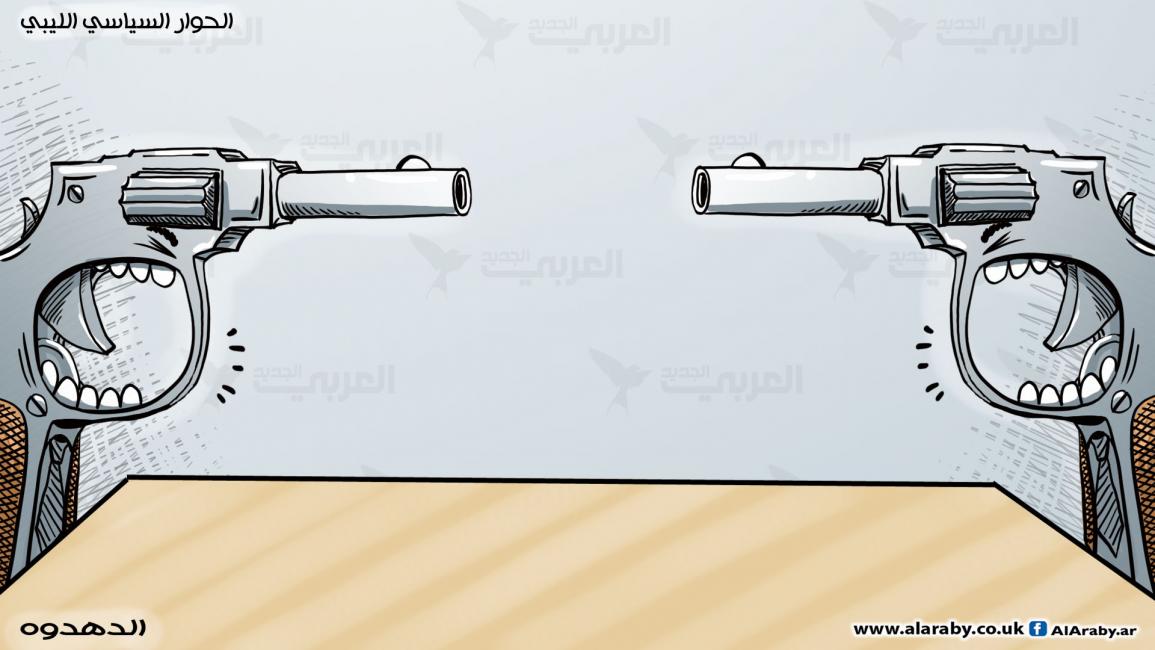13 سبتمبر 2015
حرب الألوان الفلسطينية
لا يهدأ النقاش في العوالم الافتراضية والعامة، وحتى الجلسات الخاصة، فلسطينياً، حيال أحداث كثيرة قد تمر مرور الكرام، لو حدثت في أي مكان آخر. ينقسم الفلسطينيون حول كل شيء، وينتجون الكثير من الكلام الملفوظ والمكتوب حول اختلافهم. ويتضح جيداً أن الفلسطينيين باتوا افتراضيين بمستويات غير مسبوقة، والعالم الافتراضي التواصلي قائم، أصلاً، على كلام يجر كلاماً، وصورة تجر صورة.
العنوان العريض الذي يمكن أن يشمل جزءاً وافراً من النقاشات تلك، وقد تكون كلمة "نقاش" تخفيفاً من حدة الصدامات الافتراضية، هو ما الذي يمكن أن نفعله، أو لا نفعله، في حيواتنا الخاصة أو في تجمعاتنا العامة، ونحن نعيش وضعاً سياسياً مركّباً، وواقعاً من الاحتلال، ينتج شهداء كل يوم أو يومين، وآلاف المعتقلين، وتضييقا لا ينتهي.
يتفجر النقاش مع كل حفلة صاخبة، فعالية عامة ليس الشأن الوطني موضوعها، مهرجان فني، عرض أزياء، حفل زفاف تكاثرت الكاميرات فيه، أو حتى نشاط نظمه طلاب مدرسة للعب بالألوان. هكذا نجد أنفسنا في دوامة صراخ متبادل، بات مع الوقت متوقعاً جداً، وإن استمر على الوتيرة نفسها فلن يكون سوى ملء فراغ بالمناوشة على "فيسبوك" وغيره من مساحات التقاتل المريحة.
الملاحظة الأهم على هذا النقاش أنه مركب، وليس الشأن الوطني والاختلاف على سلوكنا الحياتي في ظل الاحتلال هو المحدد الأهم فيه، بل أحد الدوافع، وغالبا هو غطاء لدوافع أخرى، فهذه النقاشات، وتحديداً التي تستهدف سلوكا احتفاليا منفتحا، منطلقة من تصورات مختلفة، اجتماعية، أخلاقية، عنصرية، مناطقية، جهوية، دينية، ثم تجد الشأن الوطني، أو السؤال الوطني، غطاء ملائماً أو جامعا لها، فتطلقه في الصدارة. وفي الغالب، هنالك مزج وخلط متعمد بين كل تلك الدوافع والدافع الوطني.
كل هذا الخلط ينفجر اليوم، وتزيد انفجاره عوامل أخرى، أهمها أن الجميع، الناقد والمنقود، يستخدمون خطاباً متشابهاً، الكل يتهم الكل في وطنيته، وسط قناعة عامة أنه مادام الآخرون لا يفعلون شيئا للوطن والقضية، فلا يمكنهم أن يسائلوني لماذا لا أفعل شيئا للوطن والقضية. وما دمت ساكناً لا أفعل شيئا من أفعال الآخرين التي يمكن أن تفسر بأنها غير عابئة بالوطن والقضية، فأنا أفضل من الذين يفعلونها. وبذلك، يتحول الشأن الوطني إلى محور حديث الجميع من دون أن يكون فاعلا في سلوك أي منهم، ويصبح المرء وطنياً لا بما يفعله، بل بما لا يفعله، أو بما يظهر أنه يفعله.
أخيراً، يلجأ كثيرون لربط أي سلوك يأتونه مع الشأن الوطني بطريقة اعتباطية، لتبرير فعله، أو لقطع الطريق على المنتقدين. هكذا يصبح الاستماع للموسيقى غير كاف كمبرر لأمسية فنية، ولا بد من "زج" بعض المعاني الوطنية في الحفل. والمحصلة تمييع الشأن الوطني، والتستر به لمعالجة منطق فاسد، أصلاً، يجب رفضه.
والملاحظ أيضا على هذه الحالة أن افتراض وجود سلوك اجتماعي، أو شخصي معين، يضمن النصر، هو مبرر غالبية القمع الممارس على أي مختلِف، ومارسته كل التنظيمات والجماعات الفلسطينيية، ونشرت هذا الوهم بين الناس بأساليب مختلفة، إحداها العبارات المضحكة المنسوبة لغولدا مائير، وأطرفها، أنها إن رأت العرب يركبون الحافلة بانتظام فستخاف منهم. هكذا بكل التسطيح. ولا يختلف الأمر عن قول إمام مسجد إننا كفلسطينيين لن ننتصر، إلا حين يمتلئ المسجد في صلاة الفجر، كامتلائه في صلاة الجمعة.
هذا المنطق في سياق النقاش حول سلوك عادي، أو من أبسط حقوق فاعليه، يصبح كارثياً ومدخلا لسلطة لانهائية على الناس وسلوكهم، بل واستخداما للوطن والقضية لغاياتٍ بعيدة كل البعد عنهما. وهو، ببساطة، منطق من لا يدركون أن الحرية والتحرر والتحرير من جذر واحد.
العنوان العريض الذي يمكن أن يشمل جزءاً وافراً من النقاشات تلك، وقد تكون كلمة "نقاش" تخفيفاً من حدة الصدامات الافتراضية، هو ما الذي يمكن أن نفعله، أو لا نفعله، في حيواتنا الخاصة أو في تجمعاتنا العامة، ونحن نعيش وضعاً سياسياً مركّباً، وواقعاً من الاحتلال، ينتج شهداء كل يوم أو يومين، وآلاف المعتقلين، وتضييقا لا ينتهي.
يتفجر النقاش مع كل حفلة صاخبة، فعالية عامة ليس الشأن الوطني موضوعها، مهرجان فني، عرض أزياء، حفل زفاف تكاثرت الكاميرات فيه، أو حتى نشاط نظمه طلاب مدرسة للعب بالألوان. هكذا نجد أنفسنا في دوامة صراخ متبادل، بات مع الوقت متوقعاً جداً، وإن استمر على الوتيرة نفسها فلن يكون سوى ملء فراغ بالمناوشة على "فيسبوك" وغيره من مساحات التقاتل المريحة.
الملاحظة الأهم على هذا النقاش أنه مركب، وليس الشأن الوطني والاختلاف على سلوكنا الحياتي في ظل الاحتلال هو المحدد الأهم فيه، بل أحد الدوافع، وغالبا هو غطاء لدوافع أخرى، فهذه النقاشات، وتحديداً التي تستهدف سلوكا احتفاليا منفتحا، منطلقة من تصورات مختلفة، اجتماعية، أخلاقية، عنصرية، مناطقية، جهوية، دينية، ثم تجد الشأن الوطني، أو السؤال الوطني، غطاء ملائماً أو جامعا لها، فتطلقه في الصدارة. وفي الغالب، هنالك مزج وخلط متعمد بين كل تلك الدوافع والدافع الوطني.
كل هذا الخلط ينفجر اليوم، وتزيد انفجاره عوامل أخرى، أهمها أن الجميع، الناقد والمنقود، يستخدمون خطاباً متشابهاً، الكل يتهم الكل في وطنيته، وسط قناعة عامة أنه مادام الآخرون لا يفعلون شيئا للوطن والقضية، فلا يمكنهم أن يسائلوني لماذا لا أفعل شيئا للوطن والقضية. وما دمت ساكناً لا أفعل شيئا من أفعال الآخرين التي يمكن أن تفسر بأنها غير عابئة بالوطن والقضية، فأنا أفضل من الذين يفعلونها. وبذلك، يتحول الشأن الوطني إلى محور حديث الجميع من دون أن يكون فاعلا في سلوك أي منهم، ويصبح المرء وطنياً لا بما يفعله، بل بما لا يفعله، أو بما يظهر أنه يفعله.
أخيراً، يلجأ كثيرون لربط أي سلوك يأتونه مع الشأن الوطني بطريقة اعتباطية، لتبرير فعله، أو لقطع الطريق على المنتقدين. هكذا يصبح الاستماع للموسيقى غير كاف كمبرر لأمسية فنية، ولا بد من "زج" بعض المعاني الوطنية في الحفل. والمحصلة تمييع الشأن الوطني، والتستر به لمعالجة منطق فاسد، أصلاً، يجب رفضه.
والملاحظ أيضا على هذه الحالة أن افتراض وجود سلوك اجتماعي، أو شخصي معين، يضمن النصر، هو مبرر غالبية القمع الممارس على أي مختلِف، ومارسته كل التنظيمات والجماعات الفلسطينيية، ونشرت هذا الوهم بين الناس بأساليب مختلفة، إحداها العبارات المضحكة المنسوبة لغولدا مائير، وأطرفها، أنها إن رأت العرب يركبون الحافلة بانتظام فستخاف منهم. هكذا بكل التسطيح. ولا يختلف الأمر عن قول إمام مسجد إننا كفلسطينيين لن ننتصر، إلا حين يمتلئ المسجد في صلاة الفجر، كامتلائه في صلاة الجمعة.
هذا المنطق في سياق النقاش حول سلوك عادي، أو من أبسط حقوق فاعليه، يصبح كارثياً ومدخلا لسلطة لانهائية على الناس وسلوكهم، بل واستخداما للوطن والقضية لغاياتٍ بعيدة كل البعد عنهما. وهو، ببساطة، منطق من لا يدركون أن الحرية والتحرر والتحرير من جذر واحد.