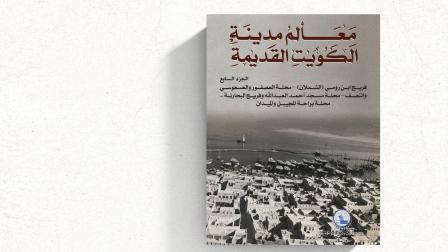لوحة للفنان العراقي حنوش.
غادرنا مصر مثل اللصوص. من دون وداع ولا شكر، بل حتى من دون إخبار الأصدقاء. نجحت أمي في انتزاع تأشيرة الخروج من هذا الضابط الذي كان يطوف حولنا. المقدّم حسن صبري. لم يكن الأمر يتعلّق، مبدئيًا، سوى بإقامة قصيرة في لبنان.
آخر من تحدّثنا إليه فوق التراب المصري، في يونيو/حزيران 1963، كان جمركيا له نظرة صقر، يساعده شرطيان يضارعانه حماسة. لم يدّخرا جهدًا في تفتيشنا: الحقائب مفتوحة، الملابس معروضة، مُفتشة، مدعوكة. والأسئلة تزداد دقة شيئًا فشيئًا، كما لو أن جرمنا يتأكّد مع مرور الدقائق. ما هي تهمتنا؟ نحن متهمون، بغموض، بالتهرّب المالي. فهم والدي أنهم لن يتركوه. لقد قرّر الذهاب نحو الكارثة، عندما ترك وراءه شركة مزدهرة.
طلب منه الجمركي بخشونة أن يُفرّغ محفظته. ثم بدأ يفحص بطاقات الزيارة داخلها، واحدة بعد أخرى. في زمن آخر كان سليم ياريد، صاحب شركة "بطرقاني وأبناؤه"، سيحدث ضجة، فيطلب مقابلة مدير المطار، أو يلحّ على الاتصال بمكتب الوزير. لكننا لم نكن هناك. أسر كثيرة "سورية- لبنانية" مثل أسرتنا، عاينوا تأميم ممتلكاتها وتلويث اسمها في الصحافة.
أمام حقائبنا المفتوحة، كان أبي يصرّ على أسنانه. أمي، وراءه، تبتلع دموعها. ولم تستسلم للبكاء إلا لحظة إقلاع طائرة "كارافيل، خطوط ميدل إيست"، التي كانت على متنها. بالنسبة لي ولإخوتي الذين لم يركبوا طائرة في حياتهم، فإن سفينة الهواء هذه بدأت بالغرق.
في النهاية، وبمظهر مشمئز، ألقى علينا الجمركي تحية الوداع "مع السلامة" مزدرية، التي لم تعنِ وهي تخرج من لسانه "لتذهبوا في سلام"، بل "ارحلوا، خلصونا". كانت إقامتنا على ضفاف "النيل" من دون شكّ إقامة قصيرة جدًا – بضعة أجيال - حتى نحظى بالتقدير الكافي. بطاقات هويتنا لم تتخذ لون القديم. لم يتمّ اعتبارنا مصريين بشكل كامل، ولا غرباء حقيقيين.
بعد مغادرتنا مصر، خلال خمس وعشرين سنة، رفضت النظر إلى الخلف. أصبحتُ فرنسيا، بعشق. فرنسا هذه التي اكتشفتها وأحببتها عن بعد، بواسطة الكتب، ما زالت مثيرة أكثر مما هي على الأوراق المطبوعة. وأنا أتغذّى من لغتها وثقافتها. أصبحت داخل المشهد حرباء حقيقية.
لم يبق في مصر فرد واحد من أفراد عائلاتنا. لقد تفرّقنا بين بيروت وباريس وجنيف ومونتريال أو ريو. في كلّ مدينة من هذه المدن المختارة، نشأت بعض التجمعات. أمّا أنا فقد بقيت على الحياد.
اقرأ أيضاً: طريق اللؤلؤ
في سنة 1980، سنة موت ميشيل في جنيف، استطاع عمي وعرّابي أن يربط بيني وبين مصر من جديد. ما الاسم الذي كانت تحمله تلك المصحّة الطاهرة، على بحيرة "لامان"، حيث تمّ إدخاله؟. ساحل جميل، ضفّة جميلة، حيث يوجد شيء ما مشابه، كنّا في شهر فبراير/شباط. الثلج يتساقط في الخارج. السماء بيضاء بالكامل.
- وأنت، يا شارل، خاطبني ميشيل بصوت ضعيف، تستطيع أن تأخذ دفاتري، إن شئت. عددها أحد عشر.
ردّ أخوه بول بسرعة، كما لو أن المريض تفوّه بقول فاحش:
- لا تنطق بالتفاهات، انتبه. خلال أسبوعين أو ثلاثة ستقف على قدميك. ينبغي أن أحجز لك مقعدًا في القطار المتجه إلى"شتاليغيون".
في اليوم الذي تلا الجنازة، حملت الدفاتر الأحد عشر داخل حقيبة من القماش، اشتريتها لهذه المناسبة. كان للدفاتر الغلاف الكارتوني نفسه، أزرق أو بني، مثل تلك التي كانت تُصنع قديمًا في القاهرة. كان عليّ أن أسرع إلى قراءة مذكرات عرّابي، بدافع الفضول على الأقلّ. لكنني لم أفتح حتّى الحقيبة حين وصولي إلى باريس. بقيت الدفاتر في هذا السجن القُماشي، داخل خزانة.
هل سيدوم نسياني الاختياري إلى الأبد؟ ذات يوم جميل، انغمستُ في مذكرات ميشيل، بنيةِ عدم إغلاقها.
طيلة سنوات، وأنا أحمل معي هذا الدفتر أو ذاك خلال السفر، كدت أُضيع هذه الدفاتر. لكن التكنولوجيا أنقذتني. أشكر السماء على أنها نسخت داخل مفتاح للحفظ "USB" الذي أصبح لا يفارقني. إنه أقلّ إثارة، لكن يمكنني في كلّ لحظة أن أجد فيه أحد المقاطع. وفي أحيان كثيرة لا أحتاجه؛ إذ انتهيت بحفظ بعض المقاطع كاملة عن ظهر قلب.
أنا أنتمي لعالم مات في أبريل/ نيسان سنة 1958، يوم جنازة جدّي، جورج باي بطرقاني. مات ودُفن، رغم أننا عشنا بعض السنوات السعيدة في مصر قبل المنفى والشتات. أنا، ما زلت أعاند في لعب الأشواط الإضافية. هذا العالم اختفى، وأنا مستمرّ رغم ذلك في رصد دقات قلبه وابتساماته.
من بين كلّ أمكنة طفولتي، بيت جدّي لأمي هو الذي يشغل المكان الكبير. ربما لأنها بقيت مسكونة إلى اليوم، بفضل دينا.
دينا. لا أحد تخيّل أنها ستكون حارسة المعبد. هي أرملة أليكس، فرد العائلة الذي لا خير يرجى منه، ذلك المستهلك الكبير للسيارات الرديئة وللفنانات من درجة "الثانية"..."الدجاجات"، كما كان يُقال عنهم قديمًا. "كلهن دواجن الفناء"، كما كان أبي يقول مدققًا.
*مقطع من رواية "ليلة في القاهرة".
ترجمة محمود عبد الغني
آخر من تحدّثنا إليه فوق التراب المصري، في يونيو/حزيران 1963، كان جمركيا له نظرة صقر، يساعده شرطيان يضارعانه حماسة. لم يدّخرا جهدًا في تفتيشنا: الحقائب مفتوحة، الملابس معروضة، مُفتشة، مدعوكة. والأسئلة تزداد دقة شيئًا فشيئًا، كما لو أن جرمنا يتأكّد مع مرور الدقائق. ما هي تهمتنا؟ نحن متهمون، بغموض، بالتهرّب المالي. فهم والدي أنهم لن يتركوه. لقد قرّر الذهاب نحو الكارثة، عندما ترك وراءه شركة مزدهرة.
طلب منه الجمركي بخشونة أن يُفرّغ محفظته. ثم بدأ يفحص بطاقات الزيارة داخلها، واحدة بعد أخرى. في زمن آخر كان سليم ياريد، صاحب شركة "بطرقاني وأبناؤه"، سيحدث ضجة، فيطلب مقابلة مدير المطار، أو يلحّ على الاتصال بمكتب الوزير. لكننا لم نكن هناك. أسر كثيرة "سورية- لبنانية" مثل أسرتنا، عاينوا تأميم ممتلكاتها وتلويث اسمها في الصحافة.
أمام حقائبنا المفتوحة، كان أبي يصرّ على أسنانه. أمي، وراءه، تبتلع دموعها. ولم تستسلم للبكاء إلا لحظة إقلاع طائرة "كارافيل، خطوط ميدل إيست"، التي كانت على متنها. بالنسبة لي ولإخوتي الذين لم يركبوا طائرة في حياتهم، فإن سفينة الهواء هذه بدأت بالغرق.
في النهاية، وبمظهر مشمئز، ألقى علينا الجمركي تحية الوداع "مع السلامة" مزدرية، التي لم تعنِ وهي تخرج من لسانه "لتذهبوا في سلام"، بل "ارحلوا، خلصونا". كانت إقامتنا على ضفاف "النيل" من دون شكّ إقامة قصيرة جدًا – بضعة أجيال - حتى نحظى بالتقدير الكافي. بطاقات هويتنا لم تتخذ لون القديم. لم يتمّ اعتبارنا مصريين بشكل كامل، ولا غرباء حقيقيين.
بعد مغادرتنا مصر، خلال خمس وعشرين سنة، رفضت النظر إلى الخلف. أصبحتُ فرنسيا، بعشق. فرنسا هذه التي اكتشفتها وأحببتها عن بعد، بواسطة الكتب، ما زالت مثيرة أكثر مما هي على الأوراق المطبوعة. وأنا أتغذّى من لغتها وثقافتها. أصبحت داخل المشهد حرباء حقيقية.
لم يبق في مصر فرد واحد من أفراد عائلاتنا. لقد تفرّقنا بين بيروت وباريس وجنيف ومونتريال أو ريو. في كلّ مدينة من هذه المدن المختارة، نشأت بعض التجمعات. أمّا أنا فقد بقيت على الحياد.
اقرأ أيضاً: طريق اللؤلؤ
في سنة 1980، سنة موت ميشيل في جنيف، استطاع عمي وعرّابي أن يربط بيني وبين مصر من جديد. ما الاسم الذي كانت تحمله تلك المصحّة الطاهرة، على بحيرة "لامان"، حيث تمّ إدخاله؟. ساحل جميل، ضفّة جميلة، حيث يوجد شيء ما مشابه، كنّا في شهر فبراير/شباط. الثلج يتساقط في الخارج. السماء بيضاء بالكامل.
- وأنت، يا شارل، خاطبني ميشيل بصوت ضعيف، تستطيع أن تأخذ دفاتري، إن شئت. عددها أحد عشر.
ردّ أخوه بول بسرعة، كما لو أن المريض تفوّه بقول فاحش:
- لا تنطق بالتفاهات، انتبه. خلال أسبوعين أو ثلاثة ستقف على قدميك. ينبغي أن أحجز لك مقعدًا في القطار المتجه إلى"شتاليغيون".
في اليوم الذي تلا الجنازة، حملت الدفاتر الأحد عشر داخل حقيبة من القماش، اشتريتها لهذه المناسبة. كان للدفاتر الغلاف الكارتوني نفسه، أزرق أو بني، مثل تلك التي كانت تُصنع قديمًا في القاهرة. كان عليّ أن أسرع إلى قراءة مذكرات عرّابي، بدافع الفضول على الأقلّ. لكنني لم أفتح حتّى الحقيبة حين وصولي إلى باريس. بقيت الدفاتر في هذا السجن القُماشي، داخل خزانة.
هل سيدوم نسياني الاختياري إلى الأبد؟ ذات يوم جميل، انغمستُ في مذكرات ميشيل، بنيةِ عدم إغلاقها.
طيلة سنوات، وأنا أحمل معي هذا الدفتر أو ذاك خلال السفر، كدت أُضيع هذه الدفاتر. لكن التكنولوجيا أنقذتني. أشكر السماء على أنها نسخت داخل مفتاح للحفظ "USB" الذي أصبح لا يفارقني. إنه أقلّ إثارة، لكن يمكنني في كلّ لحظة أن أجد فيه أحد المقاطع. وفي أحيان كثيرة لا أحتاجه؛ إذ انتهيت بحفظ بعض المقاطع كاملة عن ظهر قلب.
أنا أنتمي لعالم مات في أبريل/ نيسان سنة 1958، يوم جنازة جدّي، جورج باي بطرقاني. مات ودُفن، رغم أننا عشنا بعض السنوات السعيدة في مصر قبل المنفى والشتات. أنا، ما زلت أعاند في لعب الأشواط الإضافية. هذا العالم اختفى، وأنا مستمرّ رغم ذلك في رصد دقات قلبه وابتساماته.
من بين كلّ أمكنة طفولتي، بيت جدّي لأمي هو الذي يشغل المكان الكبير. ربما لأنها بقيت مسكونة إلى اليوم، بفضل دينا.
دينا. لا أحد تخيّل أنها ستكون حارسة المعبد. هي أرملة أليكس، فرد العائلة الذي لا خير يرجى منه، ذلك المستهلك الكبير للسيارات الرديئة وللفنانات من درجة "الثانية"..."الدجاجات"، كما كان يُقال عنهم قديمًا. "كلهن دواجن الفناء"، كما كان أبي يقول مدققًا.
*مقطع من رواية "ليلة في القاهرة".
ترجمة محمود عبد الغني