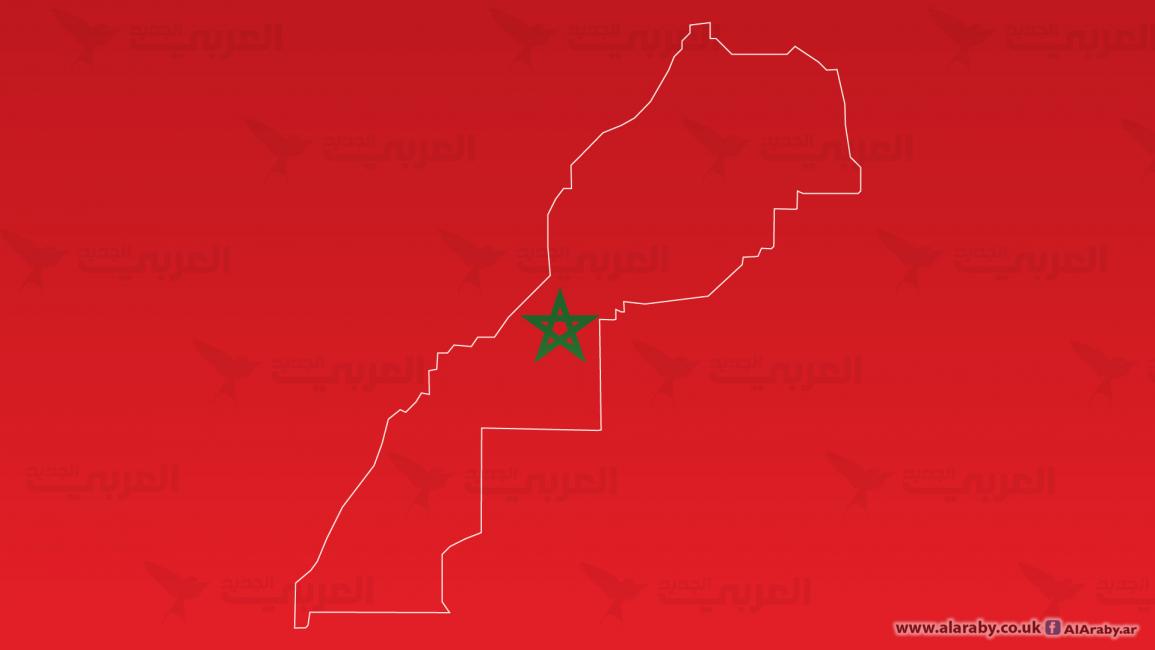01 فبراير 2019
سنة مغربية بلا أوهام
تحمل الدولة المغربية، منذ زمن، نزوعا هيمنيا في تدبير العلاقة مع المجتمع، حيث تنهض بنيتها العميقة على فكرة الضبط المسبق لرقعة تدخل باقي الفاعلين، وحدوده ومضمونه، وعلى الترتيب المسبق للاتجاهات الكبرى للحياة السياسية والاقتصادية.
لذلك، وهي التجسيد الحي لإرادة التحكم الفوقي في كل ديناميات "التحت"، المعتمدة على تقاليد راسخة في الثقافة المخزنية، فإن عدوها الأول هو القرار المجتمعي المستقل (بأشكاله الحزبية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية)، وخصمها الطبيعي هو المفاجأة.
هكذا تتحول مناهضة الحزبية المستقلة إلى هوية راسخة للدولة، تعمل على تنزيلها بحزمةٍ من الأدوات والتكنولوجيا السياسية التي أعطت دائما نتائج مبهرة.
وبحكم المراس والتجربة، فقد طورت الدولة حاسة خاصة، لتدبير ارتباك المفاجآت. فعلت ذلك مثلا مع "مفاجأة إستراتيجية" من حجم الربيع العربي، و فعلت ذلك مع مفاجأة على مستوى "الفاعلين" من حجم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
ما يبدو تنازلات جزئية سرعان ما يتحول، مع الزمن، إلى مجرد حركة سحرية، أو وهم بالتنازل. أكثر من ذلك، يصبح في الواقع نوعا من إعادة انتشار الدولة. لذلك تخرج الدولة أقوى بعد دورات الاحتجاج التي لا تعمل، في النهاية، سوى على شحذ العقيدة السلطوية .
الزمن حليف جيد للمخزن الذي لا "يأكل" خصومه، إلا على نار هادئة. وراءه في ذلك تقاليد قديمة وثقافة راسخة ودربة تاريخية في الاستنزاف والإدماج والتدجين والإغراء والإقصاء والإنهاك والتحييد.
ما يقع اليوم لحزب العدالة والتنمية، ما وقع قبلا لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليس سوى امتداد طبيعي لمدرسة كاملة في الترويض. يقول الواقع إن مخزنة فاعلي الإصلاح لا يزال مشروعا ناجحا، وإن دمقرطة المخزن، انطلاقا من دائرة المؤسسات، تبدو الآن مشروعا أقرب ما يكون إلى الاستحالة.
بعد سنواتٍ من العراك والصراع والندية، يفضل المخزن "التمثيل" بخصومه السابقين، عوض دفنهم في قبور تليق بهم باعتبارهم موتى. هكذا يعمل على تحويلهم إلى مسخ حي، إلى مجرد كاريكاتور للنسخة الأصلية، إلى بقايا صور من الماضي، إلى نقيض مطلق للقيم التاريخية، إلى أطلال مثيرة للشفقة والحنين، إلى أحزاب تدبر بأنصاف بهلوانيين، إلى مجرد ملحقاتٍ بئيسة لأحزاب الإدارة التي صنعت في مختبرات السلطة.
لذلك، تحرص الإدارة على مدهم بهواء اصطناعي وبقبل حياة اصطناعية للقيام بأدوار اصطناعية، انتقاما من التاريخ، وأساسا لأنهم في حالة "ما بعد الطبيعة"، يصبحون شهودا على انتصار مشروع الإدارة القائم على التحكّم .
باتت التحولات المجتمعية الكبرى توضح أن الدولة لم تعد قادرةً على التحكم في الزمنين، الاجتماعي والانتخابي، لكنها تعوض ذلك بتحكم غير مسبوق، إطلاقا، في الحقل الحزبي.
تحول الهشاشة الحزبية "الهبة" الانتخابية إلى حدث معزول في السياسة، وتجعل من "الحراك" الاجتماعي فاقدا للظهير السياسي وللصوت المؤسساتي.
في هذا السياق، وسيرا على موضة متمنيات السنة الجديدة، ليس هناك بتاتا أي مكان للأوهام: الرجل الجديد للمرحلة، وفقا للوصفة البائتة، قادم بلا أدنى تردد، وهو لمفارقات التاريخ ليس سوى رئيس حزب إداري خلق في عهد الملك الحسن الثاني. أنهى حزب الأصالة والمعاصرة فترة صلاحيته، موقعا على نهاية سريعة لاختيار "مختلف"، قائم على حزبٍ للدولة بخلفية إيديولوجية. حزب العدالة والتنمية سيستمر تحت الضغط والاستنزاف، إلى أن يصبح حزبا كالآخرين، بلا روح ولا مبادرة، فيما تنتظر حزب التقدم والاشتراكية جولة قاسية في صحراء التأديب السلطوي العتيق.
لذلك، وهي التجسيد الحي لإرادة التحكم الفوقي في كل ديناميات "التحت"، المعتمدة على تقاليد راسخة في الثقافة المخزنية، فإن عدوها الأول هو القرار المجتمعي المستقل (بأشكاله الحزبية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية)، وخصمها الطبيعي هو المفاجأة.
هكذا تتحول مناهضة الحزبية المستقلة إلى هوية راسخة للدولة، تعمل على تنزيلها بحزمةٍ من الأدوات والتكنولوجيا السياسية التي أعطت دائما نتائج مبهرة.
وبحكم المراس والتجربة، فقد طورت الدولة حاسة خاصة، لتدبير ارتباك المفاجآت. فعلت ذلك مثلا مع "مفاجأة إستراتيجية" من حجم الربيع العربي، و فعلت ذلك مع مفاجأة على مستوى "الفاعلين" من حجم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
ما يبدو تنازلات جزئية سرعان ما يتحول، مع الزمن، إلى مجرد حركة سحرية، أو وهم بالتنازل. أكثر من ذلك، يصبح في الواقع نوعا من إعادة انتشار الدولة. لذلك تخرج الدولة أقوى بعد دورات الاحتجاج التي لا تعمل، في النهاية، سوى على شحذ العقيدة السلطوية .
الزمن حليف جيد للمخزن الذي لا "يأكل" خصومه، إلا على نار هادئة. وراءه في ذلك تقاليد قديمة وثقافة راسخة ودربة تاريخية في الاستنزاف والإدماج والتدجين والإغراء والإقصاء والإنهاك والتحييد.
ما يقع اليوم لحزب العدالة والتنمية، ما وقع قبلا لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليس سوى امتداد طبيعي لمدرسة كاملة في الترويض. يقول الواقع إن مخزنة فاعلي الإصلاح لا يزال مشروعا ناجحا، وإن دمقرطة المخزن، انطلاقا من دائرة المؤسسات، تبدو الآن مشروعا أقرب ما يكون إلى الاستحالة.
بعد سنواتٍ من العراك والصراع والندية، يفضل المخزن "التمثيل" بخصومه السابقين، عوض دفنهم في قبور تليق بهم باعتبارهم موتى. هكذا يعمل على تحويلهم إلى مسخ حي، إلى مجرد كاريكاتور للنسخة الأصلية، إلى بقايا صور من الماضي، إلى نقيض مطلق للقيم التاريخية، إلى أطلال مثيرة للشفقة والحنين، إلى أحزاب تدبر بأنصاف بهلوانيين، إلى مجرد ملحقاتٍ بئيسة لأحزاب الإدارة التي صنعت في مختبرات السلطة.
لذلك، تحرص الإدارة على مدهم بهواء اصطناعي وبقبل حياة اصطناعية للقيام بأدوار اصطناعية، انتقاما من التاريخ، وأساسا لأنهم في حالة "ما بعد الطبيعة"، يصبحون شهودا على انتصار مشروع الإدارة القائم على التحكّم .
باتت التحولات المجتمعية الكبرى توضح أن الدولة لم تعد قادرةً على التحكم في الزمنين، الاجتماعي والانتخابي، لكنها تعوض ذلك بتحكم غير مسبوق، إطلاقا، في الحقل الحزبي.
تحول الهشاشة الحزبية "الهبة" الانتخابية إلى حدث معزول في السياسة، وتجعل من "الحراك" الاجتماعي فاقدا للظهير السياسي وللصوت المؤسساتي.
في هذا السياق، وسيرا على موضة متمنيات السنة الجديدة، ليس هناك بتاتا أي مكان للأوهام: الرجل الجديد للمرحلة، وفقا للوصفة البائتة، قادم بلا أدنى تردد، وهو لمفارقات التاريخ ليس سوى رئيس حزب إداري خلق في عهد الملك الحسن الثاني. أنهى حزب الأصالة والمعاصرة فترة صلاحيته، موقعا على نهاية سريعة لاختيار "مختلف"، قائم على حزبٍ للدولة بخلفية إيديولوجية. حزب العدالة والتنمية سيستمر تحت الضغط والاستنزاف، إلى أن يصبح حزبا كالآخرين، بلا روح ولا مبادرة، فيما تنتظر حزب التقدم والاشتراكية جولة قاسية في صحراء التأديب السلطوي العتيق.