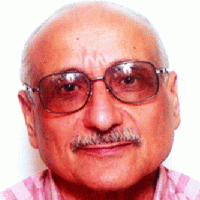20 نوفمبر 2024
عن بلادٍ بلا نهرين
تروي أسطورة بابلية أن الإله مردوخ بنى بيته على سيقان القصب، وسط الأرض المقدّسة المغمورة بالمياه، والتي شهدت أولى الحضارات قبل أكثر من ستة آلاف سنة. فرش أرضية البيت بالتراب، وبنى من حوله معابد ومساكن، ثم حفر مجريين لنهرين عظيمين، يشبهان أنهار الفردوس، هما دجلة والفرات، سرعان ما نبتت على ضفافهما الحشائش، ونمت أشجار القصب والبردي، ونشأت غابات النخيل. لم ينس مردوخ أن يقيم سدودا من أشجار القصب والتراب لدرء الفيضانات المحتملة، ولجعل الأرض المحيطة صالحة للزرع والضرع، وسجلت الملكة البابلية الحسناء سميراميس على رقيم: "استطعت أن أكبح جماح النهر القوي، ليجري على وفق رغبتي، لتروي مياهه أرضا بورا غير مسكونة، جعلتها خصبة ومأهولة، وأحكمت السيطرة على مياهه، كي تزيد مساحة الأرض الخصبة".
تلك قصة "بلاد ما بين النهرين" التي لا يعرف أحدٌ اسم أول من أطلق عليها هذه التسمية، ولعله ما كان ليطلقها لو امتد به العمر، ليشهد ما حل بنا، نحن سكان هذه البقعة من الأرض، بعد أن أوشك الماء عندنا أن ينضب، والزرع أن يجفّ، والضرع أن يختفي ويغيب، وأقدّر أنه سوف يطلق عليها في هذه الحال تسمية "بلاد بلا نهرين"!
لا أجد نفسي مغاليا، وقد سبقني في إطلاق هذه التسمية السوداء باحثٌ وعالم معروف مختص بشؤون المياه والأنهار، هو البريطاني بيتر بيامونت، الأستاذ في جامعة ويلز، والذي درس خطط إدارة المياه في الأقطار الواقعة على حوضي دجلة والفرات، وخصوصا المشاريع التي نفذتها تركيا على ضفتي النهرين، والتي ضمنت لها السيطرة الكاملة على معظم مياه الفرات، وبقدر أقل نسبيا على مياه دجلة، ونشر بحثا لم تقرأه وزارة المياه العراقية، حمل نبوءة متشائمة، أفادتنا بأن التغييرات التي تحدثها تلك المشاريع على حوضي النهرين لها نتائج كارثية على اقتصاديات الدول الأخرى المتشاطئة، اذ ستنخفض كمية المياه التي ستصل إلى العراق إلى أدنى من نصف حاجته، وسوف يكون عليه، إذا أراد تأمين حصة أكبر، أن يبادل نفطه بالماء
الصالح للشرب، لتأمين حاجة سكانه، وبالمحاصيل الزراعية لتأمين الغذاء لهم، إذ لن يجدوا ما يكفيهم، حيث ستتسع مساحات الأراضي التي يصيبها الجفاف.
ولسوء حظ العراقيين، لم تعط الحكومات التي تعاقبت على حكمهم الاهتمام الكافي لهذه المسألة، عكس تركيا التي استغلت موقعها الجغرافي الذي أتاح لها التحكم بمنابع الرافدين، زاعمة أن النهرين "تركيان عابران للحدود"، وأن من حقها أن تتصرف بمياههما كيفما شاءت، مخالفة بذلك القانون الدولي الذي يحدّد كيفية إدارة الأنهار الدولية، ومتجاهلة حقوق الجيران، وقد أقدمت على إحداث تحول في غاية الخطورة، عبر اعتماد استراتيجية تهدف إلى الحصول على أعلى إنتاجية من مياه النهرين عن طريق إقامة عشرات السدود والمنشآت والمحطات الكهرومائية، وبما ينعكس بالضرر الأكيد على العراق الذي كانت ردة فعله، في أحسن الحالات، دعوات خجولة إلى التفاوض والتنسيق، ولم يطرح خطة لمواجهة المشكلة، كما لم يمارس جهدا دبلوماسيا ضاغطا لإلزام تركيا باحترام حقوقه. وهكذا واصلت تركيا، من جانبها، تنفيذ مشاريعها، معتبرة ما تتركه للعراق من المياه "صدقةً"، تمن بها على العراقيين حسب ما تشاء، وعلى وفق دوافع إقليمية تشكل ورقة المياه واحدةً من أوراقها الرابحة.
لسنا هنا في موضع إلقاء المسؤولية على عاتق تركيا وحدها، وحتى لو تقاسمت إيران المسؤولية معها، باعتبارها مارست، هي الأخرى، سياسات خاطئة بخصوص الأنهار المتشاركة فيها، إنما المسؤولية الأكبر تقع على عاتق العراق نفسه الذي لم يتحرّك وصمت، وكأن الأمر لا يعنيه، وكل ما سمعناه من وزير المياه أن الأتراك استجابوا لطلبٍ عراقي بتأجيل عملية ملء سد أليسو العملاق بضعة أشهر، وما قالته نائبة برلمانية في تبرئة تركيا، وإلقاء اللوم على مزارعين عراقيين متنفذين استولوا على أكثر من حصصهم المائية!
مع هذا الموقف العقيم، ارتفعت أصوات خيرة محذرة ومنذرة، واجتهد ناشطون مدنيون في التنبيه إلى خطورة المشكلة، وتبعاتها المحتملة. وكان الباحث علاء اللامي قد أطلق، قبل عقدين، مع رفاق له "لجنة بلاد الرافدين بلا رافدين"، كان همها التحذير المبكر من الكارثة. وأصدر لاحقا كتاب "القيامة العراقية الآن" الذي شرح فيه أبعادها، وهو يواصل جهده اليوم عبر الصحف ومواقع التواصل، لكن المسؤولين الحكوميين لا عيونهم رأت، ولا آذانهم سمعت.
تلك قصة "بلاد ما بين النهرين" التي لا يعرف أحدٌ اسم أول من أطلق عليها هذه التسمية، ولعله ما كان ليطلقها لو امتد به العمر، ليشهد ما حل بنا، نحن سكان هذه البقعة من الأرض، بعد أن أوشك الماء عندنا أن ينضب، والزرع أن يجفّ، والضرع أن يختفي ويغيب، وأقدّر أنه سوف يطلق عليها في هذه الحال تسمية "بلاد بلا نهرين"!
لا أجد نفسي مغاليا، وقد سبقني في إطلاق هذه التسمية السوداء باحثٌ وعالم معروف مختص بشؤون المياه والأنهار، هو البريطاني بيتر بيامونت، الأستاذ في جامعة ويلز، والذي درس خطط إدارة المياه في الأقطار الواقعة على حوضي دجلة والفرات، وخصوصا المشاريع التي نفذتها تركيا على ضفتي النهرين، والتي ضمنت لها السيطرة الكاملة على معظم مياه الفرات، وبقدر أقل نسبيا على مياه دجلة، ونشر بحثا لم تقرأه وزارة المياه العراقية، حمل نبوءة متشائمة، أفادتنا بأن التغييرات التي تحدثها تلك المشاريع على حوضي النهرين لها نتائج كارثية على اقتصاديات الدول الأخرى المتشاطئة، اذ ستنخفض كمية المياه التي ستصل إلى العراق إلى أدنى من نصف حاجته، وسوف يكون عليه، إذا أراد تأمين حصة أكبر، أن يبادل نفطه بالماء
ولسوء حظ العراقيين، لم تعط الحكومات التي تعاقبت على حكمهم الاهتمام الكافي لهذه المسألة، عكس تركيا التي استغلت موقعها الجغرافي الذي أتاح لها التحكم بمنابع الرافدين، زاعمة أن النهرين "تركيان عابران للحدود"، وأن من حقها أن تتصرف بمياههما كيفما شاءت، مخالفة بذلك القانون الدولي الذي يحدّد كيفية إدارة الأنهار الدولية، ومتجاهلة حقوق الجيران، وقد أقدمت على إحداث تحول في غاية الخطورة، عبر اعتماد استراتيجية تهدف إلى الحصول على أعلى إنتاجية من مياه النهرين عن طريق إقامة عشرات السدود والمنشآت والمحطات الكهرومائية، وبما ينعكس بالضرر الأكيد على العراق الذي كانت ردة فعله، في أحسن الحالات، دعوات خجولة إلى التفاوض والتنسيق، ولم يطرح خطة لمواجهة المشكلة، كما لم يمارس جهدا دبلوماسيا ضاغطا لإلزام تركيا باحترام حقوقه. وهكذا واصلت تركيا، من جانبها، تنفيذ مشاريعها، معتبرة ما تتركه للعراق من المياه "صدقةً"، تمن بها على العراقيين حسب ما تشاء، وعلى وفق دوافع إقليمية تشكل ورقة المياه واحدةً من أوراقها الرابحة.
لسنا هنا في موضع إلقاء المسؤولية على عاتق تركيا وحدها، وحتى لو تقاسمت إيران المسؤولية معها، باعتبارها مارست، هي الأخرى، سياسات خاطئة بخصوص الأنهار المتشاركة فيها، إنما المسؤولية الأكبر تقع على عاتق العراق نفسه الذي لم يتحرّك وصمت، وكأن الأمر لا يعنيه، وكل ما سمعناه من وزير المياه أن الأتراك استجابوا لطلبٍ عراقي بتأجيل عملية ملء سد أليسو العملاق بضعة أشهر، وما قالته نائبة برلمانية في تبرئة تركيا، وإلقاء اللوم على مزارعين عراقيين متنفذين استولوا على أكثر من حصصهم المائية!
مع هذا الموقف العقيم، ارتفعت أصوات خيرة محذرة ومنذرة، واجتهد ناشطون مدنيون في التنبيه إلى خطورة المشكلة، وتبعاتها المحتملة. وكان الباحث علاء اللامي قد أطلق، قبل عقدين، مع رفاق له "لجنة بلاد الرافدين بلا رافدين"، كان همها التحذير المبكر من الكارثة. وأصدر لاحقا كتاب "القيامة العراقية الآن" الذي شرح فيه أبعادها، وهو يواصل جهده اليوم عبر الصحف ومواقع التواصل، لكن المسؤولين الحكوميين لا عيونهم رأت، ولا آذانهم سمعت.