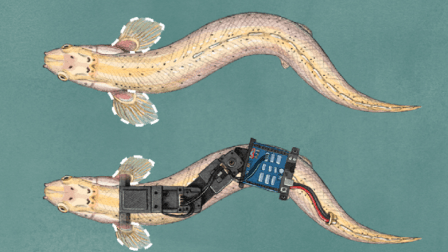ربما كان غلين، الشغوف بالتكنولوجيا، والكاره للعروض الحية، ليعجب بهذه التقنية التي ستسمح لعروضه بالانتشار على نطاق واسع، من دون أن يضطر إلى الوجود بشكل فعلي على الخشبة التي تسببت له بضيق شديد.
بعد ثلاثة أعوام من بدء الكساد العظيم، في عام 1932، ولد غلين هربيرت غولد، لأم تبلغ من العمر اثنتين وأربعين سنة. ولادته المفاجئة بعد معاناة أهله الطويلة مع الإنجاب، وثقل موهبته الموسيقية، جعلا من حضوره حدثاً بارزاً. شبهه أحد أصدقائه بظهور سلسلة جبال في الفناء الخلفي لمنزلٍ ما.
عرف والدا غولد على الحال أنهما أمام عبقري موسيقي، فاستطاع معرفة النغمات المؤلفة منها أغنية ما، قبل أن يستطيع قراءة كلماتها حتى؛ إذ كان غولد في الثالثة من عمره فقط عندما اكتشف والداه امتلاكه هبة "الأذن الموسيقية المطلقة"؛ وهو المصطلح الذي يصف ظاهرة موسيقية تتجلى لدى قلة فقط ممن يمتلكون قدرات موسيقية عالية ومتعددة منها؛ القدرة على التعرف إلى العلامة الموسيقية، أو إعادة إنتاجها من دون الحاجة إلى نغمة مرجعية أو حتى إلى نوطة.
عُرفت هذه الظاهرة الموسيقية لدى عديد كبير من الموسيقيين العظام، منهم موزارت الذي يُحكى أنه، في سن الرابعة عشرة، أعاد كتابة لحن مقطوعة miserere، للكاهن والمؤلف الموسيقي غريغوريو أليغري، والتي كانت قد فرضت عليها حراسة مشددة من قبل الكنيسة، اعتماداً على ذاكرته السمعية فحسب. كذلك الأمر بالنسبة إلى باخ، الذي سيكون له التأثير الأعظم على حياة غولد الموسيقية.
لم تكن هذه الهبة وحدها التي نحتت موهبة غولد، فمن المعروف أنه نشأ في أسرة موسيقية؛ والده عازف كمان، مارس العزف حتى تسبب لنفسه بإصابة دائمة في يده جرّاء التدرّب المستمر، كذلك والدته كانت عازفة بيانو وصاحبة صوت عذب، وهي التي كانت مسؤولة عن تعليمه الموسيقي حتى سن العاشرة تقريباً.
بعدها، بدأ غولد بتلقي الدروس الموسيقية التي كلفت عائلته قرابة الثلاثة آلاف دولار سنوياً. لم يكن هذا الشغف الموسيقي بالجديد على عائلة غولد الذين تجمعهم قرابة بعيدة بالمؤلف الموسيقي النرويجي، إيدفارد غريغ، الذي لم يعجب غولد بكونشيرتو البيانو خاصته، وهو الرافض لمعظم معايير الموسيقى الرومانسية. في حين لاقت موسيقى الباروك، والمدرسة الباروكية الجديدة، ومدرسة شونبيرغ؛ فيينا الثانية، إعجاباً وتقديراً لديه.
كان غولد موضوعاً لعدد كبير من الأفلام القصيرة والوثائقية، حتى أن الكاتب النمساوي الشهير توماس بيرنهارد جعله بطلاً لإحدى رواياته القصيرة، كما وُضع عديدٌ من الكتب التي تناولت حياته الشخصية وعلاقاته العاطفية بالنساء عامة، وبأمه فلورانس بشكل خاص.
ولعل السبب في ذلك، إلى جانب موهبته الموسيقية الفذة، يعود إلى الهالة التي أحاطت بشخصيته غير المتوقعة والمثيرة للاهتمام، بفضل آرائه الموسيقية الصادمة من ناحية، وغرابة سلوكه وتصرفاته من ناحية أخرى. إذ أشيع عن غولد، كموزارت أيضاً، معاناته من نوع من اضطرابات طيف التوحد، يُعرف بمتلازمة آسبرغر.
لكن هذه المزاعم التي احتلت نصيباً كبيراً في وسائل الإعلام، بقيت موضع جدل لم يحسم حتى يومنا هذا؛ إذ أن كل ما ذُكر، أو شوهد، على أنه أعراض ودلالات واضحة لمتلازمة آسبرغر، قد لا يتعدى كونه رهاباً مرضياً، أو طبيعة منطوية لعبقري انحل تماماً في موسيقاه، خصوصاً أن هذا التشخيص لحالة غولد لم يأتِ إلّا بعد رحيله، عام 1982، بسنوات عديدة تطورت خلالها الدراسات حول التوحد.
ما كان واضحاً ومؤكداً بالنسبة لغولد، هو نفوره من لمس الآخرين لجلده، الأمر الذي تسبب بارتدائه للمعطف الشتوي والقفازات حتى في أيام الصيف الحارقة، خوفاً من الاحتكاك بالجراثيم. إضافة إلى ذعره من السفر بالطائرات، وتحركات جسده القلقة، خصوصاً خلال العروض الحية، كتأرجحه المستمر إلى الأمام والخلف على مقعد البيانو المهترئ الذي يأبى تغييره، أو كأن يلعب دور المايسترو أثناء العزف؛ فيقود نفسه بيد واحدة، بينما يعزف بأخرى، أو عبر همهماته المسموعة والتي كانت تستمر طوال العرض مثيرةً دهشة الجمهور، وكذلك أثناء تسجيلات الاستوديو متسببة بالعديد من المشاكل التقنية لمهندسي الصوت.
عُرف غولد، في كندا، بسبب عروضه المستمرة التي بثت عبر التلفاز والراديو. ستشكل هذه العادة في العمل ضمن مكان منعزل ومغلق، واحدة من الأسباب المهمة التي تجعله لاحقاً يفضّل العمل في الاستوديو على الأداء الحي. قدّم غولد أول أداء احترافي له عام 1945، مع أوركسترا تورنتو؛ حيث أدى الحركة الأولى من كونشيرتو البيانو الرابع لبيتهوفن. بعدها بوقت قصير، سيقدم غولد آخر أداء علني له في لوس أنجيلوس، ليتجه لاحقاً إلى الأداء الإذاعي والمسجّل. إضافة إلى كتابة المقالات والمحاضرات والأطروحات التي عبّر من خلالها عن فلسفته الموسيقية.
رأى غولد أن المبرر الوحيد لأن يعيد الموسيقي أداء عمل ما، يتمثل في قدرته على تقديمه بطريقة مختلفة تماماً عن أصله. إن هذا الاختلاف الذي يقدمه الموسيقي، هنا، هو اختلافه الخاص، وبصمته التي تميزه عن غيره من أعداد لا حصر لها من الموسيقيين، فكان غولد يشجع أقرانه على عدم التزام التفاصيل المكون منها عمل ما، مؤكداً أن مؤلف العمل ذاته لم يكن ليراعي هذه التفاصيل أو يلتزم بها أيضاً؛ فلا يجب أن يُقدم أي عمل بذات الطريقة مرتين وإن كان ذلك من قبل مؤدٍ واحد.
هذا بالضبط ما سعى إليه غولد ونجح في تحقيقه عند تسجيله موسيقى Goldberg Variations، وهو عمل كتبه باخ لآلة الهاربيسكورد، وأعاد غولد تقديمه على آلة البيانو بصيغة ألبوم بعد مضي أكثر من قرن على تأليفه، ليكون هذا الألبوم الحامل للعنوان ذاته أولى نتائج تعاونه مع شركة كولومبيا للتسجيلات عام 1955.
يعيد غولد في عام 1981 تسجيل الموسيقى ذاتها، لكن بإيقاع أبطأ هذه المرة، وبتدفق متواصل يربط بين التنويعات الثلاثين بسلاسة غريبة. لقد فهم غولد تماماً ألغاز باخ اللحنية، وكذلك البنية الطباقية لموسيقاه، وفن الفيوغ؛ عمل باخ العظيم الذي لم تشأ له الأقدار إكماله، كذلك الأمر بالنسبة إلى غولد الذي لم يؤد إلّا بعض حركاته، على آلتي الأورغن والبيانو، قبل عام واحد من وفاته بسن الخمسين.
في عام 1964، أعلن غولد امتناعه نهائياً عن الأداء الحي على خشبة المسرح، إذ سرعان ما أدرك الموسيقي أنه لم يكن الرجل المناسب لـ"عالم الاستعراض"، فكان يسعى إلى الانعزال آملاً بأن التقاعد القريب سيمهد له الطريق إلى احتراف التأليف الموسيقي الذي لطالما وضعه نصب عينيه، إذ يبدو أن غولد لم يكن يتعامل مع البيانو إلا كأداة ستحقق له غايته الأعظم.
وفي حين قدّم غولد العديد من التفسيرات لهذا القرار المفاجئ، إلّا أن السبب المرجح والأكثر إقناعاً، يعود إلى نظرته حول غاية الفن وهدفه البعيد كل البعد عن تحقيق النشوة الخاطفة للفنان؛ ففي نص كتبه عام 1962 تحت عنوان "لنمنع التصفيق"، يرى غولد أن الغرض من الفن لا يتمثل في ما يسميه "الإفراز المؤقت للأدرينالين".
إن الفن هو حالة مستمرة من الدهشة والسكون تحيط بكل من الفنان والمتلقي على حد سواء. وخلق مسافة بين المتلقي والفنان، سيحقق انعتاقاً لكليهما؛ الفنان من مطالب الجمهور التي تثقل عمله الفني وتزحزحه عن مساره المخطط له مسبقاً، والجمهور من نرجسية الفنان ودكتاتوريته التي لا تقبل النقاش.
يصف غولد الفنان بالدكتاتور الاجتماعي، الذي يحكم جمهوراً لا يمتلك إلى حد كبير حق انتخابه. إن العلاقة الأمثل بين المتلقي والفنان يجب أن تشابه جملة رياضية بسيطة: "من واحد إلى صفر"، على حد تعبيره. ومن المهم أن يُمنح الفنان الحق في أن يكون مجهولاً في هذه المعادلة، وبعيداً كل البعد عن معايير "السوق".
بهذا، يشكل الاستديو الفسحة الآمنة التي يمكن من خلالها صنع العمل الفني ضمن بيئة مخبرية تصل بالموسيقى إلى أعلى درجات الكمال. وليس التسجيل نسخة مزيفة، يُحكم عليها دوماً بالمقارنة مع أصلها الحي، وتقاس قيمتها بمقدار دقتها في التطابق مع الأصل. بل على العكس، للتسجيل هوية مغايرة تماماً لهوية أصله، إذ تكمن مهمته الصعبة في تحسين العمل الفني وتحريره من الشوائب التي تفترضها ظروف المكان والزمان، كسعلة عابرة أو حشرجة أو لون قبعة يشتت تركيز المؤدي، أو ارتكابه الأخطاء التقنية والموسيقية التي من شأنها تشويه مثالية عمله.
إن الهدف من هذه الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تسمح بالإعادة والتكرار والنسخ واللصق، يكمن في إنتاج موسيقى قادرة على خلق علاقة حميمية ومباشرة مع المتلقي، حيث لا شيء سوى الموسيقى، والموسيقى فحسب. وهو الأمر المعاكس تماماً لما يراه البعض فيها من عوامل فصل وإبعاد بين المتلقي والعمل الفني.
لم يعتقد غولد أن الأشكال الأخرى لتلقي الموسيقى، الكلاسيكية تحديداً، كانت أكثر قدرة على خلق علاقة متينة بين المتلقي والفنان، إذ لا يرى أن "طقسية" الحدث الفني والبعد الجماعي له، قادران على إشراك المتلقي بالعملية الفنية، بل على النقيض من ذلك، كلما زاد عدد المشاركين في فعالية فنية ما، يضاف مزيد من الضبابية والمجهولية على المتلقي الفردي.
بهذا، يتحول الأداء الحي إلى آخر ميت، ما دام لن يسمح للمتلقي بإعادة إرسال ما أُرسل إليه أصلاً، ذلك أن هذا الأخير كان قد دفع مبلغاً من المال لقاء سماع ما يريد الفنان قوله، ولكن العكس لم يحصل. وفي توكيد وترسيخ لثنائية المتلقي/ الفنان التي يدّعي الأداء الحي تفتيتها. كما لم ير غولد في النظرية الشائعة حول "هالة" العمل الفني، التي تخلقها التفاعلات المتبادلة بين المتلقي والفنان، إلا نوعاً من الـ"أسطرة" للأداء الحي.
مثل هذه الأسطورة، لا تجد لها أصداءً في فن السينما مثلاً، فهل يقلل اعتماد هذا الفن على الوساطة الآلية من اندماج المشاهدين مع ما يُقدم لهم من محتوى بصري أو سمعي في فيلم ما؟
لقد شكلت مقولة غولد حول انتماء دار الأوبرا إلى الماضي، ماضي الموسيقى بالتحديد، واحدة من أشد المقولات استفزازاً وإثارة للجدل في عصرها، فراح البعض يعزونها إلى ضعف قدرته على العزف، أو إلى شخصيته غير الاعتيادية، فيبدو أن رغبة غولد بالابتعاد عن عالم الاستعراض، حولت حياته بحد ذاتها إلى حدث، ووضعت مزيداً من الضوء على شخصيته التي بدت في نظر كثيرين أكثر أهمية من نظرته المستقبلية للدور الذي ستلعبه التكنولوجيا في خدمة الموسيقى.
في النهاية، كانت الموسيقى وحدها ما يشغل بال غولد. الفن بالنسبة إليه ليس تحدياً، ولا مناسبة اجتماعية لاستعراض العضلات من أي نوع كانت. لقد ذعر غولد من روح المنافسة التي تفيض بها العروض الحية بشكل خاص. ولم يكن أمامه سوى الانسحاب إلى عالمه المنغلق، فاختار أن يبقى جبلاً في الفناء الخلفي لمنزله، منعزلاً، متوحداً مع ذاته في شماله البعيد، حيث يمكن له مواصلة العمل والاستكشاف.