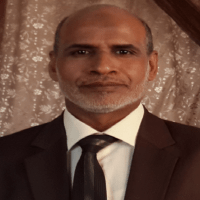31 أكتوبر 2017
نتنياهو "واعظاً" في باريس
بدا المشهد سوريالياً، رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي فتكت طائراته بآلاف الفلسطينيين في غزة وسوّت منازلهم بالأرض، قبل أربعة أشهر فقط، يقف في الصف الأول من القادة الذين قادوا مسيرة باريس التي عبّرت عن تضامن العالم مع فرنسا. وفي الصف الثاني، سار وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، الذي يجاهر بأن الحل الوحيد الذي يضمن الهدوء في غزة يتمثل في إلقاء قنبلة نووية عليها. وفي الصف الثالث، كان وزير الاقتصاد، نفتالي بنات، الذي اقتبست عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل أشهر قوله، في إحدى جلسات مجلس الوزراء المصغر لشؤون الأمن: "ما المشكلة في قتل العرب، قتلت خلال خدمتي في وحدتي سييرت متكال وماجلان كثيرين منهم"، من دون أن يبدي زملاؤه أي اعتراض. ما حدث في باريس يستحق الإدانة والتنديد، فالقتل ليس وسيلة للاحتجاج على ما نشرته مجلة "شارلي إيبدو". لكن، ما هو أكثر فظاعة أن يسمح لكبار القتلة الذين يمارسون إرهاب الدولة المنظم بأن يستغلوا هذا الحدث تحديداً، لتبرير جرائمهم بأثر رجعي. فبكل وقاحة، اعتبر نتنياهو أن ما حدث في باريس يدلل على أن العالم كان مطالباً "بإبداء تأييد أكثر قوة لإسرائيل خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة". فنتنياهو الذي يتقن فن خلط الأوراق، بغرض إضفاء شرعية على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد الفلسطينيين في غزة؛ يحاول تجنيد النخب السياسية والرأي العام في الغرب، للمساواة بين منفذي الهجمات في باريس والمقاومة الفلسطينية. فقد زعم نتنياهو أن الحوافز التي تحرك المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل هي نفسها التي حركت منفذي الهجمات في باريس. وكأن الشعب الفلسطيني لا يقاوم احتلالاً بغيضاً، يمثل أفظع أشكال الإرهاب. من أسف، فإن الذي شجع نتنياهو وزملاءه على التشبث بمنطقه الوقح والمستفز، هو النفاق العالمي الذي تعاطى مع أحط الإرهابيين الصهاينة كرجال كدولة، يجب أن يُقدّروا ويحترموا.
في كتابه "التمرد"، اعتبر رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، مناحيم بيغن، والذي كان يقود التنظيم الإرهابي "ليحي"، أن المجزرة البشعة التي نفذها ذلك التنظيم في قرية دير ياسين في التاسع من أبريل/نيسان 1948 هي "الانتصار الذي قاد إلى إنشاء إسرائيل". ولقد دانت
سلطات الانتداب البريطاني، في حينه، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق شامير، الذي كان يعمل تحت إمرة بيغن، بالمسؤولية عن قتل وجرح المئات من الفلسطينيين، حيث قام شخصياً بتفخيخ الأسواق الشعبية في حيفا ويافا وغيرها من المدن في النصف الأول من عام 1948، بغرض تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من أراضيهم. كان بيغن وشامير مسؤولين عن قتل عشرات من الضباط والجنود البريطانيين في فلسطين، ومع ذلك، لم يعبر أحد من قادة الغرب عن أي موقف أخلاقي إزاء هذه الجرائم، ولم يشر أحد ما إلى أن أيدي هذين الإرهابيين ملطختان بالدماء، كما اعتادت إسرائيل على وصف الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.
كان يكفي الغرب مراقبة ما حدث في الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود" قبل أسبوعين فقط، لكي يلمس اتساع حاضنة الإرهاب وعمقها في الفكر والممارسة السياسية الصهيونية. فقد اختار آفي ديختر، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، أن يقنع منتسبي الليكود بالتصويت له، بلفت أنظارهم إلى أنه المسؤول عن أكبر عدد من عمليات الاغتيال التي طالت الفلسطينيين في أثناء انتفاضة الأقصى (ميكور ريشون 30-12-2014). ولا حاجة للتذكير بأنه، حسب معطيات المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، فإن أكثر من 50% من الذين قتلوا في هذه العمليات مدنيون ليس لهم أية علاقة بحركات المقاومة الفلسطينية. بكل تأكيد، يلاحظ ممثلو السفارات الغربية في تل أبيب، في الآونة الأخيرة، أن الوزراء والنواب الصهاينة من الأحزاب اليمينية المرشحة للبقاء في الحكم يحاولون تحسين فرص أحزابهم، من خلال "الحج" إلى الحاخامات الذين لعبوا دوراً مهما في التحريض على قتل المدنيين الفلسطينيين. ماذا يمكن أن يفهم الشباب الصهيوني، عندما يرون وزير الإسكان، أوري أرئيل، يرتمي في أحضان الحاخام إسحاق شابيرا الذي ألف قبل ثلاث سنوات "مصنفه الفقهي"، والذي أطلق عليه "شريعة الملك"، ويجيز فيه قتل الأطفال العرب الرضع، بزعم أن هؤلاء عندما يكبرون "سيصبحون أعداءً لإسرائيل".
لكن، على الرغم من قبح النفاق الغربي تجاه الإرهاب الصهيوني، فإنه يظل أقل قبحاً من القادة العرب الذين شاركوا في مسيرة باريس، لم يظهروا تضامناً مع ضحايا الإرهاب الصهيوني من الفلسطينيين. قطع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، آلاف الكيلو مترات لكي يشارك في مسيرة باريس، التي فقدت 17 من مواطنيها في الاعتداءات الأخيرة، لكن سقوط 2250 إنسان من أبناء شعبه وجرح آلاف آخرين في الحرب الأخيرة غزة، لم يكن مسوغاً لكي ينتقل إلى القطاع، على الأقل لمواساة أبناء شعبه، وهو الفعل الذي بادر إليه مسؤولون أجانب. ولا حاجة للتذكير بملاحظات نتنياهو في أثناء الحرب الأخيرة على غزة، عندما أكد، أكثر من مرة، أن إسرائيل تخوض هذه الحرب في ظل تفهم النظم العربية "المعتدلة" في المنطقة ودعمها. من هنا، لم يكن غريباً أن يوظف نتنياهو أحداث فرنسا، ليلعب دور المدافع عن الإنسانية في مواجهة خطر الإسلام الذي يهدد "بإعادة البشرية ألف عام إلى الوراء"، كما زعم. ولم يكن مستهجناً أن تستغل إسرائيل أحداث باريس لدعوة العالم إلى اكتشاف "مزايا" التحالف مع الأنظمة العربية "المعتدلة"، على اعتبار أن مثل هذا التحالف يضمن "الانتصار على الإسلام المتطرف".
ما كان ينبغي أن يُسمح لنتنياهو بأن يستغل أحداث باريس لخلط الأوراق، ويغرق العالم في حفلة وعظ كاذبة ومضللة. وعلى الغرب أن يدرك أنه، في هذا الوقت تحديداً، مطالب بموقف أخلاقي بشأن المأساة التي يحياها الفلسطينيون، في ظل آخر احتلال إحلالي في هذا العالم.
في كتابه "التمرد"، اعتبر رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، مناحيم بيغن، والذي كان يقود التنظيم الإرهابي "ليحي"، أن المجزرة البشعة التي نفذها ذلك التنظيم في قرية دير ياسين في التاسع من أبريل/نيسان 1948 هي "الانتصار الذي قاد إلى إنشاء إسرائيل". ولقد دانت
كان يكفي الغرب مراقبة ما حدث في الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود" قبل أسبوعين فقط، لكي يلمس اتساع حاضنة الإرهاب وعمقها في الفكر والممارسة السياسية الصهيونية. فقد اختار آفي ديختر، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، أن يقنع منتسبي الليكود بالتصويت له، بلفت أنظارهم إلى أنه المسؤول عن أكبر عدد من عمليات الاغتيال التي طالت الفلسطينيين في أثناء انتفاضة الأقصى (ميكور ريشون 30-12-2014). ولا حاجة للتذكير بأنه، حسب معطيات المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، فإن أكثر من 50% من الذين قتلوا في هذه العمليات مدنيون ليس لهم أية علاقة بحركات المقاومة الفلسطينية. بكل تأكيد، يلاحظ ممثلو السفارات الغربية في تل أبيب، في الآونة الأخيرة، أن الوزراء والنواب الصهاينة من الأحزاب اليمينية المرشحة للبقاء في الحكم يحاولون تحسين فرص أحزابهم، من خلال "الحج" إلى الحاخامات الذين لعبوا دوراً مهما في التحريض على قتل المدنيين الفلسطينيين. ماذا يمكن أن يفهم الشباب الصهيوني، عندما يرون وزير الإسكان، أوري أرئيل، يرتمي في أحضان الحاخام إسحاق شابيرا الذي ألف قبل ثلاث سنوات "مصنفه الفقهي"، والذي أطلق عليه "شريعة الملك"، ويجيز فيه قتل الأطفال العرب الرضع، بزعم أن هؤلاء عندما يكبرون "سيصبحون أعداءً لإسرائيل".
لكن، على الرغم من قبح النفاق الغربي تجاه الإرهاب الصهيوني، فإنه يظل أقل قبحاً من القادة العرب الذين شاركوا في مسيرة باريس، لم يظهروا تضامناً مع ضحايا الإرهاب الصهيوني من الفلسطينيين. قطع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، آلاف الكيلو مترات لكي يشارك في مسيرة باريس، التي فقدت 17 من مواطنيها في الاعتداءات الأخيرة، لكن سقوط 2250 إنسان من أبناء شعبه وجرح آلاف آخرين في الحرب الأخيرة غزة، لم يكن مسوغاً لكي ينتقل إلى القطاع، على الأقل لمواساة أبناء شعبه، وهو الفعل الذي بادر إليه مسؤولون أجانب. ولا حاجة للتذكير بملاحظات نتنياهو في أثناء الحرب الأخيرة على غزة، عندما أكد، أكثر من مرة، أن إسرائيل تخوض هذه الحرب في ظل تفهم النظم العربية "المعتدلة" في المنطقة ودعمها. من هنا، لم يكن غريباً أن يوظف نتنياهو أحداث فرنسا، ليلعب دور المدافع عن الإنسانية في مواجهة خطر الإسلام الذي يهدد "بإعادة البشرية ألف عام إلى الوراء"، كما زعم. ولم يكن مستهجناً أن تستغل إسرائيل أحداث باريس لدعوة العالم إلى اكتشاف "مزايا" التحالف مع الأنظمة العربية "المعتدلة"، على اعتبار أن مثل هذا التحالف يضمن "الانتصار على الإسلام المتطرف".
ما كان ينبغي أن يُسمح لنتنياهو بأن يستغل أحداث باريس لخلط الأوراق، ويغرق العالم في حفلة وعظ كاذبة ومضللة. وعلى الغرب أن يدرك أنه، في هذا الوقت تحديداً، مطالب بموقف أخلاقي بشأن المأساة التي يحياها الفلسطينيون، في ظل آخر احتلال إحلالي في هذا العالم.