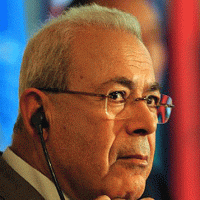17 أكتوبر 2024
نزاع فصائل الغوطة ومنطق إمارات الحرب
تدخل المواجهات الدموية بين فصائل إسلامية مسلحة في غوطة دمشق أسبوعها الثاني، في الوقت الذي تحتدم فيه الصراعات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية من أجل إنهاء الأزمة السورية على حساب الشعب السوري وحقوقه. وبينما تتذرّع الدول المختلفة، بما فيها دول كانت تعتبر نفسها صديقةً للشعب السوري، بالفوضى وعدم الثقة بقدرة فصائل المعارضة المسلحة المختلفة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أي اتفاقٍ محتملٍ للسلام، أو بإمكانية فصلها عن الجماعات المتطرفة التي حكم عليها مجلس الأمن والدول الراعية للحل السياسي بالاستبعاد من وقف إطلاق النار، لا يبدو الأمل كبيراً بإمكانية التوصل إلى تسويةٍ تنهي الخلافات المستمرة والمتزايدة بين الفصائل، والتي ستزداد مع احتمال تراجع الدعم المالي والمسلح أو تفاقم الضغط العسكري، وتضع حداً نهائياً للتضحية المجانية بمئات الشباب السوريين، المفترض أنهم وهبوا حياتهم للدفاع عن حقوق شعبهم ووطنهم، لا لنصرة هذه الزعامة أو تلك. وهذه أعظم هديةٍ، تقدمها فصائل من المعارضة، أو المحسوبة عليها، للأسد وحلفائه، كي يعزّزوا الطرح الذي بدأ يتنامى، في الأشهر الأخيرة، للإبقاء على النظام، بل على رئاسة الأسد نفسها، فترة مقبلة، ضماناً، كما يدّعون، للحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرارها. وحجتهم الرئيسية أن المعارضة المقسّمة، والمتضاربة الأهداف، من إسلامية وغير إسلامية، ومعتدلة ومتطرفة، تفتقر للوحدة والانسجام الكافيين والضروريين، للقيام بأعباء السلطة والحفاظ على الدولة، وحمل مسؤولية قيادة البلاد. كما تشكل هذه النزاعات المتواترة بين فصائل مختلفة من المعارضة الذريعة المثلى، وفي أحرج الأوقات والظروف، للعديد من الأطراف المعادية لتطلعات الشعب السوري من أجل الانسحاب من الالتزامات التي ترتبها عليها، وعلى النظام الأسدي، القرارات الدولية، وإنكار حق السوريين في راهنية انتقال ديمقراطي، يؤسس لنظامٍ جديد قائم على سيادة الشعب واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وتخضع فيه السلطة، كبقية الأطراف الاجتماعية والمؤسسات، لحكم القانون والنقد والمساءلة والحساب.
لا يزال من غير المؤكد أن تنجح النداءات التي أطلقتها شخصيات دينية وقطاعات واسعة من الرأي العام المعارض، ومنها مبادرات المجلس الإسلامي السوري والعديد من العلماء وشيوخ المسلمين، في إطفاء نار الاحتراب بين "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" اللذين ينتميان كلاهما إلى فصائل إسلامية، من المفروض أنها تقدّم مثالاً للتجرّد عن الهوى ونكران الذات والقتال من أجل أهدافٍ وغاياتٍ دينيةٍ ووطنية. والسبب في فشل هذه الجهود الدينية وانهيار التسويات، واحدتها بعد الأخرى، ليس وجود خلافات عقائدية أو سياسية من أي نوع. كما أنه ليس للاقتتال الذي أودى بحياة أكثر من 700 ضحية في الأيام القليلة الماضية، أي علاقة بالدين، وإنما هو جزء من الصراع على السلطة والنفوذ والموارد التي تميّز سلوك واستراتيجيات إمارات الحرب التي لا يمكن أن تتعايش في ما بينها، وتسعى كل منها إلى بناء سلطتها السيادية الخاصة على الرقعة التي تحتلها من الأرض، بصرف النظر عن الأهداف والغايات والمصالح الوطنية الكلية. وعندما يتفاقم عليها الضغط، لا تجد لديها مخرجاً للدفاع عن بقائها، أو تعظيم مواردها ومكاسبها وتقوية شوكتها، سوى بالاعتداء على جيرانها، وبأكل والتهام الإمارات الأخرى الأضعف منها، واستملاك مواردها المادية والبشرية واحتلال مواقعها.
وكانت النتيجة الطبيعية لهذه المواجهات، وانشغال الفصائل بقتال بعضها بعضاً، حتى الآن، خسارة القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية بأكمله، وسقوطه في يد النظام، وتهديد مواقع أخرى، وكشفها أمام هجمات النظام الجديدة. ومهما نجح الوسطاء في دفع الطرفين إلى توقيع اتفاقاتٍ وتعهداتٍ وتسوياتٍ لن تصمد طويلاً، لا أعتقد أن هناك أملا كبيرا في تجنب مواجهات جديدة، طالما بقي منطق إمارات الحرب سائداً عند الفصائل، ولم ينجح القادة العسكريون والسياسيون في التوصل إلى اتفاق لدمج القوات، أو على الأقل لتشكيل قيادةٍ واحدةٍ، تشرف على عمل الفصائل، وتنسق في ما بينها، وتنظم قتالها على أساس خطة وأهداف وطنية واضحة ومتكاملة.
وفي جميع الأحوال، لم يكن هناك، ولا يوجد، سبب واحد يمكن أن يبرّر استماتة الفصائل في الدفاع عن استقلالها، ورفض الاندراج تحت قيادةٍ واحدةٍ، سوى هذا المنطق وحده الذي يشترط وجودها، أعني منطق إمارات الحرب الذي يشير إلى بنيةٍ يكون فيها القائد هو أمير الجماعة، ويكون المقاتلون أتباعاً له وموالين، يأتمرون بأوامره، ويخضعون لإرادته ويخدمون أهدافه، وليس لمؤسسةٍ وطنيةٍ مستقلةٍ عن الأفراد، وخاضعةٍ لأعرافٍ وأصولٍ وقوانين وقواعد معروفةٍ وثابتةٍ وواحدةٍ بالنسبة للجميع، كما الحال في الجيوش وحركات التحرير الوطنية. ولا تستطيع أي عقيدة، دينيةٍ أو دنيويةٍ، أن تلغي متطلبات هذا المنطق وديناميكياته التي تتحكّم بأمراء الحرب، المتدينين منهم وغير المتدينين، وفي كل الأزمان والبلدان. فهو يتعلق بمسألةٍ مصيرية، هي أن يبقى الفصيل أو يزول. وقد كان خطأ المعارضة، منذ البداية، أنها قبلت التعايش مع مئات الفصائل المستقلة والمتكرّرة والمتوازية والمتناحرة، وأذعنت لرفض قادتها الاندماج في هيئةٍ أو جيشٍ وطنيٍّ واحد للتحرير، يخضع لقيادةٍ واحدةٍ واستراتيجيةٍ سياسيةٍ وطنيةٍ واعية، بعد إخفاق محاولة المجلس الوطني، منذ الأشهر الأولى لولادته، في تحقيق مشروع إعادة هيكلة الفصائل، بالتعاون مع العسكريين المنشقين، وتكوين جيش وطني جديد، بسبب التناحر الداخلي بين شخصيات المعارضة، ومقاومة قادة الفصائل المسلحة، وبشكل أكبر، تشجيع الدول الداعمة التي كانت تراهن على تعزيز ولاء الزعامات المتعدّدة لها، وتثبيتها في مواقعها لضمان نفوذها ودورها في الحرب، كما في تقرير مستقبل البلاد في ما بعد.
بالتأكيد، لا تنفي سيطرة منطق أمراء الحرب، الفاعل على المدى الطويل، وجود الأسباب المباشرة والاحتكاكات التي فجرت الصراع الكامن، ودفعت الفصيلين إلى تقديم الحرب بينهما على الحرب مع النظام. لكن، ما حصل في الغوطة الشرقية، وتسبب في تمكين النظام من احتلال عشرات المواقع والقرى الاستراتيجية، يمكن أن يحصل في كل مكان وبين جميع الفصائل الموجودة اليوم، وبشكل خاص الفصائل الإسلامية، بمقدار ما وظف أمراء هذه الفصائل الدين لشرعنة الانقسام، وتعدد الإمارات والقيادات، وقطع الطريق على ولادة قيادةٍ وطنيةٍ واحدة، تقود العملية العسكرية والسياسية ضد نظامٍ تفنن في تشتيت الشعب وتقسيمه، وراهن عليه، ولا يزال، لإجهاض ثورة السوريين، وإجبارهم على الخضوع والإذعان، أو الرحيل عن وطنهم ومنازلهم.
الحكمة الرئيسية من الاقتتال بين "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" والاقتتالات القادمة بين الفصائل الإسلامية هي أن السياسة وإدارة الدولة والدفاع عنها ليست من مسائل الدين، وأن الإيمان لا يضمن للمؤمن معرفة المصالح الوطنية العليا، وأن الدين لا يغني عن السياسة، وأن الدفاع عن الأوطان يحتاج إلى معارف وخبراتٍ ليست متضمنةً في ورع التقي، أو فقه العالم، أو حكمة الشيخ الجليل. ولا يمكن أن يخدم الدولة، ومن باب أولى أن يقوم بتأسيسها وحمايتها، من تتحكّم به وتحكمه ثقافة أمراء الحرب ودفاعاتهم، بأي ذريعةٍ كانت، وما يرتبط بها حتماً من تشتيت الموارد وتعزيز السلطات والقيادات المتوازية والمتناحرة، وتقويض أسس الوطنية والهوية السياسية. وفي النهاية، القضاء على فكرة الشعب نفسها، لصالح الحشود من الأتباع الذين يعيشون في رعاية الأمير، وبفضله وإحسانه.
في بلدة دير العصافير الاستراتيجية التي أعاد النظام احتلالها، سقطت نظرية إمارات الحرب الإسلامية التي وقفت حاجزاً أمام استعادة الدولة التي دمرتها الفاشية والديكتاتورية الأسدية، كما أصبحت عقبةً في وجه انتصار مطالب الشعب، وتقدم مسيرته على طريق القضاء على نظام الهمجية والانتقال السياسي نحو نظام جديد يحقق تطلعات السوريين، ويضمن حقوقهم وحرياتهم، ويعبد الطريق نحو السلام والأمن والاستقرار، في بلد عانى من خيانة نخبه وجحودها، بمثل ما عانى من غدر المجتمع الدولي، وتخليه عن مسؤولياته وتمزيقه مواثيقه، وتضحيته بقيم التضامن الإنسانية معاً.
لا يزال من غير المؤكد أن تنجح النداءات التي أطلقتها شخصيات دينية وقطاعات واسعة من الرأي العام المعارض، ومنها مبادرات المجلس الإسلامي السوري والعديد من العلماء وشيوخ المسلمين، في إطفاء نار الاحتراب بين "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" اللذين ينتميان كلاهما إلى فصائل إسلامية، من المفروض أنها تقدّم مثالاً للتجرّد عن الهوى ونكران الذات والقتال من أجل أهدافٍ وغاياتٍ دينيةٍ ووطنية. والسبب في فشل هذه الجهود الدينية وانهيار التسويات، واحدتها بعد الأخرى، ليس وجود خلافات عقائدية أو سياسية من أي نوع. كما أنه ليس للاقتتال الذي أودى بحياة أكثر من 700 ضحية في الأيام القليلة الماضية، أي علاقة بالدين، وإنما هو جزء من الصراع على السلطة والنفوذ والموارد التي تميّز سلوك واستراتيجيات إمارات الحرب التي لا يمكن أن تتعايش في ما بينها، وتسعى كل منها إلى بناء سلطتها السيادية الخاصة على الرقعة التي تحتلها من الأرض، بصرف النظر عن الأهداف والغايات والمصالح الوطنية الكلية. وعندما يتفاقم عليها الضغط، لا تجد لديها مخرجاً للدفاع عن بقائها، أو تعظيم مواردها ومكاسبها وتقوية شوكتها، سوى بالاعتداء على جيرانها، وبأكل والتهام الإمارات الأخرى الأضعف منها، واستملاك مواردها المادية والبشرية واحتلال مواقعها.
وكانت النتيجة الطبيعية لهذه المواجهات، وانشغال الفصائل بقتال بعضها بعضاً، حتى الآن، خسارة القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية بأكمله، وسقوطه في يد النظام، وتهديد مواقع أخرى، وكشفها أمام هجمات النظام الجديدة. ومهما نجح الوسطاء في دفع الطرفين إلى توقيع اتفاقاتٍ وتعهداتٍ وتسوياتٍ لن تصمد طويلاً، لا أعتقد أن هناك أملا كبيرا في تجنب مواجهات جديدة، طالما بقي منطق إمارات الحرب سائداً عند الفصائل، ولم ينجح القادة العسكريون والسياسيون في التوصل إلى اتفاق لدمج القوات، أو على الأقل لتشكيل قيادةٍ واحدةٍ، تشرف على عمل الفصائل، وتنسق في ما بينها، وتنظم قتالها على أساس خطة وأهداف وطنية واضحة ومتكاملة.
وفي جميع الأحوال، لم يكن هناك، ولا يوجد، سبب واحد يمكن أن يبرّر استماتة الفصائل في الدفاع عن استقلالها، ورفض الاندراج تحت قيادةٍ واحدةٍ، سوى هذا المنطق وحده الذي يشترط وجودها، أعني منطق إمارات الحرب الذي يشير إلى بنيةٍ يكون فيها القائد هو أمير الجماعة، ويكون المقاتلون أتباعاً له وموالين، يأتمرون بأوامره، ويخضعون لإرادته ويخدمون أهدافه، وليس لمؤسسةٍ وطنيةٍ مستقلةٍ عن الأفراد، وخاضعةٍ لأعرافٍ وأصولٍ وقوانين وقواعد معروفةٍ وثابتةٍ وواحدةٍ بالنسبة للجميع، كما الحال في الجيوش وحركات التحرير الوطنية. ولا تستطيع أي عقيدة، دينيةٍ أو دنيويةٍ، أن تلغي متطلبات هذا المنطق وديناميكياته التي تتحكّم بأمراء الحرب، المتدينين منهم وغير المتدينين، وفي كل الأزمان والبلدان. فهو يتعلق بمسألةٍ مصيرية، هي أن يبقى الفصيل أو يزول. وقد كان خطأ المعارضة، منذ البداية، أنها قبلت التعايش مع مئات الفصائل المستقلة والمتكرّرة والمتوازية والمتناحرة، وأذعنت لرفض قادتها الاندماج في هيئةٍ أو جيشٍ وطنيٍّ واحد للتحرير، يخضع لقيادةٍ واحدةٍ واستراتيجيةٍ سياسيةٍ وطنيةٍ واعية، بعد إخفاق محاولة المجلس الوطني، منذ الأشهر الأولى لولادته، في تحقيق مشروع إعادة هيكلة الفصائل، بالتعاون مع العسكريين المنشقين، وتكوين جيش وطني جديد، بسبب التناحر الداخلي بين شخصيات المعارضة، ومقاومة قادة الفصائل المسلحة، وبشكل أكبر، تشجيع الدول الداعمة التي كانت تراهن على تعزيز ولاء الزعامات المتعدّدة لها، وتثبيتها في مواقعها لضمان نفوذها ودورها في الحرب، كما في تقرير مستقبل البلاد في ما بعد.
بالتأكيد، لا تنفي سيطرة منطق أمراء الحرب، الفاعل على المدى الطويل، وجود الأسباب المباشرة والاحتكاكات التي فجرت الصراع الكامن، ودفعت الفصيلين إلى تقديم الحرب بينهما على الحرب مع النظام. لكن، ما حصل في الغوطة الشرقية، وتسبب في تمكين النظام من احتلال عشرات المواقع والقرى الاستراتيجية، يمكن أن يحصل في كل مكان وبين جميع الفصائل الموجودة اليوم، وبشكل خاص الفصائل الإسلامية، بمقدار ما وظف أمراء هذه الفصائل الدين لشرعنة الانقسام، وتعدد الإمارات والقيادات، وقطع الطريق على ولادة قيادةٍ وطنيةٍ واحدة، تقود العملية العسكرية والسياسية ضد نظامٍ تفنن في تشتيت الشعب وتقسيمه، وراهن عليه، ولا يزال، لإجهاض ثورة السوريين، وإجبارهم على الخضوع والإذعان، أو الرحيل عن وطنهم ومنازلهم.
الحكمة الرئيسية من الاقتتال بين "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" والاقتتالات القادمة بين الفصائل الإسلامية هي أن السياسة وإدارة الدولة والدفاع عنها ليست من مسائل الدين، وأن الإيمان لا يضمن للمؤمن معرفة المصالح الوطنية العليا، وأن الدين لا يغني عن السياسة، وأن الدفاع عن الأوطان يحتاج إلى معارف وخبراتٍ ليست متضمنةً في ورع التقي، أو فقه العالم، أو حكمة الشيخ الجليل. ولا يمكن أن يخدم الدولة، ومن باب أولى أن يقوم بتأسيسها وحمايتها، من تتحكّم به وتحكمه ثقافة أمراء الحرب ودفاعاتهم، بأي ذريعةٍ كانت، وما يرتبط بها حتماً من تشتيت الموارد وتعزيز السلطات والقيادات المتوازية والمتناحرة، وتقويض أسس الوطنية والهوية السياسية. وفي النهاية، القضاء على فكرة الشعب نفسها، لصالح الحشود من الأتباع الذين يعيشون في رعاية الأمير، وبفضله وإحسانه.
في بلدة دير العصافير الاستراتيجية التي أعاد النظام احتلالها، سقطت نظرية إمارات الحرب الإسلامية التي وقفت حاجزاً أمام استعادة الدولة التي دمرتها الفاشية والديكتاتورية الأسدية، كما أصبحت عقبةً في وجه انتصار مطالب الشعب، وتقدم مسيرته على طريق القضاء على نظام الهمجية والانتقال السياسي نحو نظام جديد يحقق تطلعات السوريين، ويضمن حقوقهم وحرياتهم، ويعبد الطريق نحو السلام والأمن والاستقرار، في بلد عانى من خيانة نخبه وجحودها، بمثل ما عانى من غدر المجتمع الدولي، وتخليه عن مسؤولياته وتمزيقه مواثيقه، وتضحيته بقيم التضامن الإنسانية معاً.