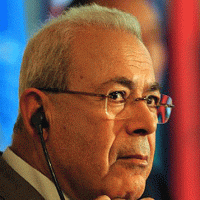11 نوفمبر 2024
هل انتهت الثورة السورية؟
الجولة السادسة من محادثات أستانة بشأن سورية (16/9/2017/فرانس برس)
تثير التحولات الجارية منذ أشهر في الساحة السورية، وفي مقدمها تعميم اتفاقات تخفيض التصعيد، التي تشكل تمهيدا لوقفٍ محتملٍ شامل لإطلاق النار، ردود أفعال مختلفة من الرأي العام السوري. فبقدر ما تغذّي أمل جمهور واسع من السوريين، وربما أغلبهم، بصرف النظر عن الموقف من الثورة والنظام، بالعودة إلى السلام واسترجاع أنفاسهم، بعد سنوات طويلة من القتل والدمار والتشرّد والعذاب. وتبعث بالتالي الأمل بنهايةٍ قريبة للحرب، فإنها تدبّ الخوف والقلق في نفوس جمهور واسع أيضا من السوريين الذين خاضوا الثورة، وأيدوها وتماهوا مع شعاراتها ومطالبها، وضحّوا من أجلها، ووضعوا كل رهاناتهم ومستقبل أبنائهم على انتصارها. وكما أننا لا يمكن أن ننفي شرعية المطالب وراء هذا الاحتفاء بوقف القتال، أو تخفيض مستوى العنف الذي شهدته السنوات الماضية، كذلك من الصعب أن نتجاهل مشروعية الخوف من الخسارة والإحباط اللذيْن يثيرهما احتمال ضياع رهانات الثورة، وخطر العودة تحت سلطة نظام الاستئثار والقتل والانتقام. وهذا ما أكده منذ أيام خطاب التجانس الذي ألقاه "السيد الرئيس"، تأكيدا للنصر الذي لا تكفّ وسائل إعلامه عن قرع طبوله، لبث الرعب في قلوب السوريين، وإعادتهم إلى ثقافة الخضوع والانصياع. وهو الدرس الذي أوكل لأحد قادة مليشيات "السيد الرئيس" إيصاله إلى السوريين جميعا، المقيم والمهجّر، عندما هدّدهم علنا بالموت، ونصحهم بأن يتجنّبوا العودة إلى بلادهم، وأن يبقوا حيث رحلوا.
اختيار مستحيل
ومنذ الآن، بدأ بعض السوريين يتذوقون طعم العيش من دون براميل، وتراجع معدل القتل اليومي، واستعادة ما يمكن من إنسانيتهم المهدورة، بصرف النظر عن أي حسابٍ آخر، بينما تزداد مخاوف المنفيين والمهجرين والمشردين من احتمال ضياع حلم العودة إلى الأبد، والبقاء في مخيمات اللجوء تحت رحمة العنصرية المتنامية في أكثر من موقع ومكان.
والواقع أن هذا التعارض بين الأمل في توقف سريع للحرب والخوف من أن يقود ذلك إلى خسارة رهانات الثورة الكبيرة والتفريط بتضحيات السوريين الهائلة، لم يكفّ عن الضغط على ضمير السوريين منذ سبع سنوات. فمنذ بداية الأحداث، وضع إنكار النظام مطالب الشعب، وتصميمه على الحسم العسكري، ورفضه أي حل سياسي، الصراع بين الثورة والنظام في طريق مسدود. ولم يترك أمام الشعب الثائر من خيارٍ سوى الاستسلام المهين أو الاستمرار في حرب إبادة شاملة. وكان قرار جمهور الثائرين الزجّ بنفسه وأبنائه بكليته في مواجهةٍ مصيرية لم تلبث حتى تحولت إلى ما يشبه القيامة الأخيرة.
لم تكن حسابات السوريين خاطئة بالكامل، فقد كانوا على قاب قوسين أو أدنى من إسقاط النظام بقوة إرادتهم الحديدية وتصميمهم، وتقديم أرواح أبنائهم، من دون حساب، على مذبح معركة الكرامة والحرية. وكاد النظام يسقط تحت أقدام فصائل المقاومة الشعبية خلال أشهر، على الرغم من استخدامه جميع أسلحة الدمار الشامل، المحرّمة حتى في الحروب الدولية. لكن تضارب الحسابات الإقليمية والمصالح الدولية عمل لصالح الأسد الذي تلقى دعما لامحدودا من حلفاء كبار، أرادوا أن يستفيدوا من الأحداث السورية، من أجل تحقيق مصالح استراتيجية، او تسجيل نقاط على الغرب الذي فرض الحصار عليهم، أو تجاهلهم في العقود الماضية، بينما وجدت فصائل الثورة المسلحة نفسها ضحية وعود فضفاضة، ودعم محدود اقتصر على السلاح، ولم يكن مجديا في مساعدة السوريين على تنظيم أنفسهم، إن لم يساهم في تقسيم صفوفهم وزيادة فرص انقسامهم. وقد أضيف إلى ذلك دفع دول وأطراف قوى التطرّف والإرهاب العالمي إلى العمل في الساحة السورية، في البداية كقوات تعمل لصالح النظام من خلف خطوط الخصم، وفي ما بعد لصالح مشاريعها الخاصة الجنونية. وبسبب ما توفر لها من دعمٍ لا يقارن بالمال والسلاح، وما قدم لها من مساعدة لاحتلال مناطق الثوار، سوف تتحول منظمات التطرّف والارهاب، بسرعة خارقة، إلى بعبع حقيقي في مواجهة فصائل المقاومة الثورية، الضعيفة التسليح والتدريب والتنظيم. ومع ذلك، ما كان من الممكن للمواجهة العسكرية مع المقاومة أن تحسم، لولا التدخل الحاسم لدولة عظمى عسكريا، أعني روسيا التي قلبت الموازين العسكرية والسياسية، ونجحت في الحصول على ما يشبه الانتداب الدولي لقيادة المرحلة الصعبة لوقف الحرب، والانتقال نحو سورية جديدة ما بعد الأسد ونظام القتل المنظم، سواء بقي الأسد فترة كما يشيع بعضهم أو أخرج نهائيا وقدّم إلى المحاكم الدولية بوصفه مجرم حرب، كما تقضي المواثيق الأممية، وتطالب منظمات حقوق الإنسان العالمية.
في هذا المنعطف الصعب الذي يطرح فيه من جديد السؤال الذي طرح منذ الأشهر الأولى للثورة، وأدى إلى تبني خيار المقاومة بالسلاح، وما سميت عسكرة الثورة السورية، تجد قيادات المعارضة المسلحة والسياسية نفسها أمام خيارين لا بديل لهما: التسليم بالأمر الواقع والاعتراف بالهزيمة، والقبول بالتسوية من تحت، وهذا ما يردّده أعداء الثورة وينتظره النظام، كما ذكّر به بشكل موارب المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في حديثه عن خسارة المعارضة الحرب. أو تجاهل الواقع وإنكار خسارة معركة السلاح، والاستمرار في القتال من دون أمل، والثبات على خطابٍ مكرور أصبح يبدو أكثر فأكثر فارغا من المعنى، ولا يفيد إلا في زيادة شعور الجمهور السوري نفسه بغياب القيادة العقلانية والحكمة السياسية.
وعلى هذه الأرضية، بدأت تبرز أيضا، إلى جانب الانقسامات التي لا تحصى داخل المعارضة، انقسامات جديدة بين من يدافع عن اتفاقيات خفض التصعيد التي أصبحت الفصائل العسكرية تتسابق على توقيعها مع الروس وغيرهم، ويعتبرها بداية الطريق إلى التسوية السياسية، ومن لا يزال يشكّك في نيات الروس والدول الضامنة عموما. ويخشى أن يكون في التوقيع على هذه الاتفاقات نهاية الثورة السورية. وأكثر فأكثر يواجه مجتمع الثورة تحديا كبيرا للحفاظ على
وحدته، ويدخل في منطقة عواصف، سوف تفاقم من اضطراب صفوفه، وربما تقود إلى شلّ المعارضة سياسيا، وتقديم أكبر هدية لموسكو لتطبق مخططها في الخروج بتسويةٍ تضمن استمرار النظام وتطعيمه ببعض عناصر المعارضة الزائفة التي لا مانع لديها من التضحية بحقوق السوريين وتضحياتهم اللامحدودة، من أجل المشاركة بسلطةٍ لقيطةٍ تعرف سلفا أنها ستكون مثالا للفشل والفوضى والانهيار.
هكذا، بدل أن يعزّز الأمل الجامع، يدفع تطبيق خطط إنهاء القتال إلى مزيدٍ من الشك والخوف وعدم الثقة بين الأطراف وبالمستقبل، ويفاقم من الطابع التراجيدي الأصلي للصراع. والسبب غياب أي أفق واضح للخروج بتسوية سياسية تحول دون عودة سياسات القتل والتنكيل والانتقام. وفي مواجهة هذا الواقع، تجد قيادات المعارضة السورية نفسها أمام سؤالٍ كبير، يتردّد صداه في جميع الأوساط السورية، بما فيها القسم الأكبر ممن كانوا، ولا يزالون، يعيشون تحت سيطرة النظام: كيف يمكن صون حق السوريين المشروع والطبيعي في حقن الدماء، والعودة إلى السلام، مع الحفاظ على رهانات الثورة، وعدم التفريط بالكرامة والحرية التي ينتظر تحقيقها أي إنسان، وعدم السقوط ثانية تحت حكم الجلاد وجنونه؟
نهاية الحرب
لا يمكن للمعارضة بالتأكيد أن تتجاهل ميزان القوى العسكري الذي صنعه الروس، ومن يقف وراءهم من الدول. ولا يساعد تجاهله على التوصل إلى أي حل. وعليها أن تعترف بخسارتها المواجهة العسكرية، وبأنه لا يوجد الآن في الأفق المنظور ما يمكن أن يسمح بتغيير التوازنات الراهنة. وينبغي أن تكون غايتها الواضحة من ذلك الحفاظ على ما تبقى من قوى مقاتلة ثورية للمرحلة المقبلة التي ستكون على الأغلب سياسية، وتخفيف العبء الكبير والمعاناة عن الشعب السوري المحاصر والمجوّع والمشرد بأكمله، بما في ذلك من لا يزال يعيش منهم داخل مدنه وأحيائه وقراه المنسية والمدمرة. ومفاوضات أستانة هي الفرصة الوحيدة المتاحة لتحقيق هذا الهدف، بعد استنكاف من سمّوا أصدقاء الشعب السوري أو أغلبهم، أو انسحابهم الجزئي أو الكلي من دعم المعارضة، وقبل ذلك فشل المعارضة العسكرية والسياسية في التوصل إلى حد أدنى من القيادة الموحدة والتنسيق خلال السنوات الطويلة الماضية. فنحن لا نحصد نتائج تضحياتنا فحسب، ولكن أيضا، وبشكل أكبر، نتائج أخطائنا ونقائص أعمالنا وتقاعسنا عن تأدية واجباتنا.
لكن وقف الحرب لا يعني تحقيق السلام. كما لا تعني سيطرة قوات النظام التي تكاد تكون، في أغلبها، مليشيات أجنبية، تجاوز تحدّي الثورة أو إنهاءها، فقد كان النظام مسيطرا على كامل الجغرافيا السورية، عندما انطلقت الثورة. لن تنتهي الثورة إلا بتحقيق أهدافها، بصرف النظر عن الوسائل والاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن تتبناها في هذا الظرف أو ذاك. وتحقيق أهدافها يعني الانتقال الفعلي، مباشرة أو تدريجا، وهذا هو موضوع المفاوضات نحو نظامٍ جديد يضمن حقوق جميع السوريين بالتساوي، ويرفض بأي شكل إعادة تكريس الدكتاتورية والاستبداد في أي صورة كانا.
والحال إن إنهاء الحرب كان الهدف الرئيسي للمعارضة وللمجتمع الدولي منذ البداية. وقد وافقت المعارضة التي تحدثت باسم الثورة، من دون أن تحل محلها، على جميع المبادرات
الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، بينما أصر النظام على الاستمرار فيها لوأد الثورة وتمزيق الشعب الذي يحتضنها. ومن خلالها، استطاعت القوى الحليفة للنظام التسلل لانتزاع مواقع لها في سورية، فتحوّلت الحرب الأسدية إلى حروبٍ إقليمية ودولية، وأصبحت أكثر فأكثر الفخ الرئيسي الذي نُصب للإيقاع بالثورة وبالشعب السوري معا، لحرمانه من حقوقه الطبيعية.
غطّى على هذه الحقيقة تبنّي الصحافة والإعلام، ثم الدبلوماسية الدولية، فكرة الحرب الأهلية، بدل الثورة أو الانتفاضة أو حركة الاحتجاج. وتعني هذه الحرب تنازع طرفين أهليين على تأكيد حقوقهما الشرعية أو المتساوية في الشرعية. والحال أن الثورة على الظلم والقهر والفساد حق طبيعي ومشروع للشعوب التي تعتبر، في العرف الحديث، مصدر السيادة والشرعية للدولة والسلطة القائمة والحكومة. أما مواجهتها بالعنف والمذابح الجماعية وزرع الفتنة والخراب في البلاد، فهو من الأعمال العدوانية غير الشرعية وغير المشروعة بأي عرف. لذلك، عمل النظام على تشويه هوية الثورة وإنكار وجودها، وأصرّ، مع حلفائه، على الحديث عن مواجهة مع المنظمات الإرهابية التي لم تكن أصلا موجودة ولم توجد قبل عام 2013. وقد نجحت الدبلوماسية الدولية، وفي مقدمها دبلوماسية موسكو وطهران، وأذرعهما الإعلامية، في تكريس فكرة الحرب الأهلية، الأول لتبرير نأيهم بأنفسهم والتخلي عن التزاماتهم، والثاني حتى يبرّروا تدخلهم في سورية، بعد تعطيلهم جميع قرارات مجلس الأمن، فجعلوا من النظام المعتدي الضحية، ومن الشعب المهدورة حياة أبنائه الجلاد والمسؤول عن العنف والدمار والخراب.
إذا كانت الثورة شعبية من دون أي شك، فقد كانت الحرب الرد المباشر للنظام، ثم لحلفائه، عليها ونقيضها في الوقت نفسه. وقد أصبحت حربا ثلاثية الأبعاد، فهي أولا حرب النظام بغرض إخضاع السوريين، والاستمرار في استعبادهم وامتهان كرامتهم واستغلالهم. وهي ثانيا، حرب إقليمية ودولية أرادت منها بعض الدول، إيران وروسيا بشكل خاص، أن تستثمر هزيمة النظام وحاجته للدعم من أجل تحقيق مكاسب استراتيجية، وتصفية حساباتها مع دول الخليج وفرض هيمنتها الإقليمية. وهي ثالثا مواجهة دولية، حاولت فيها روسيا ونجحت في تقليم أظافر الغرب الذي امتهن كرامتها بالاستخفاف بها، وفرض العقوبات المستمرة عليها، واستبعادها من القسمة القذرة ل"غنائم" حربي العراق وليبيا، وكاد يخرجها من المنطقة بخفي حنين. وإذا ظهر أن هناك فرصة اليوم لوقف هذه الحروب، فلأن الأطراف الإقليمية والدولية توشك أن تتوصل إلى بداية تفاهماتٍ حول توزيع المغانم التي تعتقد أنها تستطيع أن تحصدها الآن على أشلاء الشعب السوري، وبعد خسارة الفصائل المسلحة أو استسلامها.
إنهاء الثورة بتحقيق غاياتها
لا يضير الثورة أن تنتهي الحرب. بالعكس، يحرّرها ذلك من العبء الثقيل لهذه الحرب وفسادها. ولا يضع إنهاء الأعمال القتالية حدا لتطلعات الشعب السوري ومطالبه التي أعلن عنها من خلال انتفاضته العظيمة. إنه يعني، ببساطة، بداية العمل على مواجهة الاستحقاقات التي أراد النظام وحلفاؤه تغييبها أو تجاهلها بتسعيرهم أوار الحرب. وإذا كان وقف الحرب يشكل مصلحةً للدول الإقليمية، ولموسكو، وللغرب الخائف من عواقب استمرارها، على نمو الإرهاب أو تزايد تدفق اللاجئين وتعميم الفوضى، وزعزعة الاستقرار في بلدانٍ مجاورة، له فيها مصالح استراتيجية، فهو لا يقدّم شيئا للشعب السوري الذي تحمل وحده كامل عبئها الإنساني والسياسي.
لذلك أعتقد أن من الضروري والواجب الفصل بين المسألتين: إنهاء الحرب، وهي مسألة طارئة على الأزمة التي فجرت الثورة، وإنهاء الأزمة التي فجرتها الثورة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بإزالة الأسباب التي قادت إليها، والتي تتمثل في تغوّل نظام الحكم الفاسد الذي فرض على سورية والسوريين بقوة السلاح والعنف خلال نصف قرن. وكما أن الحرب لم تنته إلا بتحقيق الأهداف التي سعى أصحابها أو مطلقوها إليها، باستثناء النظام الذي خسر كل أوراقه فيها، لصالح من أصبحوا حماته وأولياء أمره، كذلك لن تنتهي الثورة الشعبية، وينبغي أن تنتهي يوما ما، إلا بتحقيق أهدافها. وإلا سوف تستمر بوسائلها الطبيعية التي أطلقتها قبل أن تُحاصر بالحرب، طالما لا يزال هناك سوريون يرفضون العودة إلى العبودية، ويرفضون قيام السلام من جديد على جماجم إخوانهم وجثث مواطنيهم، ويتمسّكون بما أصبح عنوان وجودهم، أعني مبادئ الكرامة والحرية.
هذا الكلام موجه أولا للمفاوضين السوريين الذين يمثلون المعارضة، وللفصائل المقاتلة التي وقّعت، أو سوف توقع، اتقاقات خفض التصعيد، لتأكيد أنهم لا ينبغي أن ينظروا إلى وقف الحرب سلفة مقدمة لهم، لقاء تنازلاتٍ لا مشروعة، يمكن أن تطلب منهم في المفاوضات السياسية المقبلة. بالعكس، ينبغي أن يعتبر القبول باتفاقات أستانة مساهمة من الفصائل المسلحة في بناء الثقة مع الدول الراعية، ولدعم الجهود الدولية المبذولة لوضع حد لكارثةٍ لم تعد عواقبها تؤثر على السوريين وحدهم. وهو موقف لا يمكن أن يوسم بالضعف، بعد المقاومة
الأسطورية التي أظهروها خلال السنوات الطويلة والصعبة الماضية، وبعد أن نالوا من نظام الاستبداد مقتلا، فتفكّكت دولته، وانهارت مؤسساته، واضطر إلى القبول بوضع نفسه تحت الوصاية والحمايتين، الإيرانية والروسية، وتسليمه لهما بالسيادة على أراضيه. وهو منذ الآن جثة هامدة سياسيا، لا تستمر في الحياة إلا في غرفة العناية الروسية والإيرانية المشدّدة، بينما لا يرى فيه العالم سوى مستحاثة خارجة من ماضي الإنسانية السحيق والبائد.
والكلام موجه أيضا إلى الوسيط الروسي والمجتمع الدولي الذي دان نفسه عندما لاذ بالصمت وخرس الضمير، وللمبعوث الأممي معا، لتأكيد أنه سيكون من الخطأ الفاحش أن يستخدم توقيع المعارضة على اتفاقات خفض التصعيد، وهي عربون سلام قدّمته فصائل المعارضة المسلحة، ذريعة للالتفاف على المطالب الشرعية للشعب، ومتابعة الحرب على السوريين بوسائل أخرى.
تنتهي الحرب عندما يقرّر من شنّها وضع حدٍّ لها، وكذلك الثورة، فهي لن تنتهي إلا عندما يقرّر أصحابها إنهاءها، ومن الصعب أن يقرّر السوريون، بعد نصف قرن من المعاناة والخبرة مع الاستبداد الهمجي، وسبع سنوات من الصراع الدموي المرير، وملايين الضحايا والمشرّدين، بالإضافة إلى الخراب العميم، التخلي عن أهدافهم ودفن تطلعاتهم نحو الكرامة والحرية، والإذعان لحكم الوحشية والطغيان.
ولا ينبغي لأحد أن يشكّ في أن الوضع سيكون كارثيا، إذا أراد المسؤولون الروس، المنتدبون عمليا من المجتمع الدولي، لترتيب المفاوضات العسكرية والسياسية، أن يختبروا إرادة السوريين التحرّرية، وقرّروا الإصرار على فصل التهدئة العسكرية عن مشروع الانتقال السياسي نحو نظام ديمقراطي، ينهي حكم الأسد الدموي، كما توحي به للأسف تصريحات وتصرفات كثيرة لهم اليوم. إن وضع السوريين من جديد أمام الاختيار المستحيل بين الموت بكرامة أو البقاء مع الذل سيدفعهم إلى وضع أخلاقي وسياسي غير محتمل، مليء بالمخاطر والتهديدات للجميع. سيكون هذا، لو حصل، أسوأ دورٍ يمكن لروسيا أن تلعبه، بعد خروجها من القبر الدولي الذي أجبرت على الحياة فيه قبل أن تقدّم لها هزيمة الأسد على يد قوات المعارضة السورية الفرصة الذهبية لقيامها وخلاصها.
اختيار مستحيل
ومنذ الآن، بدأ بعض السوريين يتذوقون طعم العيش من دون براميل، وتراجع معدل القتل اليومي، واستعادة ما يمكن من إنسانيتهم المهدورة، بصرف النظر عن أي حسابٍ آخر، بينما تزداد مخاوف المنفيين والمهجرين والمشردين من احتمال ضياع حلم العودة إلى الأبد، والبقاء في مخيمات اللجوء تحت رحمة العنصرية المتنامية في أكثر من موقع ومكان.
والواقع أن هذا التعارض بين الأمل في توقف سريع للحرب والخوف من أن يقود ذلك إلى خسارة رهانات الثورة الكبيرة والتفريط بتضحيات السوريين الهائلة، لم يكفّ عن الضغط على ضمير السوريين منذ سبع سنوات. فمنذ بداية الأحداث، وضع إنكار النظام مطالب الشعب، وتصميمه على الحسم العسكري، ورفضه أي حل سياسي، الصراع بين الثورة والنظام في طريق مسدود. ولم يترك أمام الشعب الثائر من خيارٍ سوى الاستسلام المهين أو الاستمرار في حرب إبادة شاملة. وكان قرار جمهور الثائرين الزجّ بنفسه وأبنائه بكليته في مواجهةٍ مصيرية لم تلبث حتى تحولت إلى ما يشبه القيامة الأخيرة.
لم تكن حسابات السوريين خاطئة بالكامل، فقد كانوا على قاب قوسين أو أدنى من إسقاط النظام بقوة إرادتهم الحديدية وتصميمهم، وتقديم أرواح أبنائهم، من دون حساب، على مذبح معركة الكرامة والحرية. وكاد النظام يسقط تحت أقدام فصائل المقاومة الشعبية خلال أشهر، على الرغم من استخدامه جميع أسلحة الدمار الشامل، المحرّمة حتى في الحروب الدولية. لكن تضارب الحسابات الإقليمية والمصالح الدولية عمل لصالح الأسد الذي تلقى دعما لامحدودا من حلفاء كبار، أرادوا أن يستفيدوا من الأحداث السورية، من أجل تحقيق مصالح استراتيجية، او تسجيل نقاط على الغرب الذي فرض الحصار عليهم، أو تجاهلهم في العقود الماضية، بينما وجدت فصائل الثورة المسلحة نفسها ضحية وعود فضفاضة، ودعم محدود اقتصر على السلاح، ولم يكن مجديا في مساعدة السوريين على تنظيم أنفسهم، إن لم يساهم في تقسيم صفوفهم وزيادة فرص انقسامهم. وقد أضيف إلى ذلك دفع دول وأطراف قوى التطرّف والإرهاب العالمي إلى العمل في الساحة السورية، في البداية كقوات تعمل لصالح النظام من خلف خطوط الخصم، وفي ما بعد لصالح مشاريعها الخاصة الجنونية. وبسبب ما توفر لها من دعمٍ لا يقارن بالمال والسلاح، وما قدم لها من مساعدة لاحتلال مناطق الثوار، سوف تتحول منظمات التطرّف والارهاب، بسرعة خارقة، إلى بعبع حقيقي في مواجهة فصائل المقاومة الثورية، الضعيفة التسليح والتدريب والتنظيم. ومع ذلك، ما كان من الممكن للمواجهة العسكرية مع المقاومة أن تحسم، لولا التدخل الحاسم لدولة عظمى عسكريا، أعني روسيا التي قلبت الموازين العسكرية والسياسية، ونجحت في الحصول على ما يشبه الانتداب الدولي لقيادة المرحلة الصعبة لوقف الحرب، والانتقال نحو سورية جديدة ما بعد الأسد ونظام القتل المنظم، سواء بقي الأسد فترة كما يشيع بعضهم أو أخرج نهائيا وقدّم إلى المحاكم الدولية بوصفه مجرم حرب، كما تقضي المواثيق الأممية، وتطالب منظمات حقوق الإنسان العالمية.
في هذا المنعطف الصعب الذي يطرح فيه من جديد السؤال الذي طرح منذ الأشهر الأولى للثورة، وأدى إلى تبني خيار المقاومة بالسلاح، وما سميت عسكرة الثورة السورية، تجد قيادات المعارضة المسلحة والسياسية نفسها أمام خيارين لا بديل لهما: التسليم بالأمر الواقع والاعتراف بالهزيمة، والقبول بالتسوية من تحت، وهذا ما يردّده أعداء الثورة وينتظره النظام، كما ذكّر به بشكل موارب المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في حديثه عن خسارة المعارضة الحرب. أو تجاهل الواقع وإنكار خسارة معركة السلاح، والاستمرار في القتال من دون أمل، والثبات على خطابٍ مكرور أصبح يبدو أكثر فأكثر فارغا من المعنى، ولا يفيد إلا في زيادة شعور الجمهور السوري نفسه بغياب القيادة العقلانية والحكمة السياسية.
وعلى هذه الأرضية، بدأت تبرز أيضا، إلى جانب الانقسامات التي لا تحصى داخل المعارضة، انقسامات جديدة بين من يدافع عن اتفاقيات خفض التصعيد التي أصبحت الفصائل العسكرية تتسابق على توقيعها مع الروس وغيرهم، ويعتبرها بداية الطريق إلى التسوية السياسية، ومن لا يزال يشكّك في نيات الروس والدول الضامنة عموما. ويخشى أن يكون في التوقيع على هذه الاتفاقات نهاية الثورة السورية. وأكثر فأكثر يواجه مجتمع الثورة تحديا كبيرا للحفاظ على
هكذا، بدل أن يعزّز الأمل الجامع، يدفع تطبيق خطط إنهاء القتال إلى مزيدٍ من الشك والخوف وعدم الثقة بين الأطراف وبالمستقبل، ويفاقم من الطابع التراجيدي الأصلي للصراع. والسبب غياب أي أفق واضح للخروج بتسوية سياسية تحول دون عودة سياسات القتل والتنكيل والانتقام. وفي مواجهة هذا الواقع، تجد قيادات المعارضة السورية نفسها أمام سؤالٍ كبير، يتردّد صداه في جميع الأوساط السورية، بما فيها القسم الأكبر ممن كانوا، ولا يزالون، يعيشون تحت سيطرة النظام: كيف يمكن صون حق السوريين المشروع والطبيعي في حقن الدماء، والعودة إلى السلام، مع الحفاظ على رهانات الثورة، وعدم التفريط بالكرامة والحرية التي ينتظر تحقيقها أي إنسان، وعدم السقوط ثانية تحت حكم الجلاد وجنونه؟
نهاية الحرب
لا يمكن للمعارضة بالتأكيد أن تتجاهل ميزان القوى العسكري الذي صنعه الروس، ومن يقف وراءهم من الدول. ولا يساعد تجاهله على التوصل إلى أي حل. وعليها أن تعترف بخسارتها المواجهة العسكرية، وبأنه لا يوجد الآن في الأفق المنظور ما يمكن أن يسمح بتغيير التوازنات الراهنة. وينبغي أن تكون غايتها الواضحة من ذلك الحفاظ على ما تبقى من قوى مقاتلة ثورية للمرحلة المقبلة التي ستكون على الأغلب سياسية، وتخفيف العبء الكبير والمعاناة عن الشعب السوري المحاصر والمجوّع والمشرد بأكمله، بما في ذلك من لا يزال يعيش منهم داخل مدنه وأحيائه وقراه المنسية والمدمرة. ومفاوضات أستانة هي الفرصة الوحيدة المتاحة لتحقيق هذا الهدف، بعد استنكاف من سمّوا أصدقاء الشعب السوري أو أغلبهم، أو انسحابهم الجزئي أو الكلي من دعم المعارضة، وقبل ذلك فشل المعارضة العسكرية والسياسية في التوصل إلى حد أدنى من القيادة الموحدة والتنسيق خلال السنوات الطويلة الماضية. فنحن لا نحصد نتائج تضحياتنا فحسب، ولكن أيضا، وبشكل أكبر، نتائج أخطائنا ونقائص أعمالنا وتقاعسنا عن تأدية واجباتنا.
لكن وقف الحرب لا يعني تحقيق السلام. كما لا تعني سيطرة قوات النظام التي تكاد تكون، في أغلبها، مليشيات أجنبية، تجاوز تحدّي الثورة أو إنهاءها، فقد كان النظام مسيطرا على كامل الجغرافيا السورية، عندما انطلقت الثورة. لن تنتهي الثورة إلا بتحقيق أهدافها، بصرف النظر عن الوسائل والاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن تتبناها في هذا الظرف أو ذاك. وتحقيق أهدافها يعني الانتقال الفعلي، مباشرة أو تدريجا، وهذا هو موضوع المفاوضات نحو نظامٍ جديد يضمن حقوق جميع السوريين بالتساوي، ويرفض بأي شكل إعادة تكريس الدكتاتورية والاستبداد في أي صورة كانا.
والحال إن إنهاء الحرب كان الهدف الرئيسي للمعارضة وللمجتمع الدولي منذ البداية. وقد وافقت المعارضة التي تحدثت باسم الثورة، من دون أن تحل محلها، على جميع المبادرات
غطّى على هذه الحقيقة تبنّي الصحافة والإعلام، ثم الدبلوماسية الدولية، فكرة الحرب الأهلية، بدل الثورة أو الانتفاضة أو حركة الاحتجاج. وتعني هذه الحرب تنازع طرفين أهليين على تأكيد حقوقهما الشرعية أو المتساوية في الشرعية. والحال أن الثورة على الظلم والقهر والفساد حق طبيعي ومشروع للشعوب التي تعتبر، في العرف الحديث، مصدر السيادة والشرعية للدولة والسلطة القائمة والحكومة. أما مواجهتها بالعنف والمذابح الجماعية وزرع الفتنة والخراب في البلاد، فهو من الأعمال العدوانية غير الشرعية وغير المشروعة بأي عرف. لذلك، عمل النظام على تشويه هوية الثورة وإنكار وجودها، وأصرّ، مع حلفائه، على الحديث عن مواجهة مع المنظمات الإرهابية التي لم تكن أصلا موجودة ولم توجد قبل عام 2013. وقد نجحت الدبلوماسية الدولية، وفي مقدمها دبلوماسية موسكو وطهران، وأذرعهما الإعلامية، في تكريس فكرة الحرب الأهلية، الأول لتبرير نأيهم بأنفسهم والتخلي عن التزاماتهم، والثاني حتى يبرّروا تدخلهم في سورية، بعد تعطيلهم جميع قرارات مجلس الأمن، فجعلوا من النظام المعتدي الضحية، ومن الشعب المهدورة حياة أبنائه الجلاد والمسؤول عن العنف والدمار والخراب.
إذا كانت الثورة شعبية من دون أي شك، فقد كانت الحرب الرد المباشر للنظام، ثم لحلفائه، عليها ونقيضها في الوقت نفسه. وقد أصبحت حربا ثلاثية الأبعاد، فهي أولا حرب النظام بغرض إخضاع السوريين، والاستمرار في استعبادهم وامتهان كرامتهم واستغلالهم. وهي ثانيا، حرب إقليمية ودولية أرادت منها بعض الدول، إيران وروسيا بشكل خاص، أن تستثمر هزيمة النظام وحاجته للدعم من أجل تحقيق مكاسب استراتيجية، وتصفية حساباتها مع دول الخليج وفرض هيمنتها الإقليمية. وهي ثالثا مواجهة دولية، حاولت فيها روسيا ونجحت في تقليم أظافر الغرب الذي امتهن كرامتها بالاستخفاف بها، وفرض العقوبات المستمرة عليها، واستبعادها من القسمة القذرة ل"غنائم" حربي العراق وليبيا، وكاد يخرجها من المنطقة بخفي حنين. وإذا ظهر أن هناك فرصة اليوم لوقف هذه الحروب، فلأن الأطراف الإقليمية والدولية توشك أن تتوصل إلى بداية تفاهماتٍ حول توزيع المغانم التي تعتقد أنها تستطيع أن تحصدها الآن على أشلاء الشعب السوري، وبعد خسارة الفصائل المسلحة أو استسلامها.
إنهاء الثورة بتحقيق غاياتها
لا يضير الثورة أن تنتهي الحرب. بالعكس، يحرّرها ذلك من العبء الثقيل لهذه الحرب وفسادها. ولا يضع إنهاء الأعمال القتالية حدا لتطلعات الشعب السوري ومطالبه التي أعلن عنها من خلال انتفاضته العظيمة. إنه يعني، ببساطة، بداية العمل على مواجهة الاستحقاقات التي أراد النظام وحلفاؤه تغييبها أو تجاهلها بتسعيرهم أوار الحرب. وإذا كان وقف الحرب يشكل مصلحةً للدول الإقليمية، ولموسكو، وللغرب الخائف من عواقب استمرارها، على نمو الإرهاب أو تزايد تدفق اللاجئين وتعميم الفوضى، وزعزعة الاستقرار في بلدانٍ مجاورة، له فيها مصالح استراتيجية، فهو لا يقدّم شيئا للشعب السوري الذي تحمل وحده كامل عبئها الإنساني والسياسي.
لذلك أعتقد أن من الضروري والواجب الفصل بين المسألتين: إنهاء الحرب، وهي مسألة طارئة على الأزمة التي فجرت الثورة، وإنهاء الأزمة التي فجرتها الثورة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بإزالة الأسباب التي قادت إليها، والتي تتمثل في تغوّل نظام الحكم الفاسد الذي فرض على سورية والسوريين بقوة السلاح والعنف خلال نصف قرن. وكما أن الحرب لم تنته إلا بتحقيق الأهداف التي سعى أصحابها أو مطلقوها إليها، باستثناء النظام الذي خسر كل أوراقه فيها، لصالح من أصبحوا حماته وأولياء أمره، كذلك لن تنتهي الثورة الشعبية، وينبغي أن تنتهي يوما ما، إلا بتحقيق أهدافها. وإلا سوف تستمر بوسائلها الطبيعية التي أطلقتها قبل أن تُحاصر بالحرب، طالما لا يزال هناك سوريون يرفضون العودة إلى العبودية، ويرفضون قيام السلام من جديد على جماجم إخوانهم وجثث مواطنيهم، ويتمسّكون بما أصبح عنوان وجودهم، أعني مبادئ الكرامة والحرية.
هذا الكلام موجه أولا للمفاوضين السوريين الذين يمثلون المعارضة، وللفصائل المقاتلة التي وقّعت، أو سوف توقع، اتقاقات خفض التصعيد، لتأكيد أنهم لا ينبغي أن ينظروا إلى وقف الحرب سلفة مقدمة لهم، لقاء تنازلاتٍ لا مشروعة، يمكن أن تطلب منهم في المفاوضات السياسية المقبلة. بالعكس، ينبغي أن يعتبر القبول باتفاقات أستانة مساهمة من الفصائل المسلحة في بناء الثقة مع الدول الراعية، ولدعم الجهود الدولية المبذولة لوضع حد لكارثةٍ لم تعد عواقبها تؤثر على السوريين وحدهم. وهو موقف لا يمكن أن يوسم بالضعف، بعد المقاومة
والكلام موجه أيضا إلى الوسيط الروسي والمجتمع الدولي الذي دان نفسه عندما لاذ بالصمت وخرس الضمير، وللمبعوث الأممي معا، لتأكيد أنه سيكون من الخطأ الفاحش أن يستخدم توقيع المعارضة على اتفاقات خفض التصعيد، وهي عربون سلام قدّمته فصائل المعارضة المسلحة، ذريعة للالتفاف على المطالب الشرعية للشعب، ومتابعة الحرب على السوريين بوسائل أخرى.
تنتهي الحرب عندما يقرّر من شنّها وضع حدٍّ لها، وكذلك الثورة، فهي لن تنتهي إلا عندما يقرّر أصحابها إنهاءها، ومن الصعب أن يقرّر السوريون، بعد نصف قرن من المعاناة والخبرة مع الاستبداد الهمجي، وسبع سنوات من الصراع الدموي المرير، وملايين الضحايا والمشرّدين، بالإضافة إلى الخراب العميم، التخلي عن أهدافهم ودفن تطلعاتهم نحو الكرامة والحرية، والإذعان لحكم الوحشية والطغيان.
ولا ينبغي لأحد أن يشكّ في أن الوضع سيكون كارثيا، إذا أراد المسؤولون الروس، المنتدبون عمليا من المجتمع الدولي، لترتيب المفاوضات العسكرية والسياسية، أن يختبروا إرادة السوريين التحرّرية، وقرّروا الإصرار على فصل التهدئة العسكرية عن مشروع الانتقال السياسي نحو نظام ديمقراطي، ينهي حكم الأسد الدموي، كما توحي به للأسف تصريحات وتصرفات كثيرة لهم اليوم. إن وضع السوريين من جديد أمام الاختيار المستحيل بين الموت بكرامة أو البقاء مع الذل سيدفعهم إلى وضع أخلاقي وسياسي غير محتمل، مليء بالمخاطر والتهديدات للجميع. سيكون هذا، لو حصل، أسوأ دورٍ يمكن لروسيا أن تلعبه، بعد خروجها من القبر الدولي الذي أجبرت على الحياة فيه قبل أن تقدّم لها هزيمة الأسد على يد قوات المعارضة السورية الفرصة الذهبية لقيامها وخلاصها.