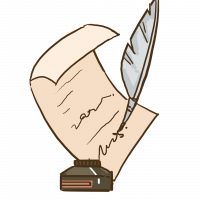ملف| كيف تُستخدم الحرية كسلاح استعماري؟ (20)
بينما نتابع الأحداث في غزّة، شاهدنا سجالات حول قضية فلسطين بين الرأي (السردية المهيمنة) والرأي الآخر. كان من أطولها الحوار الثاني لباسم يوسف مع الإعلامي بيرس مورغان. يطرح باسم سؤالًا جوهريًا وهو: لماذا على كلّ مرشحي الرئاسة الأميركية إثبات الولاء لآيباك التي تمثل لوبي يعمل لصالح دولة أجنبية؟ ليقاطعه بيرس قائلًا: "أتعلم أين تكمن الروعة؟ يمكنك أن تقول هذا هنا بينما لا يمكنك قول هذا في مصر"، وذلك قبل أن يتجاهل السؤال ويغيّر الموضوع. هذه المناورة تستحق التأمل، وبخاصة أنّها ليست المرّة الأولى، ولا الأخيرة، التي يُلمح فيها رجل أوروبي لرجل من الجنوب تلميحًا مشابهًا.
"كلنا عنصريون"، هذه عبارة صادمة واتهام لن يروق لأحد. ربّما لا تخلو هذه العبارة من مبالغة، لكنها ليست مفرغة تمامًا من الحقيقة. فلدينا جميعًا نزعة أصيلة لتفضيل جماعاتنا على حساب الجماعات الأخرى. ألا نحب أوطاننا، وقومياتنا، ومدننا، وقرانا، وأدياننا، وطبقاتنا الاجتماعية، وحتى نادينا الرياضي المفضّل أكثر (بقليل في أحسن الأحوال) من الآخرين؟
قد لا تترجم تلك النزعة بالضرورة إلى سلوكيات عنصرية وخطابات كراهية. إنّما هناك نزعة أخرى مصاحبة لها هي التي تكرّس تلك السلوكيات والخطابات، وهي التعالي الأخلاقي. فمتى ما شعر الفرد بأنّ انتماءه لجماعة بعينها يجعله أفضل، أرقى، أجدر من غيره من المنتمين للجماعات الأخرى، نبتت الكراهية التي تُرسّب بدورها سياسات وخطابات التمييز.
خطابات تصل في جرأتها وعنفها لما حدث في نيويورك، حيث هدّد رجل ما بائعًا مصريًا يعمل على إحدى عربات الأطعمة الحلال بأنّه سيكلم أصدقاءه في المخابرات المصرية الذين (على حدّ قوله) سوف يقبضون على أبيه ويخلعون أظافره واحدًا واحداً، وذلك عقابًا له على دعم "الإرهابيين" في غزّة. ليتضح بعد ذلك أنّ هذا الرجل ليس أيّ رجل، بل هو الديبلوماسي السابق في الحكومة الأميركية، ستيوارت سيلدوويتز، والذي شغل منصب نائب المدير والمسؤول السياسي الأوّل لمكتب الشؤون السياسية الإسرائيلية - الفلسطينية بين عامي 1999 و2003.
متى ما شعر الفرد بأنّ انتماءه لجماعة بعينها يجعله أفضل، أرقى، أجدر من غيره من المنتمين للجماعات الأخرى، نبتت الكراهية التي ترسب بدورها سياسات وخطابات التمييز
وأحدث تلك المواجهات، تلك التي قامت بها مذيعة القناة البريطانية اليمينية Talk TV، جوليا هارتلي برور، قبل أن تفقد أعصابها تماماً في مواجهة الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، وقبل أن تبدأ بالصراخ عليه باعتباره (كما تقول) ليس معتادًا على الاستماع للنساء. وهي قالت له عن الخلاف في الداخل الإسرائيلي حول إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للحرب مع حماس، تقريبًا نفس ما قاله بيرس: "على الأقل المواطنون الإسرائيليون يعارضون رئيس الوزراء في إطار دولة ديمقراطية. وهو الأمر الذي لا وجود له في أي مكان آخر في الشرق الأوسط".
في الحوادث الثلاثة يُستخدم الواقع القمعي الذي يعيشه الناس في جنوب العالم كحجة لإخراسهم إذا ما أرادوا تحدّي أو مناقشة أو تفكيك توجه الشمال (الديمقراطي) العدواني باتجاه بلادهم.
تلك الحجة ليست من ابتداع الثلاثة المذكورين، بل هي في قلب الشخصية التي تتقمصها إسرائيل (البيرسونا الإسرائيلية) في السردية الرسمية الأوروأميركية، والتي تتبناها الشقيقتان الاستعماريتان كندا وأستراليا. لسنوات كانت "إسرائيل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، وهي الحجة التي تُستخدم لإخراس المتشكّكين. تلعب هذه الحجة على نزعة التعالي الأخلاقي لدى أبناء المجتمعات الديمقراطية، حيث يصبح من جهتهم امتلاك "فضيلة" الديمقراطية هو ما يحّدد أي المجموعات يشبههم، وبالتالي أيّها أحق بالوجود والدعم.
على امتداد الخط ذاته، يستخدم غياب الحريات (الجنسية منها على سبيل المثال) في غالبية المجتمعات العربية، لتفريق التضامن مع غزّة وإهدار الدعوة لوقف إطلاق النار منذ الأسابيع الأولى، الذيْن شنتهما جماعات نسوية مناصرة بطبيعة الحال لمجتمع الميم في أوروبا وأميركا. فخرج مدونون إسرائيليون لمهاجمة تلك المجموعات والسخرية منها؛ بسبب التناقض البادي في تعاطفهم مع الحقوق الإنسانية والتاريخية لجماعة غالبيتها من المسلمين، المعروفين بدرجات مختلفة من الكراهية لمجتمع الميم.
هنا تتم المساواة بين واقع المجموعات واستحقاقها. لهذا إذا كانت إسرائيل ديمقراطية وتكفل الحريات الجنسية، أو على الأقل تقدّم نفسها بهذا الشكل، فذلك يجعلها أحق بالدعم والاصطفاف، والعكس بالعكس. إذا كانت بلدان الجنوب تفتقر للديمقراطية والحرية، فهذا يحدّد سقف استحقاقها التاريخي والسياسي، ويرسم كذلك حدود وأشكال التعاطف التي يستأهلونها. فيتحوّل الانحياز للديمقراطية وللحريات في ذاته إلى هوية و"فضيلة"، تغذّي التعالي الأخلاقي لمجموعات فوق أخرى. وعلى النقيض، فإن تمكن هذه المجموعات النسوية من تجاوز تلك النزعة وكذلك تجاوز خلافها الأيديولوجي، بل الأخلاقي في مسألة الانحياز لمجتمع الميم من عدمه، مع الشخصية المتخيلة للمجموع الفلسطيني (باعتباره أغلبية مسلمة وباعتبار ما يحمله ذلك من دلالات حول انحيازاته الأيديولوجية) في سبيل الانحياز للحقوق التاريخية للشعوب المستعمرة، هو عين الاتساق مع الذات والأيديولوجيا.