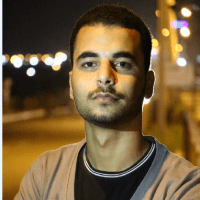لا يحتاج التياران الإسلامي والليبرالي العربيّان، في محاولة ردم الفجوة بينهما، إلى اختراع الجديد أو بناء الصلح/ التوافق التاريخي الأوّل بينهما، بعد أن عمّقت الأنظمة السلطوية العربية حجم العداء، وإنّما يحتاج الطرفان، وفق مؤرّخة دؤوبة مثل إليزابيث ف. تومبسون (Elizabeth F. Thompson)، إلى إعادة نظر كلّ تيار في تاريخ التيار الآخر؛ فالاثنان سيُصابان بالذهول حال أن يقرآ تجربة التحالف السياسي والفكري الأوّل بينهما في المؤتمر السوري عام 1920، بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، حيث سعى العرب الذين أُقصوا عن حُكم بلادهم قرابة أربعمئة عام إلى تشكيل كياناتهم السياسية.
في كتابها "كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب: المؤتمر السوري في عام 1920 وتدمير التحالف التاريخي الليبرالي- الإسلامي فيه"، الصادر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" بترجمة الكاتب والمؤرخ الكوسوفي السوري محمّد م. الأرناؤوط، تتقصّى المؤرّخة الأميركية إحدى أكثر المراحل التاريخية تعقيدًا في تاريخ المشرق العربي الحديث، وهي من لحظة إعلان المؤتمر السوري استقلالَ سورية وتتويج الأمير فيصل بن الشريف حسين ملكًا عليها في 8 آذار/ مارس 1920 وحتى احتلال القوّات الفرنسية للعاصمة دمشق في 25 يوليو/ تموز عام 1920، وتروي، باستخدام مصادر جديدة لم توظَّف من قبل (كأرشيف تقارير المؤتمر والصحف والرسائل والمذكّرات الشخصية) حكاية صوغ أوّل دستور علماني أسّس لبناء أوّل ديمقراطية عربية بعد انهيار الإمبراطورية، والذي أشرف عليه الشيخ رشيد رضا.
الحكومة العربية في دمشق
دخل الأمير فيصل بن الشريف حسين مدينة دمشق بجيشه الحجازي، مُعلنًا في 5 تشرين الأوّل/ أكتوبر عام 1918 قيام حكومة دستورية، عربيةٍ ومستقلّة، دستورها العلماني الحديث، الذي استغرق العمل عليه نحو تسعة أشهر، هو الأوّلُ من نوعه عربيًا، وقائمٌ على مبدأ "النظر إلى جميع الناطقين بالضاد على اختلاف مذاهبهم وأديانهم نظرةً واحدة، لا فرق فيها بين حقوق المسلم والمسيحي والموسوي، وأنّ الدين لله والوطن للجميع"، كما جاء في إعلان الأمير فيصل. وعلى حدّ تعبير إدمون رباط، فإن إعلان فيصل كان أوّل مظاهر التعبير عن عروبة الدولة، ومنعطفًا في تطوّر وضع "أهل الذمّة" واعترافًا بصفتهم مواطنين كاملي الحقوق. كما أنّ تلك الحكومة أنشأت جامعة سورية حديثة، ومَجمعًا علميًا للغة العربية، وسَنَّت قانونًا للنقد الوطني السوري، وجيشًا وطنيًا سوريًا خالصًا يقوم على التجنيد الإجباري، حيث إنّ ذلك الجيش الذي دخل به فيصل إلى دمشق كان جيشًا حجازيًا وتمّت "سورنته" مباشرةً، ولم يتبقّ من الحجازيين يوم ميسلون ما يتعدّى فرزة حراسة، على حد تعبير المؤرخ السوري محمد جمال باروت.
وقد اعتبر المنظّر القومي ساطع الحصري، في كتابه "يوم ميسلون"، هذا النموذج "دولةً عربيةً بأتمّ معاني الكلمة"، ولكن الأمير فيصل ما لبث أن وجد نفسه بين دهاة الإنكليز والفرنسيّين أضيَع من الأيتام على مأدبة اللئام، كما يصف ذلك علي محافظة، إذ لم يَعبَأ هؤلاء لا بالعرب ولا بمطالبهم، ولا بوعودهم التي قطعوها للشريف حسين وابنه فيصل لاحقًا ثم سرعان ما أنكروها.
دستور علماني حديث هو الأوّلُ من نوعه عربيًّا
ولمّا فشل الوفد العربي في مؤتمر الصلح بباريس في تحقيق مساعيه، وعاد فيصل إلى دمشق مُحمَّلًا بعرض رئيس وزراء فرنسا جورج كليمنصو بقبول الانتداب الفرنسي على سورية الشمالية ولبنان، رفض المؤتمرُ السوري العام العرض، وأعلن استقلال سورية الطبيعية، ونادى بالأمير فيصل ملكًا عليها في 8 آذار/ مارس 1920.
وعليه ننطلق من هذه اللحظة التي حظيت بحصّة الأسد من كتاب تومبسون. ولإيضاح أهمية مساهمة هذه المؤرّخة من ناحية الجديد فيه، كما لتفسير مركزية هذه الحقبة، لا بدّ من ذِكر أنّ الجنرال غوبيت حين احتلّ بفرقته العسكرية العاصمة دمشق، كانت لديه تعليمات صارمة بمداهمة مقر المؤتمر السوري العام لـ"مصادرة كلّ ما يتعلّق بهذه التجربة الديمقراطية الفريدة وإتلافها"، وانطلقت تومبسون لفهم تداعيات فتك الفرنسيّين عليه في فسخ التحالف العلماني- الإسلامي الفريد الذي نجح في وضع "دستور ديمقراطي عصري يؤسّس لنظام نيابي دستوري لدولة لا مركزية عربية يكون فيه الإسلام دين الملك لا دين الدولة".
الشيخ في مواجهة الملك
في صباح 27 آذار/ مارس 1920، دعا رئيس جلسة المؤتمر السوري، هاشم الأتاسي، العسكريَّ ورئيسَ الحكومة رضا الركابي إلى تقديم البرنامج السياسي لحكومته كي ينال الثقة، ورفض الأخير الحضور، وهو ما أثار أوّل أزمة في المملكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد صوّت نوّاب المؤتمر قبلها بأيام على قرار يطالب رئيس الحكومة بأن يكون مسؤولًا أمامهم وليس أمام الملك، وكان الأخير هو ورئيس حكومته الركابي مستنكرين لهذا التصويت المجمع عليه في المؤتمر، لكنّ قادة "جمعية العربية الفتاة" في المؤتمر كانوا يكافحون ضدّ الاستبداد الملكي الذي اعتادوا عليه في المرحلة العثمانية، وجاء الوقت لكي يؤمّنوا ديمقراطيتهم.
استمرّت تلك الأزمة ثلاثة أيام وتدخّل بعدها الشيخ رشيد رضا للتوسّط، وذهب إلى القصر الملكي، وسأله الأمير فيصل عن رأيه في الأزمة، أي أزمة القرار الذي اتخذه المؤتمر بمحاسبة رئيس الحكومة أمامهم وليس أمام الملك، فتأخّر الشيخ في الردّ، وقرّر أن يتحدّث بصراحة بحضور إحسان الجابري والأمير زيد، وهذه الصراحة دفعت إليزابيث تومبسون إلى القول إنّ النقاش الذي دار بين الأمير والشيخ يومها تحوّل إلى لحظة أسطورية في التاريخ السوري، ولأهمية النقاش فعلًا نورده هنا:
قال رضا ناصحًا: "رأيي أنّه لا يمكن الرجوع عنه بعد وقوعه، فلا بدّ من تنفيذه".
أُحبط فيصل وألحّ قائلًا: "لا أقبل أن أُعطي السلطة لهذا المؤتمر. إنّه ليس بمجلس نيابي".
ردّ عليه رضا: "بل هو أعظم من مجلس نيابي، إنّ هذا المؤتمر جمعية تأسيسية".
قال فيصل: "أنا الذي أوجدتُه، فلا أعطيه هذا الحقّ الذي يعرقل عمل الحكومة".
ردّ رضا بحسم: "بل هو الذي أوجدك. أنت كنت قبله قائد جيش الشرق التابع للورد ألنبي، فجعلك هذا المؤتمر ملكًا لسورية. إنّه يمثّل السلطة العليا لأنه يمثّل الأمّة. إنّ هذا يستند إلى دينك الإسلام وكلّ القوانين الحديثة".
وتُعقّب تومبسون على الحوار بأنّ الملك صمت ولم يتوقّع من رضا أن يبرّر سلطة المؤتمر بالاستناد إلى الشرع. "حيث اعتقد فيصل، نظرًا إلى أنّه كان القائد المنتصر للثورة العربية، أنّ الشرع سيكون في صفّه. فقد كان السلاطين العثمانيون يبرّرون حكمهم بواسطة الإسلام لقرون". بل إنّ هناك مشادّة أُخرى وقعت بين الملك والشيخ توضّح مكانة وصراحة ومبدئية الأخير بشكل قاطع، كما يذكُرها لنا المؤرّخ فاروق حبلص في بحثه ضمن كتاب "الحكومة العربية في دمشق" الصادر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، أنّه في اليوم الذي نزع المؤتمر الثقة عن الحكومة عند قبولها بإنذار الجنرال الفرنسي غورو باحتلال البلاد، ذهب الشيخ بصحبة وفد من المؤتمر إلى الملك فيصل، وقال الأخير يومها: "من أنتم ... أنا خلقت سورية"، وردّ رشيد رضا على غرور الملك بالقول: "أأنت خلقت سورية؟ لقد خُلقت سورية قبل أن تُخلق أنت".
وبالعودة إلى الشيخ ونقاشه الأوّل مع الملك حول المؤتمر، فإنّ رضا، وفق المؤرّخة، كان يعتقد أنّ ممارَسة المجالس التشريعية يمكن أن تعيق الملوك القابلين للفساد من بيع بلادهم للأوروبيّين، وكان لديه اعتقاد راسخ أنّ الدستورية الليبرالية هي تعبير أصيل عن القيم الإسلامية وليست فسادًا أو فكرًا غربيًا، على عكس ما يُحبّ أن يرى إسلاميو اليوم. وعليه، وبعد إصرار من الشيخ وأعضاء "جمعية العربية الفتاة"، في المؤتمر، توصّلوا إلى حالٍ وسط مع الملك فيصل، وهو أن يبقى المؤتمر منعقدًا، شرط أن تنحصر سلطته على الحكومة في الأمور التي تتعلّق بالاستقلال السوري.
وقد عقدت تومبسون مقارنةً تاريخية مع النموذج التركي الذي كان يتشكّل بالضبط في نفس العام الذي كان السوريون يسعون فيه إلى خلاصهم، إذ وجدت أنّ ما كان في دمشق يومها من نقاشات وتأسيس للدستور هو ثورة ديمقراطية بامتياز، أنضج من نظيرها التركي، ففي الوقت الذي كان السوريون إحيائيّين وغير إقصائيّين وليبراليّين، كانت الحركة التركية تدافع عن مطالب الأتراك والمسلمين في الأناضول ضدّ مطالب اليونانيّين والأرمن والمسيحيّين، كما لم يضمن ذلك الدستور المساواة بين جميع المواطنين، على عكس ما فعله السوريّون يومها وما أعلنه الملك فيصل يوم دخوله دمشق عام 1918.
ربّما يفسّر البعضُ أنّ ما قام به السوريون آنذاك ما هو إلّا تعبير عن النفس ليُثبتوا لباريس (التي تنوي احتلالهم) أنّهم يتبنّون قيمًا ديمقراطية ليبرالية ويرعون حقوق غير المسلمين، ففي حينه كانت بريطانيا وفرنسا تُبرّران احتلالهما وتدخُّلهما في بلدان أُخرى بحماية الأقليات من "الاستبداد الإسلامي". ولكنّ تومبسون ردت على أيّ ادعاء من هذا النوع بالقول: "إنّ تفضيل الزعماء السوريّين للديمقراطية لم يكن مجرّد تكتيك انتهازي، بل كانوا يعملون بقناعة سياسية راسخة. فقد انضمّ بعضهم إلى حزب اللامركزية قبل الحرب للنضال من أجل المساواة بين العرب والمسيحيّين وغيرهم من الأقلّيات في البرلمان العثماني. وبالنظر إلى ظروف عامي (1919 - 1920)، كان تصميمهم لسورية كأمّة عربية يجب أن يُفهم بكونه تعبيرًا عن روح احتوائية تقوم على تضييق الفروق لتوحيد الناطقين بالعربية".
دستورا سورية 1920 والولايات المتّحدة 1787
بالقدر الذي برهنت فيه تومبسون على ديمقراطية النُّخَب السورية يومها، إلّا أنّه بالفعل كانت محاولات السوريّين للإسراع بإنشاء الدستور ضرورةً مُلحّة لحماية أنفسهم من الأنظمة الاستعمارية، إذ كان فيصل يرى أنّ الدستور سلاح مدني لسدّ الطريق على المستعمِرين وأساسًا للحياة الديمقراطية. وقد قارن السوريّون أنفسهم بالأميركيّين الذين اجتمعوا في فيلادلفيا عام 1787، فكما كتبت جريدة "العاصمة" في حينه أنّ الفرق بينهما هو أنّ الحكومة الأميركية جمهورية دستورية، والحكومة العربية ستكون مملكة دستورية. زد على ذلك أنّ السياق التاريخي لكلتا التجربتين أيضًا متشابه، فالسوريّون والأميركيون كانوا يعملون على تأسيس دولهم ودساتيرها تحت الضغط لتوحيد شعبَيهم والدفاع عن بلادهم ضدّ التهديد الخارجي.
ضمّت اللجنة الدستورية عدداً من الشخصيات البارزة والحقوقية التي تعكس مدى التنوّع المناطقي والفكري والديني، كهاشم الأتاسي وقريبه المحامي وصفي الأتاسي من حمص، وعزة دروزة ابن نابلس وصديقه الفلسطيني إبراهيم القاسم عبد الهادي، وسعد الله الجابري والمسيحي تيودور أنطاكي من حلب، والمحاميَين سعيد حيدر (بعلبك) وعثمان سلطان (طرابلس)، والشيخ عبد القادر الكيلاني (حماة).
وكانت أوّلُ ثلاثة بنود قدّمتها هذه اللجنة إلى المؤتمر قد جعلت من الدستور السوري كالطفل المتمرّد على سلفه العثماني، على حد تعبير المؤرخة، حيث جاء فيها: "1- حكومة المملكة العربية السورية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق ودين ملكها الإسلام؛ 2- المملكة السورية تتألّف من مقاطعات ذات وحدة سياسية لا تقبل التجزئة؛ 3- سيكون الملك القائد العام، ولكن أي إعلان للحرب أو عقد معاهدة سلام يجب أن يخضع لتصديق المؤتمر، ولا يجوز لأيّ عضو في الأسرة الملكية أن يكون عضوًا في الحكومة".
صادَر الفرنسيّون وأتلفوا كلّ ما يتعلّق بهذه التجربة
واستكمالًا للبند الأخير، اقترحت اللجنة في ما يتعلّق بالملك، أن "يُقسِم يمين الاحترام للشرائع الإلهية والأمانة للأمّة والمراعاة للدستور"، وبهذا تمرّدت حقًّا على سلفها، إذ أسقطت واستبدلت كلمة "الشريعة" بـ"احترام الشرائع الإلهية"، وهذه الروح دفعت اللجنة إلى حذف البنود من 4 إلى 6 في الدستور العثماني، والمتعلّقة بقدسية السلطان ودوره كحامٍ للإسلام، وبالحصانة القانونية لأسرته.
بالإضافة إلى هذا، وفي ما يتعلّق بكلّ المساحات الحقوقية للمواطنين، فقد وصف الباحثون في تلك المرحلة هذا الدستور بأنّه "في نصّه ومضمونه الأكثرُ تقدّمًا وحداثةً بين دساتير عصره، وأرقاها في كلّ ما يتعلّق بتعريف الحقوق والواجبات والحريات والمساواة التامّة فيها، كما أنّه سبق في منحه المرأة حقّها المُساوي للرجل معظمَ الدساتير الأوروبية في حينه، ومنها الفرنسي".
لم تفشل، بل سُرقت عمداً
سعت إليزابيث ف. تومبسون في كتابها إلى التأكيد على أن الدولة العربية الديمقراطية التي أقيمت عام 1920 لم تفشل، بل سُرقت عمداً مع دخول الجنود الفرنسيّين العاصمة دمشق في 25 تموز/ يوليو عام 1920، حيث نفت قادتَها، ثم اتّبعت سياسةً منهجية لتفكيك المرحلة "الشريفية" كما يسمّيها الفرنسيّون. ويذهب كذلك عددٌ من الباحثين في تأييد هذا التحليل، كبرهان غليون في كتابه الذي صدر قبل أسابيع عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" بعنوان "سؤال المصير: قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية"، والذي رأى في زحف القوّات الفرنسية إلى المشرق العربي سحقًا لرغبة تلك الشعوب في حقّها بتقرير مصيرها.
ونحن، وإن اتّفقنا مع كليهما، فإنّ النظرة المتفحّصة تكشف عن أنّ الوضع السياسي في سورية كان هشًّا جدًّا، وهو طبيعي، كما أنّ هناك قسمًا من النخب السياسية طلب من باريس صراحةً أن تنتدب سورية مثل "الحزب الحرّ المعتدل" (المرتبط بالحزب الوطني) الذي كان يرأسه عبد الرحمن باشا اليوسف، وكان أحد أغنى رجال دمشق، وكان يرى في حكومة فيصل تهديدًا لمصالحهم ومكانتهم كأصحاب نفوذ قوي في المدينة، وقد استخدم وصف "الأغراب" في إشارة إلى فيصل والنوّاب العرب القادمين من لبنان وفلسطين.
يُضاف إلى ذلك وضْعُ الجيش السوري المترهّل، والذي لم يصمد أمام القوّات الفرنسية أكثر من ساعتين، فلم تكن هناك خطّة تعبئة وإنشاء جيش قادر على أداء مهامه لأسباب متعدّدة، منها وأهمّها أنّ الشيخ رشيد رضا ضغط على رئيس الحكومة في حينه، رضا الركابي، بضرورة تشكيل قوّة دفاعية مكوّنة من العشائر البدوية لتكون سدًّا منيعًا أمام أيّ محاولة اعتداء، ولكنّ تقاعُس الركابي هو الذي أحبَط هذا المخطَّط. إذن، بجانب التحليل الاستعماري الحق جدّاً، لا بدّ من تحميل أنفسنا جانبًا من المسؤولية.
* باحث من فلسطين