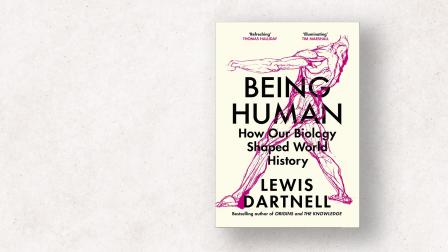لم ينل كاتبٌ عربي قراءات متعدّدة ومركبة لعمل روائي واحد مثلما حدث مع الطيّب صالح في "موسم الهجرة إلى الشمال"، الذي قدّم في أقلّ من مئتي صفحة أزمنة متداخلة، مفكّكاً جملة التباسات وأوهام لدى المستعمِر بالمستعمَر وبالعكس؛ حيث سعى الأول إلى تحديث الثاني بهدف الهيمنة عليه، ما ولّد تشوّهات لا تزال ماثلة إلى اليوم، ولم تستطع شعوب الجنوب أن تنجو منها في علاقتها مع الغرب.
ورغم الانتشار الواسع لهذه الرواية والتناول النقدي الهائل لها إلّا أن فخاخاً كثيرة ظلّت تلاحق صاحبها، سواء في ما يتعلّق بمضمونها الذي اعتبره كتّاب عرب متطابقاً مع الرؤية الاستشراقية، ولم تنجح محاولات المؤلّف في تفنيدها، أو ما يتصل بذلك الإصرار على تخيّلها سيرة ذاتية عاشها صالح في لندن، ما اضطره إلى نفي ذلك كلما ظهر على الإعلام.
يضيء أستاذ الأدب الإنكليزي والناقد محمد شاهين أبعاداً مختلفة في شخصية الكاتب السوداني (1929 – 2009)، في كتابه "الطيب صالح.. حوارات ومتابعات في الفكر والثقافة والإبداع"، الذي صدر حديثاً عن "المؤسسة العربية للدراسات والنشر"، من خلال انطباعاته التي كوّنها عبر لقاءاته الشخصية مع صاحب "عرس الزين"، وتوثيقه لمقابلاته الصحافية على مدار سنوات طويلة.
آمن بأن "موسم الهجرة" من أقوى الحجج الفنية ضدّ الاستعمار
إحدى الالتقاطات البارزة التي تحتويها مقدّمة المؤلّف، تتمثّل في رأي عبد الرحمن منيف بـ"موسم الهجرة إلى الشمال" في كتابه "الكاتب والمنفى"، كونها "رواية تمجّد الاستعمار"، وهو تقييم يعتقد شاهين أنه لم يأت من فراغ لأنه يعود في أصله إلى الخطاب المعقّد الذي أنتجته شخصية مصطفى سعيد، وهو العصب الذي ترتكز عليها الرواية، لكنه يعتقد أن منيف ضلّ السبيل إلى قراءة منصفة عندما رأى البطل مجرّد راوٍ لتاريخ الاستعمار في سياق يتعاطف فيه الروائي نفسه مع الراوي المتخيّل داخل الرواية، كما جرت العادة في رواية العصر الفيكتوري.
شاهين الذي عقَد صداقة حميمية مع كلا الكاتبيْن، لم يتمكّن من متابعة مبرّرات تقييم كهذا من منيف لأسباب لا يذكرها، لكنّ صالح ردّ على ذلك التقييم في حوار ضمّه الكتاب بالقول إن "روايته ترجمت إلى واحد وعشرين لغة وقُبلت عالمياً على أنها من أقوى الحجج الفنّية ضدّ الاستعمار". أمّا شاهين، فيلفت إلى الخطاب المغاير للرواية ويكمن في المفارقة التي يمثّلها مصطفى سعيد؛ بطل الرواية، في قوله "جئتكم غازياً" وليس "مجرّد وافد مثل عطيل الذي يضيع في متاهات الغربة الغربية الغريبة. وكأن صدى عبارته (أي سعيد) توحي بالقول: أنا لستُ الوافد الضحية المسالم المستسلم. مصدر قوّتي أصلاً مردّه ردّة فعل قوّتكم؛ جرثومة فتّاكة لا تفرّق بين غازٍ ومغزوّ، بين متسعمِر ومستعمَر".
مسألة ثانية يستذكرها شاهين في تقديمه وهي القراءة الجائرة التي استُقبلت بها الرواية فور ظهورها في مجلّة "حوار" لأوّل مرة عام 1966، إذ مُنعت من النشر في مصر والكويت بسبب "الاعتماد على قراءة لا تذهب أبعد من البُعد الخارجي للحدث"، وربما مثل هذه القراءة جعلت منيف يذهب في تقييمه للرواية إلى ما ذهب إليه، بحسب المؤلّف.
تفسير الحدث/ الحبكة الذي قامت عليه الرواية ظَلّ مدار بحث لم ينته حتى اليوم، ما تثبته إجابات صالح عن أسئلة متكرّرة طرحها عليه محاوروه في هذا السياق، وتأكيده المستمرّ على وجود وهم أوروبي ووهم عربي حيال الصراع بين الشرق والغرب، حيث كلمة "شرق" لا تعني بالنسبة إليه أي شيء، بل إنه يعتبر أنه من ضمن الأوهام التي أضافها العرب على هذه الأوهام قبولهم بأنهم "شرق"، وبذلك يكون الصراع في الرواية بين أوهام.
ويذهب أبعد من ذلك بالقول: "كنت من أوائل الكتّاب العرب الذين قدّموا تحدّياً لهذا الوهم، لأنه لم يكن ثمة أدنى شك في ذهني بأن هذه العلاقة علاقة مزيّفة، ولا يمكن أن ينتج عنها أي فائدة. وقد جاء أساتذة مثل إدوارد سعيد، الذي كتب كتابه 'الاستشراق' وتعرّض لهذه القضية باستفاضة، وكيف أن الغرب 'صاغنا'، قائلاً بالفكرة من جديد، في صورة ليست حقيقية، بل صورة أرادها ليقيم علاقته مع هذا الوهم".
قال بأن الصراع بين الشرق والغرب مجرّد وهم أوروبي وعربي
لم يكن ذلك هو الهاجس الوحيد لدى صالح عند كتابته هذه الرواية التي صدرت بعد إقامته في لندن لستّة عشر عاماً، إذ يبيّن في أكثر من لقاء أنه سعى أيضاً إلى إضاءة مناطق مظلمة في الوعي العربي حين كتب عن بلده السودان وتحديداً في شماله حيث تسكن قبائل عربية يشكّل نهر النيل أساس وجودها، لافتاً إلى أن تصويره نمط حياتهم يصب في النهج الذي سار عليه كتّاب عرب مثل البشير خريف في رواياته حول الجنوب التونسي، وعبد الكريم غلاب في كتابته عن المغرب، وطاهر وطار حول الجزائر، وغالب هلسا في روايته عن الأردن ومصر والعراق.
إلى جانب رغبته في الحديث عن الصراع في الحياة الذي يقوم بين إيروس (الحب) والموت، إذ كان واقعاً في تلك الفترة تحت تأثير فرويد، بحسب إحدى مقابلاته، حيث الحب هو التعبير التام عن الحرّية، وما عدا ذلك ــ مثل أن يصبح المرء مليونيراً أو رئيساً للجمهورية، أو أي شيء آخر ــ فهذا كله يدخل في باب الموت.
لكنّ هذه الطروحات وغيرها ممّا تناوله في هذه الرواية ظلّ أسير الجدل حول مضمون رسائله التي أوصلها للقارئ، كما يظهر في ردود الفعل التي دارت حولها، وكذلك في إصرار القرّاء والنقّاد على اعتبار بطل الرواية تمثيلاً لحياة الطيب صالح، ما استدعى تفنيده لذلك بأشكال مختلفة، ومنها قوله إن حياته لم تحمل إثارة تُذكر، خلافاً لمصطفى سعيد، وإن التخييل في خلق الشخصية كان طاغياً على كلّ ما هو واقع، وإن كانت بعض صفاته تشبه صالح أو مئات العرب من جنسيات مختلفة أكدوا أنهم يشبهونه، كما كانوا يخبرونه في لقاءاتهم معه.
ويزيد في توضيح المسألة بأن "الكاتب يجب أن يقطع الحبل السريّ بالتجربة ويتركه يختلط بأشياء كثيرة، ومصطفى سعيد به صلة بي، ما لمحيميد في 'ضو البيت' من صلة بي"، في إشارة إلى روايته التي صدرت عام 1989؛ بعد أكثر من ثلاثة عقود من صدور "موسم الهجرة إلى الشمال". وينطبق الأمر ذاته على جين مورس، حبيبة مصطفى سعيد، التي كانت مجرّد اسم لفتاة التفاها صالح مرّة واحدة أثناء حضوره معرضاً فنياً ولم يقابلها بعد ذلك، لكن أطلق خياله لتصوّرها إحدى شخصيات روايته.
رواية واحدة طغت على بقية أعمال الطيب صالح التي لم ترقَ إلى مستواها، ولم يستطع الإفلات من هيمنتها على معظم محاوريه الذين كان يضطرّ كثيراً لتصحيح معلومة أنها ليست روايته الأولى، وأنه كتب رواية "عرس الزين" قبلها بسنوات عدّة، وهو يحافظ على موضوعيته إزاء الطروحات المبالغ فيها حول "موسم الهجرة إلى الشمال" بأنها رواية مستقبلية أو عمل فكري أو تاريخي، دون إغفال "أسبقيته" في التصدّي لأطروحات مركّبة لا تزال تواصل تأثيرها في الراهن العربي. بل ربما كانت الرواية العمل الأبرز الذي نُشر قبل هزيمة حزيران/ يونيو 1967؛ الهزيمة التي فجّرت تساؤلات حرجة حول الذات العربية في نظرتها إلى "انكسارها" كجماعة مستلبة وغير فاعلة في حاضرها، وفي طبيعة علاقتها المعقّدة مع الآخر.
ببساطة، تعامل الطيّب صالح مع تلقّي روايته بواقعية شديدة، باعتبارها عملاً نجح في مقاربة أفكار لا تزال راهنة دون التنازل عن المستوى الفنّي، قائلاً إنها لا تحتمل أكثر من ذلك. وينسحب الأمر على مشروعه الروائي كلّه، حيث يقول بصراحة: "لم أرد أن أكون كاتباً. بل بالعكس، أنا حاولت أن أكون شيئاً آخر وأصبحت كاتباً بطريق الصدفة، ولم أرد أن أترك السودان... أيضاً خرجت من السودان بطريق الصدفة، ويبدو أن الصدفة تلعب دوراً في حياتي".