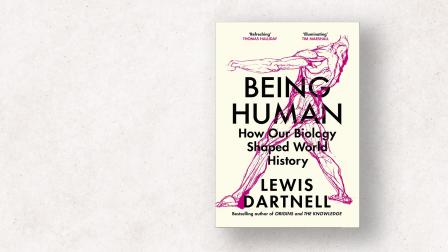تُعدّ الإدانة في الأعراف الدولية فعلاً دبلوماسيّاً بامتياز، يُسجّل عبرَه طرفٌ ما موقف الرفض لحدثٍ محدَّد. وقد تتجاوز الإدانة الخطابَ لتتجسّد في عمل ملموس مثل استدعاء السفراء أو سحبهم وحتّى قطع العلاقات بين البلدان. هذا ما يجري في أزمان السلم والأزمات الاعتيادية التي تُحرّك يوميات العالَم. وأمّا في مثل حروب غزّة، فقواعد الإدانة أخفى وهي إلى الغموض والمكر أقرب، وتستحقّ عمليةَ تفكيك معمَّقة.
فمن جهة أُولى، يستميت الإسرائيليّون ومناصروهم، أكانوا إعلاميّين أم رجال دولة أو مثقّفين، في اقتلاع إدانة صريحة من ضيوفهم لهجوم حماس يوم السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر، كما لسائر أعمالها مُذ كانت. ويُطالب هؤلاء بهذه الإدانة كشرط لمواصلة الحوار: تُتلى كما تُتلى الشعيرة الدينية أو شهادة الإيمان، فإمّا تُتيح لصاحبها القبول ومواصلة النقاش أو تجلب له الإقصاء واللعنة. وبمجرّد موت شخص واحد، تتعالى الأصوات بالاستنكار، ثم تنزلق المقابلة إلى شجب للدين الإسلامي و"عنفه"، ولمَ لا اقتراح تصوُّر عن إسلام فرنسا! هكذا في مثل حفلة مسعورة، صيغُها محفوظة مسكوكة، إيقاعُها شعائري وغايتها شيْطنة مَن يعتبرونه إرهابيّاً بعد القطع بتهمته من دون أيّ حقّ في الدفاع عن النفس أو حتى مجرّد التوضيح.
وفي المقابل، تتوالى المجازر ويُقتّل آلاف الأطفال والنساء وتُقصف المستشفيات والمساجد والكنائس، من دون أن يُطالِب أحدٌ بالشجب أو الاستنكار. يَغفَل الإعلاميّون عن مطالبة ضيوفهم المساندِين لـ"إسرائيل" بالتنديد بما حصل، لأنّ دم الطفل الفلسطيني لا يُساوي نظيرَه من ذوي الجنسيات الغربية. وحتى عندما تُرتَكب مثل هذه المجازر في حق مؤسّسات غربية، مثل "الأونروا" والمعاهد الأوروبيّة، فإنّ هذه الدول تكتفي بالمطالبة "بتوضيحات" أو "تعبّر عن قلقها"، في بيانات باهتة باردة.
حفلة مسعورة هدفها شيطنة الفلسطينيّين ومن يناصر قضيّتهم
وهكذا، يختلف فعل الإدانة وشكله ومضمونه بحسب هويّة الجاني والضحيّة، ويُصبح التلاعُب بالإدانة جزءاً من اللعبة الإعلامية والخطابية، يَصنع عبر التصريح بها خطاباً حول الجرائم المروّعة إمّا تغييباً مقصوداً لها أو تخفيفاً من شأنها. لكن، حين يرتكبها الطرف الفلسطيني تُضخَّم حتى يسوَّغ ما سيأتي بعده من الانتقام الجنوني. وعندما يُدينها الغربيّون، معتبرين إيّاها "إرهاباً"، فبهدف إظهار تعلّقهم بالقيم الإنسانية والتبجّح بحقوق الإنسان. لكن تغيب هذه القيم الإنسانية تماماً عندما يتعلّق الأمر بشجب المجازر التي يأتيها المعتدون في حقّ المدنيّين، وتتلاشى مقولات القانون الدولي ومبادئ الأخوّة البشرية.
وعلى ذكر لعبة الإدانات، نلاحظ أن الصّمت المطبق جزءٌ من آلياتها: تسكُت جحافل المثقّفين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحيوان، وهم الذين يملأون الدنيا صراخاً حين يتعلّق الأمر بدجاجةٍ تموت في أقصى قرية أوروبية، ويمتنعون عن الإدانة حتى حين تنهال القنابل المحرّمة على شعبٍ أعزل، ثم يبرّرون صمتهم بخطابٍ فكري لا ينطلي حتى على الصبيان. وفي أحسن الأحوال، يُكتفى بصيغ باردة من قبيل "نحن بصدد التحقّق من وقوع كذا" أو "لسنا متأكّدين". وقد يُهرب من السؤال ويُنصرف عنه كلّياً، كأنّ أطفال فلسطين لا أحلام تُدغدغهم ولا مشاعر تحرّكهم، لا يعانقون الآمال كسائر أطفال العالم.
أمّا الجمعيات النسوية التي اعتادت أن تقيم الدنيا من أجل حجاب ترى أنّه مفروض على المرأة حتى وإنْ وضعته إيماناً وحرية، فلا تنبس ببنت شفة أمام التقتيل المستمرّ، لأكثر من شهر، لنساء فلسطين وبناتِها. تعلم هذه الجمعيّات أنّ أكثر المستهدَفين هم من النساء والأطفال، لكن لا بواكيَ لهنّ، وتتلاشى الإدانة في الحناجر.
وفي سياق آخر، تمنع البلدان الغربية الاستنكار الموجّه لـ"إسرائيل" وتعتبره معاداة للسامية ومساساً بالأمن العام، وكلاهما جريمة، في حين تسمح بحرق المصاحف وإهانة ملايين المسلمين بدعوى "حريّة التعبير" التي تُرفع إلى مَصاف المقدّسات أو تُنتهك صراحةً بحسب الظروف والأطراف المعنية.
وأمّا لدى مثقَّفي اليمين، فيتحوّل التنديد بـ"إسرائيل"، وفي طرفة عين، إلى إلغاء للآخر ومنها إلى "حرب أديان" و"صراع حضارات"، كما عند مفكّريهم مثل ميشال أنفري وجيل كيبال وزيمور. أن تنتقد المجازر يعني أن تُشكّك في قيَم الحداثة وأن تنضمّ إلى قوافل البرابرة من العرب والمسلمين الذي لا يؤمنون بقيمها الكونية. التنديد بحماس واجب يقتضيه الإيمان بالإنسانية. ثم ينجرّ هؤلاء المثقّفون في لعبة الإدانة هذه تخويناً وتهويلاً حتى يجعلوا منها شرط مواطنة وصكّ غفران.
وحين تُقرَن الإدانة بالدول العربية وجامعتها، فإنّها تصبح رديف العَجز والعطالة، بل وتغدو صورة ساخرة تومئ إلى مقدار الهوان العربي. ومع هذا، لا تأتي الإدانة من هذه الدول صريحةً صارخة، بل باهتة تثير الاشمئزاز ولا تبعث على التعاطف، فضلاً عن أن تُغيّر واقعاً، إذ الخصيصة الرئيسة لهذه الأقوال الإنجازية، كما نظّر لها دانيال فاندربيكن في كتابه "أفعال الخطاب" (1988)، هي إحداث تغيير في الواقع والتأثير عليه.
اليوم، من بين واجبات المثقَّف المأزوم أن يَكشف ألاعيب هذا القول ويفضح ما يختفي وراءه، ليس فقط من "نفاق أخلاقي"، وإنّما من تزييف فلسفي وثقافي للقيَم تلاعُباً بها حتى سقطت ورقة التوت عن الفكر الغربي الموغِل في مركزيته وإحساسه بالتفوّق على سائر الأجناس، وإيمانه العميق، والذي يعبّر عنه دون عقد، بأنّ الناس غير متساوين، وأنّ نسمة الحياة التي نُفخت في أطفال فلسطين ليست هي التي نُفخت في غيرهم.
تختلف الإدانة وشكلها ومضمونها حسب هويّة الجاني والضحية
كما أنّ الإدانة ومظاهر التلاعب بها إظهاراً وإخفاءً من صميم الحرب الإعلامية وخفيِّ الدّعاية التي تتوازى مع الحرب الواقعية وتُكملها وتمنح لها الشرعية. هي لعبة ماكرة يستغلّ الغرب غموضها من أجل شيطنة الضحيّة وتبرئة المعتدي، يجعل لها في الخطاب الدبلوماسي درجاتٍ وظلالاً، تتراوح بين الشجب والرفض والتنديد والانتقاد والاستنكار، ثم يُخرجون من القبّعة المصطلح الذي يلائمهم أكثر بحسب الغايات والفصول.
لكن أليست الإدانة أصلاً حيلة مخادِعة غرضُها إيجاد كلام يُغطّي على عجز الفعل. فهل تحتاج غزّة اليوم إلى خطابات الإدانة تخفيفاً عن وخز الضمير؟ أم إلى فعل عاجلٍ تَقع مسؤوليته على القوى الكبرى، وعليها أن تتحمّلها، فالمطلوب الضغط الفعلي على "إسرائيل" من أجل إيقاف المجازر، وليس الاكتفاء بخطاب الإدانة الذي يجري على صيغ جاهزة لا روح فيها، حتى سُمّيت في اللسان الفرنسي "اللغة الخشبية"، لما فيها من غلظة وسماكة.
ولئن كانت بعض الإدانات تَستحضر من طرف خفيّ الرسالة المفتوحة التي صاغها الكاتب الفرنسي إيميل زولا "أدين" تنديداً بالظلم الذي حاق بدرفيوس وإسهاماً في تغيير مسار القضية، فليس كلّ الكُتّاب زولا. ولا يُرفَع الظلم بذكريات الإدانة والاستحضار المريب لإحدى بَدَرات الشجاعة الأدبية، لأنّ هذه الشجاعة تصمت تماماً حين يتعلّق الأمر بالضحايا العرب في فلسطين وفي غيرها من أراضيهم.
* كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس