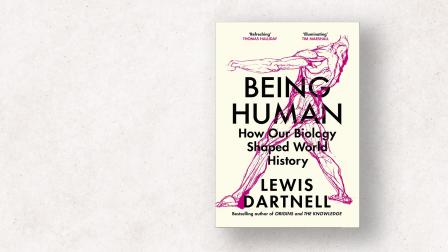توجد في التاريخ البشري أسماء لامعة سطعتْ بفكرها وتأثيرها الكبير على مسار الفهم البشري لنفسه وللطبيعة بشقَّيها الحيواني والنباتي وغيرهما. ولقد دأبَ المفكّرون على التخصّص، عن وعيٍ أو غيرِ وعيٍ، فتعمّقَت أفكارُهُم وفهمُهم لما يشغلُ عقولهم وخيالهم جُلَّ الوقت. لكن، توجدُ هناك قلّةٌ من المفكّرين عَبَرُوا حدود تخصّصهم، أو لنقُل اِهتمامهم الأوّل، وتعمّقوا فيما عبروا إليه، وأصبحَ لهم رأيٌ وشأنٌ أحياناً في تخصُّصات عدِّة.
لكنّ مَن يتأمّل مسيرة بعضِ المفكّرين الذين أرسوا قواعد الفكر البشري قديماً وحديثاً، من أمثال سقراط وأفلاطون اليونان، والخوارزمي وابن خلدون، وديكارت وجيامباتيستا فيكو، وديفيد هيوم وأدم سميث، وكانط ونيتشه وماركس، مروراً بالقرن العشرين، سيغموند فرويد، وإينشتاين، وميشيل فوكو، ونعوم تشومسكي وبرتراند راسل وإدوارد سعيد، وجون بول سارتر، وسيمون دو بوفوار، وفرانتز فانون، وجوديث بتلر وغيرِهم كثيرون، سيجدُ أنَّ لكلِّ واحدٍ من هؤلاء فكرة انطلقَ منها ليفتحَ أبواباً فكريّة كثيرة، وَيُغني مسيرة الفكر للإنسانية جمعاء.
فإذا ما تأمّلنا سيَر هؤلاء العباقرة وأفكارهم، فإنّ الفكرة التي أتى بها كلّ منهم وشاعت هي فكرة واحدة. وتكادُ تكونُ هذه الفكرة بسيطة وبديهيّة للوهلة الأُولى، لكنها في الحقيقة وازنة، جامعة مانعة كما يقولُ العرب، أيّ أنّ فيها غنى فكرياً ذا تأثير حاسم ومهمّ على شكل ومحتوى المجتمع الذي يتبنّاها. ولا أقصد هنا الفكرة العلمية، فتلكَ مسألة علمية لا بدَّ من تبنّيها بغضِّ النظر عن أصلِ صاحبها، ولكن الفلسفية. الفلسفة هنا هي عصارة الحياة المُثمرة، ووقودُ تجدّدها الضروري وديمومتها، وبلا فلسفة ذات قواعد وضوابط فكرية جدّية وسليمة، يصبحُ المجتمع شبه أعمى، تقوده عادات وتقاليد، كثيرٌ منها خارج عن إطار الوعي السليم المحسوب، المتّزن والقادر على تمييز الصحيح من الخطأ على أسس معرفية ومنطقية.
مدرستان منحتا الفكر شكلَيْه: الأفلاطونية والأرسطية
فإذا ما فكرنا في أفكار أفلاطون وسقراط، وهما من المعلّمين الأوائل للفكر الإنساني الحديث، بالرغم من أنهما عاشا قبل أكثر من ثلاثة ألاف سنة، فإن أفكارهما تأخذُ بُعداً يقعُ في صميم ما معنى أن نكونَ بشراً، نمتلكُ عقلاً ولغةً، وبالتالي الإمكانية للوعي والتعبير عن أنفسنا فلسفياً وعلمياً وعاطفياً... وهكذا، حين طرحَ أفلاطون فكرة أنَّ الأشياء ليست كما تبدو، بل هي ظلٌّ لما هي في الحقيقة، فهو يقولُ إنَّ هناك باطناً للأشياءِ، وهو شيءٌ كوني، هو لبُّ بنية التفكير البشري. والبحثُ في هكذا بنية في العقل والنفس البشرية، أيّ في ما هو كوني، هو أساس الفلسفة ومبتغاها، وأيضاً هو الطريقِ إلى فهم أعمق لما يشتركُ به البشر، وهذا أهمّ من الاختلافات الخارجية.
وهكذا، بهذه الفكرة يُرسي أفلاطون قواعد العقلانية في التاريخ البشري، أي مدرسة ما زالت مؤثّرة، حيثُ تمّ الإضافة إليها والإشارة إليها بشكلٍ لانهائي، بينما ذهب سقراط إلى أنّ التجربة هي عصب الحياة البشرية، التجربة التي تقعُ في قالبٍ بيئي معيَّن ويتمُّ من خلالها تصنيف الأشياء. وبهذا تمَّ التأسيس للمدرسة التجريبية، وهي مدرسة لا تُهمِل ظاهر الأشياء بل تأخذها على محمل الجدّ، كظواهر لها علاقة بالبيئة المحيطة بها، وتلكَ مدرسة مهمّة جدّاً في التاريخ البشري.
وهنا، إذا ما تقدّمنا للقرن العشرين، نجدُ مفكّرين، أمثال نعوم تشومكسي، يتبعون المدرسة الأفلاطونية، ويطوّرونها ويذهبون لأبعد الحدود في تبيان مضامينها. تصبحُ اللغة في هذا السياق عضواً بيولوجياً في دماغ الإنسان، وتصبحُ دراستها على هذا الأساس الكوني أهم من دراستها على أساسها الظاهر في بيئتها المحدَّدة. لكن إذا ما تطرّقنا لإدوارد سعيد، فإنّنا نجده أقرب إلى المدرسة الأرستقراطية، أي أنّه يُولي السياق والبيئة اِهتماماً من ناحية تأثيرهما على حياة الناس والسياسة التي تحكمهم، وأنماط الحياة الاِجتماعية...
إذاً، نحن أمام مدرستين أبديّتين لن يتوقّفَ الجدل بخصوص أيهما أكثرُ أهميّة، وأيهما أكثرُ إقناعاً. وطبعاً تتدخّل الأهواء البشرية في التأكيد على أهميّة مدرسة على أُخرى، وإنْ أخذَ هذا طابعاً ولغةً علميةً في كثيرٍ من الأحيان.
النظرُ إلى باطن الأشياء هو لبُّ بنية التفكير البشري
أنا أميل إلى أنََّ كلّاً من المدرستين مهمّ، وقد يبدو هذا هروباً من الاصطفاف. ولكن أرى أنَّ الكوني والخاص هما في لبَّ أن تكونَ بشراً واعياً، فلا يكفي أن تكونَ كونيّاً وتهملُ البيئة التي حولك، ولا يكفي أن تكونَ متقعّراً في بيئتكَ بلا أفقٍ كونيٍ مستنير. وقد يُقال الكثير هنا، ولكن أكتفي بهذا القدر.
ولنأخذ مثالاً آخر على موضوع الفكرة الواحدة والكلام الكثير. وهنا نستحضرُ ماركس وفرويد، وكلاهما قامتان عاليتان في تاريخ الفكر الإنساني المتشعّب. فلقد رأى ماركس أنّ الاقتصاد، أي الفكّر والترتيب الاقتصادي لأي أمّة، هو الذي يُحدّدُ شكل وهوية المجتمعات، أمّا الثقافة فهي تابع من توابع الاقتصاد، أي بنية دونية بالمقارنة مع الاقتصاد. ومن هنا فقد قضى الرجلُ حياته ليضعَ أُسس الاقتصاد الاشتراكي، الذي يقومُ على توزيعِ الثروات بين أفراد الشعب توزيعاً عادلاً، وَيَقضي على نظام الطبقات (البرجوازية، والطبقة العاملة) الذي تقومُ عليه وتكرّسه الرأسمالية. وهذه فكّرة واحدة، لكن ما أكثر الكلام - وطبعاً لا أقلّلُ من أهميته - الذي أخذتهُ هذه الفكّرة لتبيانها، وتبيان أسسها، وأبعادها ومضامينها ومستقبلها... هكذا كلام من ذهب، لأنّه يحتوي على المقدّمة والدليل، والتسلسل في الأفكار، وجمال التعبير وجزالة الألفاظ، وأيضاً القدرة على الإقناع والتأثير في مسار الفكّر الإنساني المتشعّب والطويل.
أمّا فكرة فرويد، فهي تأخذُ منحىً آخر لتركّز على البشر والبشرية من ناحية الجنس، حيثُ يبدو البشر أسرى ماضيهم الجنسي الذي يرزحُ تحتَ وطأة اللاوعي على وجه الخصوص. وتحدّدُ تلك الهوية الجنسية، إذا ما جاز التعبير، طبيعة البشر، ولأنّ البشر "رهائن" غرائزهم، فإنَّ هذه الغرائز هي التي تدمّرُ حضارتهم، لأنَّ الغرائز، خصوصاً عندما تُتَرجم بشكلٍ جمعي، هي أقوى من الحضارة.
الفكّرة هنا واحدة على أهميتها، والكلامُ كثيرٌ أيضاً على أهميته. ويبقى لنا أن نوضّحَ أكثر في فرصةٍ أُخرى أهميّة الكلام الكثير (المنتظم طبعاً) في عالم الفكر والتفكير.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن