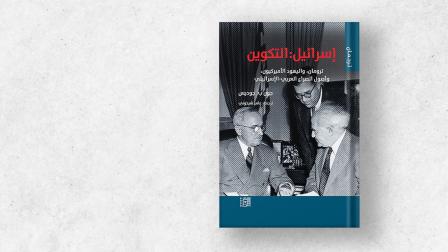تستعيد هذه الزاوية شخصية ثقافية عربية أو عالمية بمناسبة ذكرى ميلادها، في محاولة لإضاءة جوانب أخرى من شخصيتها أو من عوالمها الإبداعية. يصادف اليوم، السابع عشر من شباط/ فبراير، ذكرى ميلاد الكاتب المصري صالح مرسي (1929 -1996).
تقع شخصية رأفت الهجان في نفسي موقعاً عميقاً للغاية. هي أشبه بمرساة سفينة حين تنغرس في موضع، فهي تحدّد كيفية استقرارنا في الوجود. ظهرت كنهر يعبر طفولتي في مسلسل تلفزيوني تابعتُه بشغف قد تفسّره، وقتها، عدوى الشغف الذي كان يتيحُه زمن الفرجة الجماعية في التلفزيون. ولعلّ ذلك كان أوّلُ اختبار لمثل هذا الشعور ببناء علاقة نفسية مع تكوين فنّيٍ. فلما كبرتُ بقيتُ أسائل أسراره، وأتغذّى منه وأنا أعود إليه بوسائل شتّى وكأنني أجدّد ارتباطي بتلك المرساة التي أُلقيَت ذات يوم ولا تزال مكانها.
من ذلك اللقاء الأوّل البعيد، لم يبق لديّ اليوم سوى ذكرى الأثر اللذيذ للمشاهدة. لم يكن ذهن الطفل ليستوعب ما وراء ذلك الافتتان، من سياقات العمل وإحالاته التاريخية ورسائله وحسن إدارة الحكايات والتلوينات الفنية المختلفة من الموسيقى إلى التجسيد. وقبل كل شيء، ذلك البناء الدقيق للشخصية الرئيسية بما يتيح الالتقاء بها والانسياق في تيارها المائي. وتلك صنعة صالح مرسي التي لن أتبّين قيمتها إلا بقراءة "رأفت الهجان" نصاً.
أتى ذلك بعد عشر سنوات تقريباً من المشاهدة الأولى، وأنا في الخامسة عشرة من العمر تقريباً. ظهر رأفت الهجان أمامي مجدّداً في كتاب أزرق مهترئ الغلاف كان في مكتبة أسرية أثّثها لسنوات خالي رضا فرحات. العودة بالذاكرة إلى تلك المساءات لا يزال يبعث في نفسي ما يبعث الناقوس بالنُساك، إذا جاز لي أن أستعير عبارة أحمد شوقي. كنتُ أشغّل كاسيت الموسيقى التصويرية التي وضعها عمّار شريعي للعمل الدرامي، وأغطس في الكتاب على حساب الواجبات الدراسية وأي التزام آخر. أعرف اليوم أننا لا نقيم علاقة كهذه إلا مع عدد قليل من الكتب، ولذلك تتحوّل الأسفار التي لعبت هذا الدور إلى معالم في مسالك العمر.
لاحقاً، تفطّنتُ إلى أن رواية "رأفت الهجّان" ظهرت لتقطع حبلاً كان يربطني بشكل القراءة المحبّب الأول، والذي تُطربني فيه قراءة الألغاز البوليسية أكثر من أي شكل آخر من الكتب، بالتأكيد أكثر من مقترحات "الأدب الرفيع" التي بدأت المقرّرات الدراسية تفرضها علينا وكأنها تقصفنا بها في ذلك السن. قد لا ينتبه المدرّسون إلى التعسّف الذي يكمن في ذلك الانتقال الضروري، وأودّ لو أشير عليهم بالانتباه إلى الجسور التي يمكن أن تنقل الناشئة من بحيرة القراءات الأولى إلى المحيط الأوسع. بالنسبة إلي، تكوّن هذا الجسر من حجارة وجدتُها في نصوص صالح مرسي ونجيب محفوظ أساساً.
لم يأت رأفت الهجان كبطل جاهز بل بناه صالح مرسي من حاجيات الإنسان العربي
أكثرَ نضجاً، قادتني زيارات كثيرة إلى "رأفت الهجان" - مرئياً ومقروءاً - ولم تفلح المدارك التي نراكمها بمرور السنوات في خلخلة "الأسطورة" كما فعلت بعناصر أخرى فقدت طعمها تدريجياً ولعلّها اختفت. هناك سرّ وضعه مرسي في "رأفت الهجان"، شيء ما عنصرُه الحياة وفهم مكوّنات عميقة في الإنسان العربي.
لا يأتي رأفت الهجان كبطل جاهز، هو - بحسب التركيبة التي أنشأها مرسي انطلاقاً من ملف عملية في أدراج مكاتب جهاز المخابرات المصري - كائنٌ ملقى في الضياع العربي اصطفته الظروف كي يكون بطلاً، وهكذا بات مقولة مضادة لليأس المطبق الذي ينخر الذات العربية. نفس ذلك المسار الذي وضعه في عمل شبيه مع شخصية جمعة الشوان في "دموع في عيون وقحة". يؤدّي بنا الخطاب المرافق لهذه الشخصيات بأن أياً منا - نحن التائهون في شعاب التاريخ العربي المعاصر - يمكن أن يكون بطلاً، وأن مفهوم البطولة يدور في منطقة غير مرئية غالباً، ومن أدوار الفن أن يضيء هذه المنطقة من حين إلى آخر ليعبّر الجزء عن الكل.
حين ظهر على مستوى موسّع بفضل العمل التلفزيوني الذي أخرجه يحيى العلمي، وعُرضت أجزاؤه ما بين 1988 و1992، كانت هناك حاجة عربية ملحّة إلى بطل جامع. بدا الأمر وكأن الفن قد سارع ليؤدّي هذه المهمة بصناعة بطل، والشعوبُ العربية تدخل مرحلة اليأس بأن يأتي الواقعُ بمثله في شكل قائد سياسي أو مصلح اجتماعي. للأسف، من موقعنا اليوم، سيبدو الفن العربي بمختلف أشكاله وقد توقّف عن لعب دور شبيه لصالح أدوار أخرى، ربما كانعكاس طبيعي لمرحلة مختلفة أو عن عجز أن عن استشعار لأولويات أخرى.
في الحقيقة، لم تكن تلبية هذه الحاجة الشعبية لبطلٍ السببَ الوحيدَ الذي يفسّر نجاح مسلسل "رأفت الهجان". كان نقطة تقاطع مصالح كثيرة، منها حاجة النظام المصري وقتها لتنفيس خيبات كثيرة، واسترجاع أمجاد وطنية لم يعد من الممكن تجسيدها بمكوّنات واقعية. استند ذلك على حس وطنيّ موجود بالفعل لدى المشتغلين بالفن الدرامي ورغبتهم في إنجاز أعمال جدّية، ولذلك حين انفتحت خزائن جهاز المخابرات وجدت رغبة صادقة من الكتّاب للخوض في هذا التوجّه، لنجد مساهمات من بشير الديك وإبراهيم مسعود وفائز غالي، لكن صالح مرسي كان الأبرز ولم يأت ذلك من فراغ.
أتى إلى ملفات المخابرات انطلاقاً من تجربة في أدب البحر
إضافة إلى نجاح "رأفت الهجان"، صنعت أعمال مثل "الحفار" و"الصعود إلى الهاوية" و"دموع في عيون وقحة" علاقة ارتباط عضوية بين صالح مرسي وعالم المخابرات، وقد بدا بالتالي كاتباً متخصّصاً في هذا اللون الأدبي حصراً، لكن الأمر ليس كذلك إذا شئنا الدقة، فقد أتى مرسي من منطقة أخرى تماماً كان يمكن أن تكون واجهته الأدبية الرئيسية لولا الطلب - الرسمي والشعبي - على الكتابة ضمن أدب الجاسوسية، ثم إعادة إنتاج هذا الطلب مع نجاح الأعمال الأولى.
بدأ مرسي كاتباً من البحر، كان ثيمته الأثيرة في "زقاق السيد البلطي" و"البحار مُندي" وفي رواية بعنوان "البحر". وقد كتب عنه عن تجربة حيّة، حيث عمل في مهن بحرية في الإسكندرية قرابة سبع سنوات، وحين قرّر أن يخوض غمار التأليف كتب في "أدب البحر" وكأنه اخترعه، أي أنه لم يعتمد على خلفية معيارية جاهزة لكتابة هذا اللون، بل على شعور باستحقاق البحر أن يُفرد له فضاء خاص من فضاءات الكتابة.
في حديث تلفزيوني، أشار بوضوح إلى أن خلفياته كقارئ تفسّر ذهابه إلى كتابة أدب الجاسوسية، حيث نهل بشكل مبكّر من الأدب البوليسي، لكن هذه الخلفيات القرائية لا تفسّر اهتمامه بالبحر، والذي أتى من المعايشة والملاحظة. وهنا يجدر أن نلتفت إلى نجاح مرسي في تمرينين أدبيين مختلفين؛ الاستلهام من التجربة الذاتية كما في أدب البحر والاستناد إلى مادة وقائعية كما في أدب الجاسوسية، وكل هذه مواد خام ومنقطة انطلاق وإبحار لا غير. الفن، بعبارة أخرى، هو المسافة التي قطعها صالح مرسي برأفت الهجان، من ملف يرقد في أرشيف عمليات المخابرات المصرية إلى شخصية أدبية ودرامية باتت تسكن النفوس.
من الواضح أن مرسي قد استفاد من المرور بتجربة أدب البحر حين وصل لاحقاً إلى ملفات المخابرات فحوّلها إلى نصوص سردية، يظهر ذلك في "دموع في عيون وقحة"، وبشكل أكبر في "الحفار"، والذي يرافق تطوّر الخيط الدرامي لأحداثه تراكمٌ في المعرفة الجغرافية، بين بِحار العالم وموانئ ثلاث قارات، ما يجعل العمل أشبه بتذويب موسوعة في حكاية مثيرة.
في "الحفار"، لا يمكننا أن نطمئن - كما في "رأفت الهجان" - إلى الشكل التلفزيوني من العمل. علينا العودة إلى نص صالح مرسي نفسه، وإلا فقدنا روعة هذه الحكاية، فقد أتت المعالجة الدرامية التي ظهرت في الشاشة عام 1996 (إخراج وفيق وجدي عن سيناريو لبشير الديك) حاملة لكثير من الركاكة والشعبوية وإن حافظت على الموسوعية الجغرافية التي كانت موطن فتنة النص الأصلي، فقد جرى إقحام الكوميديا بشكل فج، كما تضمّن العمل نظرة استعلائية غير مبررة للبلدان الأفريقية التي تدور بعض فصول العملية على أرضها. بدا مسلسل "الحفار" عملاً جرى استسهال نجاحه لكونه يأتي بعد سنوات قليلة من "رأفت الهجان"، علماً أن ترتيب صدور العملين في كتابين معاكس لصدورهما كمسلسلين، وكان مرسي يؤكّد دائماً بأن جودة "الحفار" لا تقلّ عن جودة "رأفت الهجان".
حين يقول ذلك ينظر المؤلف إلى عمله من زاوية جهده في الكتابة، ويُهمل النصف الثاني الذي يصنع روعة العمل الفني، وهو ما يبقى للقارئ أن يضيفه. لم يكن في "الحفار" شخصية رئيسية يتماهى فيها القارئ أو المشاهد، إذ تمجّد الرواية الروحَ الجماعية للعمل الوطني، وهو أمر محمود ولكنه أقل فاعليةً فنية وتأثيرية من تركيز بؤرة العمل حول شخصية محورية، وهناك يجد المؤلف مساحة أوسع لنسج عالم حكائي مقنع أو التعمّق في تعقيدات شخصية الجاسوس.
مع تجربتَي أدب البحر أو أدب الجاسوسية، كان لصالح مرسي مغامرات تخييلية أخرى لا تجد حظّها كثيراً. في زياراتي لنصوص أخرى له، اكتشفتُ صنعته في بناء شخصية الصحافي في رواية "الكداب" (صدرت عام 1965 وتحوّلت إلى فيلم بذات العنوان في 1975)، بمهارات لا تقلّ عن مهارات تركيب شخصية الجاسوس، حيث يقترح حكاية انتحال صحافي لشخصية أخرى من أجل إظهار حقيقةٍ في عمل استقصائي ليكون اكتشافُ انتحاله سبباً في كسر كل ثقة بجهده الصحافي رغم نواياه السليمة، مقدّماً وعياً مبكّراً بقضايا حارقة تتعلّق بالعمل الصحافي وحدوده.
بمثل هذه الحبكات يجدّد صالح مرسي أسباب حضور أدبه في نفسي. معظمها تبدو أسباباً ذاتية، ولكني ألمس من حولي حضور فاعليته في الوجدان الجمعي، فلا يزال رأفت الهجان التعبيرة الثقافية الأعمق لمفهوم الوطنية بعد أكثر من ثلاثة عقود من التقائه بالجمهور الواسع، ولا تزال إلى اليوم تتجدّد مشاهداته وكأن الأمر يتعلّق بالعودة إلى أحد "مصادر الذات" في ثقافتنا العربية المعاصرة.
ليس معطى طبيعياً أن يفعل ذلك أدب الجاسوسية، فمن السهل أن يذهب هذا اللون الروائي نحو الترفيه والإثارة والغايات الربحية. من تلك المنطقة، نجح صالح مرسي في تصدير معنى عميق يلبّي حاجات كثيرة تثوي في نفوسنا فيما تفشل فنون أخرى في ذلك، خصوصاً في أيامنا حيث تنقطع الشعرة بين حاجيات المجتمعات والإنتاج الفني، وتلك من مآسي الثقافات في بعض اللحظات من تاريخها.