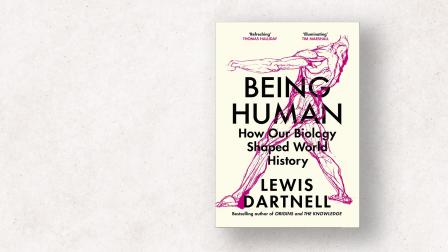ربّما يكون اليومُ الذي يمرّ من دون أخبار هدم وإزالة في مصر هو الحدث، لا العكس؛ إذ تكاد الأيام تتوالى بشكل روتيني بمثل هذه الأنباء. أحياء وشوارع قديمة، ومنازل كتّاب وشعراء، ومتاحف فنّية على طول البلاد وعرضها، يحوّم فوقها شبح علامة الإزالة.
وحيث يبدو الأمر، حسب التبرير الحكومي، مجرّد "سياسة تخطيطية - عمرانية"، لا تلقى دعواتُ الشجب والاستنكار وحفظ المباني التراثية، والتي يُطلقها مثقّفون وناشطون، أيّة استجابة. يحيى حقّي، ومحمود سامي البارودي، وعباس محمود العقّاد، وطه حسين (يُصادف هذا العامُ ذكرى رحيله الخمسين، وبدل أن يكون عاماً للتذكير بمُنجز صاحب "الأيام" والاحتفاء به، تحوّل إلى ملاحقة تخريبية لا تنتهي للمكان الذي دُفنَ فيه)، كلّ مدافن أو منازل هذه الأسماء المذكورة، والقائمة تطول طبعاً، معرّضة للهدم والإزالة.
لكنْ، ألا نستطيع أن نفتّش حقّاً عن حلّ لهذه الحُمّى؟ لا شكّ في أنّ هناك الكثير من المُبادرات والرؤى الجادّة في مصر، والتي يقدّمها معماريّون ومهندسون وناشطو بيئة، للوقوف في وجه هذا التوغّل الإسمنتي للكباري والأبراج وقطاع الخدمات المتعلّق بهما. لكن ماذا عن الأدب؟ ألا يبدو مرشّحاً أيضاً للخوض في هذه المسألة، خاصة أنّ ما يحدث يقرب من الأجواء الديستوبية التي يُمكن الاستثمار بها.
لا بدّ من عودة إلى الأدب لمواجهة هذا التوحّش وتفسيره
من جهة أُخرى، لا تفتح جريمة التلوّث البصري والعمراني مُتخيَّلاتِ الكتابة المستقبلية فحسب؛ بل تجعلُنا نفتّش عن نصوصٍ كُتبَت في هذا السياق، ما يكشف عن أنّ عمليات الهدم ذات تاريخ مُمتدٍّ في السياسات العمرانية بمصر. وفي هذا السياق، يمكن الإحالة إلى أحد النصوص التي تمثّلت هذا الخطر الذي يتهدّد ذاكرة الناس وجسد المدينة، وهو قصة قصيرة بعنوان "العميان"، وقّعها الكاتب والقاصّ والطبيب محمد المخزنجي (1950)، وضمّنها كتابه القصصي "البستان" الذي صدر عام 1992، وتاريخ الصدور يُضيء - أدبياً - منذ متى تأسّست هذه الإجراءات.
برز العمى بقوّة كثيمة أدبية وفنّية، وقد جرى الاحتيال عبر شخصية الأعمى لتقديم نصّ مليء بالرمزية الاجتماعية، كما صنع الجاحظ (ت: 255هـ) في كتابه "البُرصان والعُرجان والعُميان والحُولان"، والذي قدّم فيه نماذج بارزة عن هؤلاء. ومن المعروف لقارئ العربية ما تميّزت به أسماء كبشّار بن بُرد والمعرّي وصولاً إلى طه حسين. في المقابل نبّهت بعض المُعالجات الأدبية من تلك الفِطنة التي يتميّز بها العميان، وأنها تُخفي وراءها مقداراً ليس قليلاً من الدهاء والمراوغة. فأيّ من هذه الصفات ينطبق على ما كتبه صاحب "رشق السكين" (2007)؟
ينقسم "بستان" المخزنجي إلى ثلاثة أقسام: "فيزيقيات"، و"سيكولوجيات"، و"باراسيكولوجيات"، حيث خَتمت "العميان" القسم الأول منه، والذي ركّز فيه الكاتب على حضور الجسد وحواسه، أو حسب التعبير الكلاسيكي "آلاته". ولمّا كانت العين هي آلة الإبصار، فإنّ بُنيان هذه القصة كلّها مشيّدٌ عليها، حضوراً ثم غياباً... ونأتي على ذكر كلّ ما سبق، لعلّنا نستلهم التقنية التي استعانَ بها القاصّ، أو بطلُه الراوي في القصّة، للتخلّص من أولئك الذين أرادوا هَدْم المكتبة والحديقة، ليُشيِّدوا في مكانيهما جسوراً وأبراجاً، ممّا نراه ونُعاينه في بلداننا اليوم.
تبدأ القصة بمقهىً لا يخلو من الغموض، كلّ مرتاديه هُم من العُميان، وقد نسّب هؤلاء المحيطَ إليهم ولم يقتصروا على المقهى، فهناك أيضاً "ساحة العميان"، و"محطة سرفيس العُمي"، وغير ذلك. كما لا تغلب على طباعهم المسكنة، بل هم منهمكون - رغم ظُلمتهم - بلعب الشطرنج والدومينو، و"إنْ أمسكوا بكَ لفتكوا بكَ شرَّ الفتك". لهؤلاء تاريخ، وعَماهُم عقوبة رادعة، لا خِلقة أصيلة. وفي يوم غير بعيد كانوا مُبصرين، ومتنفّذين في مقاماتهم السُّلطوية، هُم من النوع الذي يبيع ويشتري المُناقصات الوهمية، يغزو وينهب ممتلكات الناس، ويحطّم ذكرياتهم، ولا تسلم منهم حتى الطيور في وكناتها. وصحيح أن القصة في تناصّها التراثي المباشر مع ما جاء في "سورة الفيل"، وما فعلته الطير الأبابيل بجيش من الغُزاة، تُساير الأمثولة الأخلاقية في مؤدّياتها؛ إلّا أنها التقاطة واضحة لما يمثّله الاعتداء بالهدم؛ إنه ضربٌ من سيكولوجيا الغزو المُعشِّشة في النفس البشرية، فما المقاومة المرجوّة والناجعة ضدّها؟
يتلاشى العامّ في مدننا ويفيض الاستهلاكي والمدفوع
المكتبة والحديقة العامّتان والمجّانيتان هُما علامتان من علامات المَدَنية الحديثة، ومُستراحان يدلّان على مدى التحضّر الإنساني (قبل أن تفرّخ الكافيتريات والمطاعم في مُدننا). وهُما كانتا الهدف الأساسي لمجموعة من المتنفّذين والمسؤولين، حيث حوّلوا الأُولى إلى كومة أنقاض، على مرأى من أبناء المدينة. قبل أن يتوجّهوا إلى شجرات الثانية ويقتلعوها واحدة واحدة، وصولاً إلى الأكبر من بينها، تلك التي احتمى بها عبد الله النديم، خطيب الثورة العُرابية، وصاحب "تاريخ مصر في هذا العصر"، الشجرة نفسها التي حفظت تاريخ ثورة 1919، كما لحّن تحت غصونها السنباطي بعضاً من أُغنيات "كوكب الشرق"، وما من عاشق صغير ولا كبير إلّا وحفر اسم محبوبته عليها مع قلبٍ مرشوق بسهم، هي شجرة "لا تخلعُ عن لحائها رقائق الذكرى ولا التواريخ أبداً".
هناك مشهد مسرحيّ حقّاً يصوّره المخزنجي دفاعاً عن الشجرة، تجمُّعٌ كبير من العشّاق والمُنتمِين بدأوا بالتناقص شيئاً فشيئاً، مع تحطيم عمّال المحافظة كلّ الشجرات الصغيرة المحيطة بها. يدبّ اليأس وقلّة الحيلة في نفوس الناس عندما يرون دولتهم تُعمِل آلاتها في خزّان ذكرياتهم ولا تبالي. يُتابع الكاتب بنفَس تراجيدي مُتصاعد، فينقل زمجرة البلدوزرات والأوناش الهاجمة - كالأفيال تماماً - واصطكاك المناشير بلا رحمة، في مأوى الكروانات الرمادية والواق الأبيض وصقور الغروب. فزَعٌ يلفُّ المكان، وطيورٌ تلوذُ بالشرفات وأسلاك الكهرباء بدل الأغصان، قبل أن "يرتطم زمنٌ كامل بسُور الكورنيش".
عند هذه اللحظة، ومع انكفاء الناس وتخاذلهم في الدفاع عن ذاكرتهم العامّة، تتسيّد الطيور فعل البطولة، وتشتعل السماء بتوحّشها: "صَدْحٌ وشقشقاتٌ وهديلٌ ونعيب وضربات مناقير"، إنه شيءٌ له اسمٌ واحد "مطر الدمّ". راحت بعدها المناقير تتصوّب نحو عيون المهاجمين. العيون فقط. انقلبت الآية، وبدأت الطيور تثأر لنفسها بنفسها ممّن هاجمها، ولم تترك منهم مُبصراً واحداً، إلّا وحشَرته في هذا المقهى الذي أصبح خاصاً بهؤلاء العميان... قبل أن يتكاثر من حولهم، لاحقاً، عميانٌ آخرون مثلُهم يقومون على خدمتهم، والجميع مُنطوٍ على رعب من أصوات الرفرفة والنقر والشقشقة.
هل سيأتي يوم يُفرِدُ فيه المصريون كتائبَ من العصافير تتولّى حراسة القرّافات والمدافن ومنازل الأدباء؟ فتقف مجموعة منهم عند مدفن يحيى حقّي، وأُخرى عند كتف طه حُسين؟ تترصّد بغريزتها علامات الإزالة وما تمثّله من بشاعة، ثم تنقضّ على أولئك المخطّطين والمنفّذين "العباقرة"، وتخلّص أحداقهم بمناقيرها. تنقَضُّ كمطر الدّم تماماً. عندها قد نحتاج إلى مقهىً أوسع بكثير من ذلك الذي كتب عنه المخزنجي، بل مقاهٍ، أو ربّما "مُولات" كبيرة نحشر فيها طبقة جديدة من العُميان.