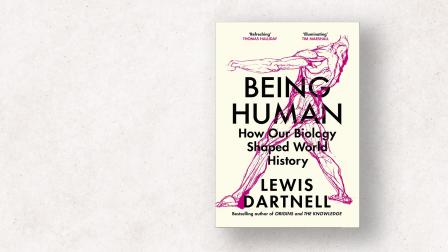تُبرّر "إسرائيل" عدوانها المُتكرّر على فلسطين بأسطورة سياسية - دينية أُطلق عليها الصهيونية. وهدفُها التشريع لاحتلال أرض فلسطين، وهو ما وضَع العالَم بأسره أمام واقع محتوم، تضخّمت أبعادُه حتى صار من المحظور تحليلُها، ثم تزايدت أكثر حتى غدت تبريرًا أخلاقيًّا للقتل والتهجير. وهذه العُقدة بالذات هي التي عاد إليها المؤرّخ السويسري جاك بو في كتابه الأخير "فلسطين (1917 - 1949): وجوه استعمار إحلالي"، الصادر حديثًا عن "دار لارمتان" الفرنسية.
يُذكّر الكاتب بأنّ الاحتلال الإسرائيلي زرع بذرة مستقبله عندما اغتصب، تحت الانتداب البريطاني، أراضي هي مُلكٌ لشعب آخر، والأدهى من ذلك أنّ هذا التقسيم حصل بين اليهود الذين كانوا أقلّية تعيش على هذه الأرض وبين العرب الذين كانوا تحت سلطة "قضاء" عثماني ضمن ولاية الشام. وسيظل هذا التقسيم مرسومًا عبر جغرافيا الأرض والملّة ومحكومًا بها إلى يومنا. إلّا أنّ ما أجّج هذه الفوضى الجغرا-سياسية هو حصول "إسرائيل"، سنة 1948، على الآليات الإدارية والاقتصادية لحُكم هذه المنطقة و"وراثتها" عن بريطانيا التي "فوّضت" لها السيطرة الكلّية على الحجر والبشر.
قسّم المؤرّخ السويسري كتابه إلى خمسة أقسام: عنون الأوّل منها "الإجابة الوطنية عن المسألة الصهيونية"؛ وفيه عاد إلى الفروق الجوهرية بين مفهومَي: الهوية اليهودية والصهيونية، وعالج نقاط الاختلاف والائتلاف بينهما، بعد وضعهما ضمن ما سمّاه "الإغراء الغربي"، أي التشجيع المالي والدبلوماسي اللامشروط الذي حظي به الكيان الجديد.
إدانةٌ للموقف الغربي المنحاز إلى الرواية الصهيونية
وخصّص الفصل الثاني لمعالجة ما أطلق عليه "النموذج الشعبي" القائم على مقولة "نحن شعب: شعبٌ واحدٌ"، مُستعرضًا أصناف القراءات الثقافية والإثنية والتاريخية لمفهوم "العِرق"، ثمّ مساءلته نقديًّا. في الفصل التالي، استرجع الكاتب ظروف قيام الاستعمار في فلسطين إثر "وعد بلفور"، الذي "أهدى" ظُلمًا أرض شعب لآخر، وما أسفر عنه ذلك من تمدّد سياسي ومن مقاومة اندلعت منذ السنوات الأُولى للاحتلال. وفي الرابع، فضح العنف الاستعماري وعنف الدولة المؤسَّسي. وفي الفصل الأخير، حلّل بعض المفاتيح الأُخرى مثل نكبة عام 1948 واللجوء.
وهكذا، فالكتاب توثيق دقيق للملابسات التاريخية، بعناصرها الواقعية والأيديولوجية، التي تقف وراء قيام كيان "إسرائيل" على أنقاض قضاء عثمانيّ، شعبُه عربيّ مُسلم في أغلبيته مع أقلّية مسيحية عريقة يعود حضورها إلى ما قبل المسيح، وأُخرى يهودية، تتعايش جميعُها في وئام، حتى لعبت المخابرات الخارجية، البريطانية والفرنسية، دورًا خبيثًا (لا وصفَ أفضل من هذا) في تحقيق الحُلم الصهيوني، وخلق كيان سلطوي يتوافق مع عقائد ألفيّة وأساطير تلمودية، جذورها في ثنايا التاريخ والمخيال.
وتغطّي مقاربة جاك بو الأحداث السياسية التي جرت في أرض الواقع، علاوةً على تحليل الخطاب العرقي القائم على الاعتقاد بوجود اليهودية ديانةً والصهيونية أيديولوجيا للاستعمار. وأمّا المفهوم الذي يخترق هذه الدراسة فهو مبدأ "الاستبدال" (remplacement)، إلّا أننا نُفضّل ترجمَته بمصطلح "الطمس"، الذي يعني محو جميع الآثار الفلسطينية الأصلية وجعلها تندثر عن وجه الأرض، وتعويضها بغيرها من المباني والأسماء والمَرافق والمشاهد العمرانية المستحدثة التي تُضيّع إلى الأبد الهوية الأصلية، فلا يبقى من شاهد عليها سوى الحسرة والألم. ويرى بو أنّه بقدر ما يستمرّ فعل الطّمس، بقدر ما تلتهب المقاومة وتقوى شوكتها وتثور من تحت الرماد بشكل أقوى. وما حصل أخيرًا مع حركة حماس أبلغ آية على أنّ المقاومة لا تفتر، وإن ظنّ البعض أنّ القضاء على قادتها كفيلٌ بإبادتها تمامًا.
وليس الهدف الذي وضعه المؤرّخ علميًّا فحسب، أي مجرّد عرضٍ جافّ لبعض وقائع التاريخ، بل هو أيضًا أخلاقي وسياسي، لأنّه سعى إلى إدانة جرائم الاحتلال ضدّ الإنسانيّة التي شهدها القرن الماضي وما تزال مستمرّة إلى اليوم. وهو بذلك يُضيف جهوده إلى جهود قلّة قليلة من مثقّفي أوروبا تعمل على كشف النقاب عن فظاعات الاستعمار، وما ألحقه من ترويع ضدّ شعب بذاكرته وأرضه وجسده المكلوم. كما أنه يدين العجز الغربي الذي يمنع الساسة والمثقّفين من رؤية هذه القضيّة بوضوح ويدفعهم إلى التخلّي عن مقاومة الظلم.
ويقوده ذلك إلى سؤال ثانٍ: لماذا عجزت أجيالٌ كاملة من المثقّفين والمؤرّخين عن الالتزام بهذه القضية، رغم أنّهم يرون رأيَ العين ما يعانيه الفلسطينيون من الظلم والطمس والإجحاف؟ ولماذا لا يلجأ هؤلاء إلى الترسانة القانونية والعسكرية وحتى الثقافية التي بحوزتهم حتى يفضحوا هذه الممارسات الاستعمارية، التي لا يمكن أن يكون لها اسم آخر سوى الاحتلال، وإن تفنّن صانعو الأيديولوجيات والخطابات في التنظير لها وتجميلها، مع شيطنة كلّ كفاحٍ ضدّها واعتباره "إرهابًا" من أجل تدميره.
الكتاب بمضمونه ونفَسه النضالي أمرٌ نادر في المشهد الفرنسي
بهذا الكتاب، ينتقد بو هشاشة الموقف الأوروبي وتهافته، لأنّه يقوم على إحساسٍ عميق بالذنب، نظرًا لما ألحقته القرون المسيحية في أوروبا من اضطهاد لليهود، ثم ما ارتكبه النازيّون في حقّهم، فكأنهم بهذه السياسة يكفّرون عن كبائرهم. ويتساءل الكاتب (ونتساءل معه): لماذا يُفرَض على الفلسطينيّين أن يدفعوا ثمن تلك الجرائم المُنكرة؟ ولماذا يداوون فظاعةً بأُخرى أشدّ منها إيلامًا تقوم على تهجير شعب بأكمله و"تعويضه"؟ ثم لماذا يتّخذ مواطنو أوروبا مثل هذه المواقف السلبية في حين أنهم لم يولدوا تحت نظام نازي؟ ولماذا عليهم أن يتحمّلوا أخطاء حكومات أجدادهم السابقة ويساندوا الموقف الصهيوني على حساب أصحاب الأرض الفلسطينيّين؟
مجرَّد صدور هذا الكتاب، وكذا مضمونُه ونفَسه النضالي أمرٌ نادر في المشهد الثقافي بفرنسا اليوم، إلّا أنّه لم ولن يلقَ أيّ صدًى حقيقي في أوساط المثقّفين ولا لدى وسائل الإعلام أو منصّات التواصل الاجتماعي بحُكم الحصار الذي يُمارَس على كلّ صوت يعارض الجوقة العامّة الساعية لتكريس السرديّة الصهيونية وخنق الرؤية الفلسطينيّة للنضال. وللعلم، فحتى دار النشر التي طبعت هذا الكتاب، ورغم جهودها الحثيثة في استقطاب الجامعيّين، تظلّ هامشيّة مقارنة مع دور أُخرى.
وبسبب ذلك الحصار، لم يُدعَ الكاتب إلى أيّ برنامج ثقافي، في القنوات التلفزيونية والإذاعية، على كثرتها، حيث يُستضاف الجميع إلّا مناصري القضية الفلسطينية، حتى لتظلّ مثل هذه الكتب أشبه بصرخة في الوادي الفرنسي.
* كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس
بطاقة
Jacques Pous مؤرَّخ سويسري من مواليد تولوز الفرنسية. عارض في شبابه الاستعمار الفرنسي للجزائر. اشتغل مدرّسًا في "مركز عيسات إيدير" بتونس، والذي أُنشئ للتكفّل بالأطفال الجزائريّين الأيتام بعد الثورة التحريرية، ثمّ تفرّغ للتدريس عدّة بلدان عربية؛ من بينها الجزائر والسودان وفلسطين، قبل أن يعمل أستاذًا في مادّتَي التاريخ والفلسفة في سويسرا. وقد خصّص غالبية كتبه لنقد الاستعمار في الجزائر وفلسطين.