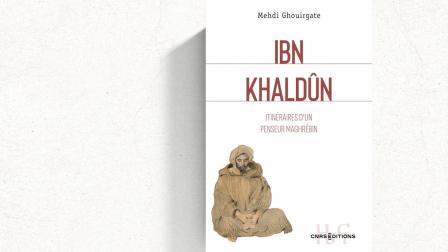ننشر على حلقات رواية "نصّ اللاجئ"، والتي لم تُنشر في كتاب، وهي من أهم أعمال الشاعر والروائي والناقد الراحل محمد الأسعد الذي غادر عالمنا في أيلول/ سبتمبر 2021، وكان من طليعة كتّاب القسم الثقافي في "العربي الجديد"، وأحد أبرز كتّاب فلسطين والعالم العربي.
طوال عامين فُرض علينا حظرُ التجوال خارج المعسكر البريطاني الذي يُطلق عليه الآن اسم "معسكر الشعيبة". حول هذا المعسكر كانت تنتشر آنذاك معسكراتٌ أُخرى أهمّها معسكرٌ لـ"سلاح الجوّ الملكي البريطاني" (RAF). وهذا الاسم الأخير كان أكثر الأسماء التي تداولها اللاجئون بينهم وسط الصحراء المُحيطة بهم، لأنّه المعسكر الوحيد الذي سُمح لبعضهم بالعمل فيه سائقي شاحناتٍ أو خدم.
أذكرُ أن الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بالمعسكر على هيئة لفّاتٍ هائلة الارتفاع كانت أكبر من المعتاد، ولا يعيدها إلى ذاكرتي إلّا مشهدُ الأسلاك التي أحاط بها موسوليني الصحراء الليبية لمحاصرة عمر المختار وصحبه في العشرينيات.
ربما كان حجم الأسلاك هائلاً بسبب حجمي الصغير وأنا أمرّ بجانبها وأنظر إلى الخلاء الشاسع وراءها. ومع ذلك لم تفُتني ملاحظة فجواتٍ في هذه اللفّات تخترقها ألواحٌ خشبية يضعها اللاجئون ليتمكّنوا من المرور بسلام... فأين كانوا يذهبون؟ من سُمح له بالعمل في المعسكر البريطاني كانت البوّابة طريقه، أمّا الآخرون، فكانوا يمضون إلى أقرب قرية وهي الزبير، ليعملوا باعةً متجوّلين في أزقّتها التي لم تتغيّر منذ العصر الأموي، وليعودوا خلسةً مع المساء.
كانت المساكنُ مهاجعَ الجنود المهجورة، وقد تقاسمتها العائلاتُ بأن وضعت خرقاً باليةً على حبال تفصل بين عائلة وأُخرى. وكان المطبخُ مركزياً. نستيقظ نحن الصغار مبكّرين ونحمل إليه أوعية ونعود بالحساء لإفطارِ العائلة، حساء نوع من الحبوب يدعى"الماش" أخضرَ اللون، وكان يدهشني أنه ينمو بكثافة حين أدفنه في التراب.
في هذا المعتقل ذي الطرقات، ومهاجع الجنود، وبركة السباحة والسينما (أحيانا كانوا يعرضون على اللاجئين مشاهدَ من الحرب الكوريّة ونشرات أخبار مماثلة أسبوعياً في الهواء الطلق) عيّنوا لأطفال اللاجئين مدرّساتٍ من بينهم، وأشهرهن كانت رفيقة الخياطة ذات الأصابع النحيلة والطويلة، التي عملت كمساعدة للمدير العراقي الزائر بين فترة وأُخرى. وكان هذا المديرُ يصرّ على أن التعليم الشفهي أفضل أنواع التعليم كما يبدو، لأنه جاء بالكتب مُكرَهاً في ما بعد بسبب ضغط اللاجئين الذين كانوا فلّاحين بالفعل، إلاّ أنهم كانوا قادرين على الربط بين وجود المدرسة ووجود الكتاب.
وهكذا بدأنا نتعلّم الأبجدية بكتاب "القراءة الخلدونية" فرحين رغم تعليق المدير الغامض حين سلّمني الكتب قائلا: "لولا عيون أبيك... لما رأيتَ هذه الكتب..." فجعلني أشعرُ بالذنب كلّما فتحتُ كتاباً لسببٍ لا أدريه.
كان بعض اللاجئين يمضون إلى الزبير ليعملوا في أزقّتها خلسة
ذاكرة هذا المعسكر هي المكان الذي استيقظتُ فيه مبكّراً. وما تزال أسئلةُ البداية فيه تراودني. فلماذا كانت الكتبُ محرّمةً إلى هذه الدرجة؟ ولماذا شعرتُ أنّ في كلمات المدير كراهيةً مكبوتة؟ ولماذا حين دخل أحد الجنود العراقيين مأوى أحد اللاجئين وشاهد صورة الحاج أمين الحسيني معلّقة على الجدار سأله لماذا يعلّق صورة هذا الخائن؟
كان لمعسكر "الاعتقال" هذا مراراتُه بالتأكيد، مراراتٌ أكبر من سنّي آنذاك، إلاّ أنني تشرّبتُها بطريقٍ غير مباشر في شبه الصمت الدائم الذي عاشه أهلي. الأصدقاءُ الأكبر سنّاً، والذين مرّوا به واعين، وكتبوا قصائدَ وقصصاً فيما بعد، أسقطوه من ذاكراتهم. وهو أمرٌ ظلّ يدهشني حتى وقت قريب، أي إلى أن اكتشفتُ سرَّ هذا الطمس الذاتي لجزءٍ من الذاكرة، وإقامةِ أبنيةٍ فوقها حجارتها استعاراتٌ وتعبيرات لغوية فارغة: إنه محو الشخصية لسانياً وعاطفياً.
حين انتقلنا، أو سُمح لنا بالانتقال، إلى مدينة البصرة ذاتها في العام 1952، مررتُ بأوّل تجربةِ اشتباكٍ ألسنية في هذا العالم الغريب. وهي تجربةٌ مرّ بها كلُّ لاجئ مع اختلافٍ في النتيجة وردّ الفعل.
كانت الهواجس والوساوس كثيرة، وأكثرها وُلد في معسكرِ الاعتقال ذاك. فقد شاعت بين اللّاجئين قصّة اعتقال يهوديّ أمسكه الحرسُ وهو يحاول تسميم خزّان المياه الوحيد في المعسكر. وستدفعنا هذه القصة إلى رفض قبول حلوى حاول يهوديٌّ عجوز مبتسم تقديمها لنا نحن الصغار أمام المعبد اليهودي المهجور المجاور للتوراة. وشاعت أقاصيصُ عن أشخاصٍ زارتهم في الليل أشباحُ القتلى العثمانيّين الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى، بمعركةٍ كبيرة قرب هذا المعسكر.
وكان استنكارُ الأمّ تزويجَ فلسطينيّ ابنته من عراقي يبذرُ في نفسي البذرة الأولى للشعور بالاختلاف والتميّز. وستحتقر أمي شجاراً بين اللّاجئين على حصصِ أكياس السكّر والطحين، وترى فيه عاراً وأيّ عار. وسيولّدُ هذا في النفس إعلاءً لقيمٍ تتجاوز سقط المتاع... واعتزازاً بما هو أكثر قيمة من السكّر والطحين.
تحت ظلِّ هذه الوساوس والمخاوف، ونموّ الإحساس بالاختلاف أمام العالم الخارجي الغريب، أرسلني أهلي في الأيّام الأولى من إقامتنا في بيتٍ كبير يعلو سوقاً مكتظاً بالباعة لأشتري ملح الليمون، ووقف الصغيرُ أمام صاحب البقالة طالباً ملح الليمون. وتحيّرَ الرجل الذي لم يفهم معنى هذه الكلمة، واستولى عليه فضولُ تأملِ هذا الصغير الغريب، فبدأ يعرض عليه أنواعاً من الأشياء: حلوى وأمشاط ومقصّات، والصغيرُ يهز رأسَه رافضاً. وفجأة احتشد المكان بعددٍ من العمالقة، وكلُّ واحد منهم يحاول أن يفهم ما يريده الصغير، أو يحاول بالأحرى معرفة "ما هو" هذا الصغير الضئيل الحائر بينهم، لا يفهم ما يقولون ولا يفهمون ما يقول. وأخيراً اكتشف أحدهم المقصود بكلمة ملح الليمون فهتف بصاحب البقالة أنه يريد نيموندوزي. وعرفتُ في ما بعد أن هذه الكلمة التركية التي تعني ترجمتها الحرفية ملح الليمون هي المقابل العراقي للفظَتي.
كانت البصرةُ في الخمسينيات ما تزال قريبةً من مناخها العثماني، وكانت الألفاظ التركية ما تزال طرّيةً إلى حدّ كبير. وحتى في الستينيات، كان هنالك بيتٌ على الأقل، يسكنه أحد أبناء العشائر القادمين للدراسة في ضيافة عجوز من معارف عشيرته، تحتفظ جدرانُ غرفهِ بصورِ ضبّاطٍ أتراك بشواربهم الضخمة وطرابيشهم الحمراء، وتروي إحدى لوحاته معركة من معارك الجيش التركي.
هذا الاشتباك اللساني الأوّل، والذي سيجبرني على استخدام كلمة نيموندوزي، وآلاف الكلمات العراقية المتنوعة الأصول مابين سومرية وأكدية ونجدية، لم يكن يسحق لهجتي ولساني فقط، بل وتجربتي أيضاً، وقدراتي التعبيرية*. لم يكن المحرَّمُ كما تعلّمتُ في ما بعد نطقَ اللفظ الفلسطيني الذي يرميك بعيداً ويُفردك وسط هذا العالم الغريب، بل الكشف عن هويّتك كلاجئ، وهذا هو السببُ، كما أعتقد، الذي جعل الكاتب والشاعر الفلسطيني يتجنّب كتابة أو نطق ما يشي بأنه "لاجئ" في هذا المكان من العالم. ومن هنا سقط من وعيه الكتابي واللفظي كلّ ما هو خاصٌّ ومتميِّز.
أحد أصدقائنا، وكان يدرس اللغة الإنكليزية في "معهد اللّغات" في بغداد، كان يبدي ازدراءه لوثيقةِ السفر التي تحمل اسم اللاجئين، بقوله: ?What is this? a travel document. والحقيقة أن هذا الازدراء كان تعبيراً عن كراهية النفس بالدرجة الأولى، فهذا الصديق كان يصاب بالرعب حين نزوره في المعهد، ويتحاشى أن يحدّثنا بلهجته الفلسطينية مُصّراً على اصطناع اللهجة العراقية؛ خشية أن ينكشف أمرُه بين زملائه ويُقبض عليه متلبساً بجريمة كونه "أحد اللاجئين". هذا الصديق سيذهب إلى السعودية في ما بعد وينخرط في سلك التعليم ويتزوّج، وأصادفه بعد سنوات طويلة وهو يشكو من مرض في القلب. كان يأتي صيفاً لزيارة أمه وإخوته أحياناً، وحين سألتُ عنه ذات يوم قيل إنه انتقل إلى رحمة اللــه... وما الجدوى من ذكر اسمه؟
سيتعلّلُ بعض اللّاجئين، في ما بعد، بالعروبة والهوية العربية، وسيكتفي بعضهم بإخفاءِ جريمةِ كونهِ "لاجئاً" بالغرق في اللهجة العراقية وطقوس شرب العرق العراقي الشهير، وسيوغل آخرون عميقاً في الأحياء العراقية، فيتزوّجون ويزوّجون ويغيّرون أزياءَهم، وكلُّ ذلك طلباً لقبول هذا العالم الغريب لهم.
كانت البصرةُ في الخمسينيات ما تزال قريبةً من مناخها العثماني
لم تكن البصرةُ عالماً ضاغطاً على اللسانِ وخصوصيةِ التجربة فقط، بل كانت مكاناً لتجاربَ عزلٍ أشدّ مرارةً، أقلّها الإرهاب الذي تعرّض له الفلسطيني، تجاربَ لم يتحدّث عنها أحدٌ حتى هذه اللحظة، بمن فيهم الصديق الشاعر خالد علي مصطفى الأكبر سنّاً مني، والذي عاش هذه التجارب معنا نحن الصغار، ولكن قصائده المطوّلة المصقولة والشبيهة بعربات قطارٍ متماثلة خلَتْ من ملامح ملموسة لحياةِ اللاجئ، أو المعادل الموضوعي لكلّ ذلك الرعب والخوف والإذلال في تلك الأيام. صحيحٌ أن الانتماء إلى الكلّ العربي يمنح اللاجئَ تعويضاً، ولكنه لا يمنحه الملموسَ الإنساني لما هو عليه واقعياً؛ إنه يمنحه وجوداً وهمياً وملموساتٍ أُخرى.
تتميّز عدّة شعوبٍ برفضِ الأجنبي وعدم التسامح مع ملامحه الخاصة، وتعمل جاهدة على فرض لسانها ووجدانها وتجاربها عليه. وكلُّ ذلك بفعلٍ بسيط غير مباشر: إنها تشعره بغربته وشذوذه في كلِّ لحظةٍ حين ترفض فهم لهجته أو التعامل معها. ولكنّ الأخطر هو جعله يحسّ أن مجرّد كونه غريباً لهو جريمة يجب أن يخفيها. وكان الأمرُ أقسى بالنسبة لنا، لأن الجريمة التي كان علينا أن نخفيها هي أننا من اللاجئين، وهذا نرتكبه بمجرّد وجودنا: وجود اللاجئ الذي أُعطي لنا بالاقتلاع من البيت والأرض أوّلاً، ثم بتسميتنا من قِبل هذا العالم الغريب. لكن هذه اللفظة ليست شتيمةً فقط، بل هي مما يحط ّ وينتقص من قدرِ الإنسان، وعليه أن يتقبّلها، أي يقبل بأن قدره منتقص ومنحطٌّ.
في هذه المتاهة واجَهَنا الفضولُ أوّلاً: شراسة الأطفال العراقيين في المدرسة. كنّا في المدرسة معاً، وأجد نفسي مع مجموعة صغيرة من اللّاجئين وقد أُلجئنا إلى جدارٍ، وأمامنا متراسٌ من الحصى، وفي الجانب الآخر أطفال المدرسة كلّها، وجوهٌ بعدد النجوم. وكنّا نشتبك معهم في معركةٍ سلاحُها الحصى؛ إنه متراسنا الأول الذي وجدنا أنفسنا وراءه.
بعد أيام قرّرت إدارةُ المدرسة تشتيتَ هذه "العصابة" العنيدة من اللاجئين، وتوزيع أطفالها على عدّةِ مدارس. كنتُ حين أشكو للأستاذ اعتداءَ طالب عليّ لا أستطيع أن أُفهمه ما أعني إلّا بالحديث بالفصحى، كأن أقول له: "ضربني على أنفي" لأنني لم أكن أعرف ما يعنيه الأنف باللهجة العراقية. وكان الأستاذ يتجاهل الشكوى... ويتركني لحيرتي... ربّما لأنّه لا يفهم الفصحى كما كنت أظنّ... لأنها لغتي.
وتمّ توزيعنا. فكان نصيبي مع اثنين آخرين مدرسة نائية تقع شرقيّ البصرة بين النخيل (ما زلت أذكر أن اسمها كان الخليل بن أحمد. وكنت أتساءلُ عن صلة أستاذ اللغة أحمد بهذا الاسم). وواجهنا الفضولُ منذ اليوم الأول، حين خرجنا من غرفة المدير بعد تسليم أوراق الانتقال، وجدنا أمامنا حشداً من الطلبة المنتظرين، ما لبثوا أن فتحوا لنا ممرّاً صغيراً بينهم لنسير فيه. كان الكلُّ على الجانبين يتلهّف لمعرفة ما هو هذا "اللاجئ الفلسطيني"، وأيّ كائن هو، وما شكله. وأتذكّر كيف كان الطلبة الأطول قامةً يمدّون أعناقهم فوق الحشد ليتطلّعوا إلى الصغار اللّاجئين وهم يسيرون في الممرّ الضيّق. كانت الإشاعة المنتشرة في البصرة هي أن للاّجئين ذيول قردة!
دبّرت الحكومة الملكية حريق الصرائف بهدف إجلاء الريفيّين عن البصرة
وجاءت عاصفة الإرهاب بعد ذلك، بعــد الفضول والعزل. كنا قد انتقلنا من منطقة السوق الموحل إلى "توراتَين" تقــابل إحداهما الأُخرى في زقاقٍ، ويلاصق الأوسع بينهما معبدٌ يهودي مهجور. و بدأت تحدثُ حرائقُ متفرّقة تندلع في الصرائف فجأة. والصرائف هذه مساكن ريفية عراقية، جدرانها وسقوفها من حزم قصب ينمو في منطقة الأهوار. وقيل آنذاك أن هذه الحرائق كانت تندلع فجأةً وكأنما من دون فعلِ فاعل. وسرعان ما انطلقت الشائعةُ ُالكبيرة: أنّ مشعلي الحرائق هم اللاجئون. وحوصر هؤلاء كلٌّ في توراته وفي جسده، ومن كان يتصادف مروره في منطقة الصرائف لسببٍ مـا لم يكن يخرج حيّاً.
هذه الصرائفُ أقامها الريفيون العراقيون حول البصرة، عمادها طينُ الأرض وقصبها، وكلّهم مهاجرٌ من الأرياف. كانت البصرة آنذاك تعني عدّة أشياء: شركة النفط وشركة التمور وشركة الموانئ. وهي مؤسّسات ثلاث تعني بالنسبة للفقراء فُرصَ العمل والثراء. وهكذا تضخّمت الصرائفُ وتحوّلت إلى مدنٍ كاملة تطوّق البصرة بحِزامٍ من الفقرِ والتعاسة.
وتطاولت الهجمة الإرهابية على اللاجئين. فقيل إن دولاً أجنبية أرسلتهم لتدمير العراق. ولم يكن غريباً أن يُلقى القبضُ على أي فلسطيني خارج البصرة ويُسأل ماذا جاء يفعل هنا؟ ومن الذي أرسله؟ كان التنقّل ممنوعاً بالطبع، والانتقال إلى مدينةٍ أُخرى غير مسموح به إلّا في حالاتٍ نادرة، ومنها لمّ شمل العائلات التي مزّقَ شملها التشتيتُ بين بغداد والموصل والبصرة.
ولم تتوقّف الهجمةُ إلّا بعد الانقلاب العسكري المعروف في العام 1958، وكشف بعض أوراق الحكومة الملَكية. وعُرف يوم ذاك أن حرائق الصرائف كانت من تدبير الحكومة العراقية وإصرارِها على إجلاء الريفيّين الفقراء الذين أحاطوا بالبصرة، ووضعوا يدهم على أراض حكومية وخاصة، ووقفوا عقبة أمام تمليك هذه الأراضي لأثرياء شركة التمور والموانئ والنفط، بالإضافة إلى محاربة الشيوعية التي لا تُولد وتترعرع كما كان يرى نوري السعيد إلّا في تجمّعات البؤساء، والحلُّ هو تشتيتُ هذا التجمّعات بحرق صرائفها.
ولم يمنع هذا الأمرُ بالطبع نوري السعيد من إعادة إحياء "المقام العراقي" الذي مات فور مغادرة العراقيين اليهود إلى فلسطين في أعقابِ العام 1948. وروى لي أحد أقطاب هذا الفن أن نوري السعيد استدعاه مع مجموعةٍ من محبّي المقامات وطلب منهم إنشاءَ فرقة "مقام" تبعث مجدداً مقامات الحجاز والنهاوند والبراهيمي... الخ. كان نوري هذا من عشاق هذا الغناء ويدفع بسخاء لإعادةِ إحيائه.
* إذا كان معنى كلمةٍ ما يتحدّدُ بالاختلاف، أي باختلافها عن الكلمات الأُخرى، تلك التي تُجاورها صوتياً ودلالياً ومكانياً، كما تقول البنيوية فإن زجّ كلماتٍ غريبة من حقولٍ دلالية وصوتية أُخرى، وبخاصة إن كانت من لسانٍ آخر، في تعبيراتِ لسانٍ ما، يُوقع ارتباكاً في هذه التعبيرات ذا أثر بالغ على القدرات التعبيرية، وعلى قدرة إيضاح النفس في اللغة أيضاً بالنسبة للمتكلّم.