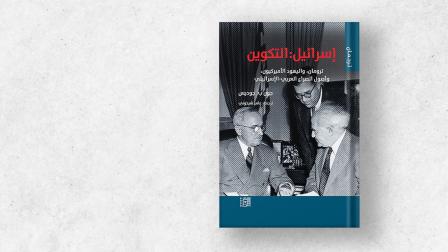في إيطاليا "المصابة"، حيث تسبّب فيروس كورونا حتى الآن بسقوط مئات من الضحايا، يفرُّ عشرون طالباً من طلاب المدرسة الإعدادية، عشرة فتيان وعشرُ فتيات، على متن حافلة مدرسية بعد اكتشافهم أن العدوى بدأت تنتشر حتى في مدرستهم. أحد المعلّمين يقود الحافلة، وهو يريد إيصالهم إلى بر الأمان في جزيرة مهجورة تعود إلى أجداده، بالقرب من شواطئ صقلية. المعلّم المصاب بالفيروس لا يصل إلى الجزيرة أبداً، لسوء حظه. عندئذٍ، وفي انتظار انتهاء الوباء ووصول أحد ما لإنقاذهم، يقرّر الفتية والفتيات قضاء الوقت في ابتكار ورواية القصص كلّ مساء.
إذا ذكّرتكم هذه الحبكة بشيء ما، فأنتم حتماً لستم مخطئين: "الديكاميرون"، رائعة جوفاني بوكاتشو التي روى فيها الطاعون القاتل الذي ألَمّ بمدينة فلورنسا في الأعوام 1348-1351، الوباء الأسوأ على الإطلاق الذي شهدته إيطاليا وأوروبا عبر التاريخ.
هذا ما يفعلونه في "معهد ستراديللا" في بلدة نيبي الصقلية، حيث قرّر الطلاب تجاوز الخوف بكتابة ديكاميرون مصغّر في زمن فيروس كورونا. وعلى خطى الجدّ بوكاتشو، ينتخب الطلاب كلّ أسبوع ملكاً وملكة، يحدّدان النوع الأدبي والموضوع الذي سيغامرون بتجربته. تتراوح القصص بين الرعب والمغامرة، وتلمّس المشاعر الإنسانية العامة مثل الصداقة والغيرة والحب، وهي بالطبع بعيدة كلّ البعد عن الأسلوب الكلاسيكي الذي يميّز الأعمال الأدبية القديمة.
وكلّ أسبوع، يعمل كلّ من جوليا وياسين على "حياكة" القصص المختلفة في إطار سردي مقنع وممتع. إنها واحدة من المبادرات الكثيرة التي يقوم بها الطلاب والمعلّمون بعد أن وجدوا أنفسهم فجأة حبيسي المنازل في وضع قلّما مرّت به إيطاليا في العقود الماضية.
تتكاثر مثل هذه المبادرات بين سكان ميلانو أيضاً، إنما دون اللجوء إلى الأرياف للوصول إلى عوالم جوفاني بوكاتشو: الأزقةّ المقفرة، النجوم الخافتة، والمعاطف السوداء التي تمتزج بحلكة الليل. فهم سيبقون في بيوتهم، بانتظار رحيل هذا الزائر المريع.
في هذه الأثناء، تعود ليالي الشتاء الطويلة، الألعاب المنسيّة، ويتردّد في أعماق الليل صدى همسات منسية أيضاً: لقد عدنا لأنفسنا، إنها الحياة التي كنا نفتقدها. ومع هذه الحياة الجديدة، يجد الإيطاليون أنفسهم مرغمين على التخلّي عن عادات عريقة، مثل العناق بين الأصدقاء وسهرة المساء "الموفيدا" بعد عناء يوم طويل في العمل.
في الخارج، الطرق مغلقة ورجال الشرطة والكارابينييري ينتشرون في الشوارع وعلى مداخل المدن والبلدات، يقفون بالمرصاد لأوّل مرّة، ليس في مواجهة المافيا وعصابات الإجرام المنظّمة، إنما في وجه عدو غير مرئي استطاع خلال فترة قصيرة أن يهدّد الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأحد أهمّ البلدان الصناعية في العالم.
قبل المرسوم الوزاري، كانت المسافة قد أصبحت عُرفاً، مترٌ واحدٌ أو ثلاث خطوات، ولا تمدّ لي يدك، فلربما ستكون قاتلي. في البداية، انصبّ الغضب على الصيني الذي جلب مع بضاعته الفيروس القاتل، ثم بالتبادل، أدار العالم ظهره، أوروبا أولاً، للإيطالي الذي نقل الوباء إلى أرجاء مختلفة من العالم. حرب البيتزا بدأها الفرنسيون، وتكتّم الألمان على ضحاياهم لئلا يبدون أقلّ حيطة من الطليان.
عدوى الابتسامة بدلاً من عدوى فيروس كورونا. ابتسامة من تحت القناع، غير مرئية، ولكن يمكن التكهّن بوضوح أنها ليست سوى تكشيرة، مضحكة أحياناً، وحزينة في معظم الأحيان.
إنها، الابتسامة، سلاح آخر لوقف زحف هذا العدو الذي لا يأبه بالحواجز ولا بأقصى ما توصلت إليه حضارتنا من اكتشافات علمية استطاعت، بعد تضحيات كبيرة، الحدّ أو حتى القضاء على العديد من الأمراض المعدية. كلمات ينطقها المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، متحاشياً النظر مباشرة إلى عين الكاميرا.
استعانوا أيضاً بالكتاب والفنانين: أنا سأبقى اليوم في البيت. سأقرأ كتاباً، سألعب مع أطفالي، وربما سأبدأ في الإعداد لكتابة مذكراتي. ثم تأهّب العالم الأدبي برمته للإجابة عن أسئلة الناس ومخاوفهم، مستعيدين في الذاكرة كيف أن الأوبئة، في وقت ما، كانت قد تحوّلت إلى أدب عظيم، منذ العصور القديمة، حيث وُلد هذا التوسيم الأدبي الذي سيظهر في معظم الثقافات، وسيؤدّي إلى تناغم مدهش بين الهاوية العميقة للمخاوف اللاشعورية من المجهول، والمجابهة الشرسة للبقاء على قيد الحياة. مكان مشترك، ومخطّط سردي يمكن إعادة استخدامه إلى أجل غير مسمّى، وغالباً ما يرتبط بمسبّب كارثي، كما فيروس الكورونا الآن. كلمة السر في كلّ هذا عدم الاستسلام للخوف.
كان من المستبعد للغاية، ولا يمكن حتى التنبؤ به، أن يسقط رجل القرن الحادي والعشرين المشبع باليقين العلمي وبالبحث المتواصل عن إطالة العمر، في دوامة رعب الأجداد وأن يغمره الذهان العالمي. عارٍ أمام الحقيقة، عيناه مذعورتان بالشر القادم من الطبيعة أو من مخابر سرية، ومظهره الهش الضعيف ليس سوى واحد من الاختبارات الكثيرة التي واجهها منذ بدايات وجوده على سطح الأرض.
كانت البداية، ربما، مع آفة الطاعون، وهي مرض حيواني المنشأ، مرّ عبر البراغيث، من الجرذان إلى البشر، أو كما كان يعتقد الأقدمون عندما كانوا يردّون هذه الآفات إلى غضب الآلهة، مثل صاحب "الإنيادة" الشاعر الروماني فيرجيل، الذي وصَف الطاعون الذي أصاب سكان روما بأن السماء أصبحت شديدة النيران، وداهمَ الموت، قادماً من الأعلى، كلّ نفْس من البشر والحيوانات.
هذا ما يعنيه أيضاً دانييل ديفو (1660-1731) في سرد طاعون لندن عام 1665، عندما ألقى اللوم على مرور نجم مذنب أو في رؤية ملاك يحمل سيفاً من النار، في جو عام من الانحلال الأخلاقي والديني. حتى أن العوام كانوا يعتقدون أن الأشخاص المصابين، بدافع الكراهية، كانوا يعمدون إلى نقل العدوى للآخرين لجعلهم يعانون مثلهم.
وقلّما يُذكر الأميركي إدغار آلان بو (1809-1849) في "قناع الموت الأحمر" المقلق حول المصير المأساوي ورعب الموت، وبصرف النظر عن البعد السريالي للقصة، يبزغ الموت لدى بو كرمز لعبثية الحياة.
أما البرازيلي خورخي أمادو في "تيريزا باتيستا تعبت من الحرب" (1972)، فيقلب الأمور رأساً على عقب، ولا يتردّد من دفع بطلته الهجينة، اليتيمة التي بيعت أثناء صغرها، وتحوّلت في ما بعد إلى راقصة وعاهرة، إلى نجدة الفقراء عند انتشار مرض الجدري في بوكين.
ويحذر: "فليصدق ذلك من يشاء، إن من قضى على الجدري الأسود هن عاهرات موريكابيبا، تقودهن تيريزا. بأسنانها الحادة ومنها السن الذهبي، مضغت تيريزا باتيستا الجدري وبصقته [...]. ومن مخبئه في مغارة، ينتظر الجدري فرصة للانقضاض مرة أخرى. آه، إذا لم يحتاطوا، فإن الجدري سيعود يوماً ليجهز على ما تبقى، والويل لنا عندئذ! فأين سنجد مرة أخرى تيريزا-الجدري-الأسود لتقود المعارك؟".
من يقود المعارك اليوم هم معلّمو ومعلّمات المدارس، منطلقين من فكرة تحويل الوضع الخاص الذي تمّر به المدارس، إلى فرصة خلّاقة، عن طريق اكتشاف العالم بالسرد. في الواقع، وحتى لو كانت المدرسة هاربة من "فيروس كورونا" وفي الحجر الصحي، وبالتالي تمرّ بلحظة مماثلة لتلك التي وصفها بوكاتشو في الديكاميرون، فإنهم بدأوا بدعوة الطلاب في كل مكان للمشاركة في ورشة عمل للكتابة الإبداعية، باتباع نموذج الديكاميرون، حيث سيكونون قادرين على اختيار كلمة واحدة من تلك المقترحة، مثل الصداقة، الخيانة، العبث والوئام، إلخ، وبناء رواية أو نوفيللا.
كتَب عالم "الرئيسيات" فرانس دي فال مقالاً نُشر منذ بعض الوقت في مجلة "الجمعية الملكية لتشجيع الفنون والصناعة والتجارة"، يقول فيه: "إن السؤال الأساسي، الذي نادراً ما نطرحه على أنفسنا، هو لماذا شكّل الانتقاء الطبيعي أدمغتنا بحيث نتمكّن من التناغم بشكل مثالي مع البشر الآخرين، لنشعر بالألم لآلامهم، وبالسعادة لسعادتهم. لو كان استغلال الآخرين هو السبيل الوحيد للتقدّم، لما كان التطوّر قد تعامل مع هذا التعاطف برمّته، لكنه فعل ذلك، بجدارة".