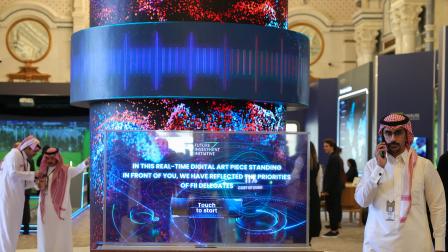احتجاجات في لندن تطالب بإنهاء الحرب في سورية (Getty)
يقول أصحاب الديانات غير التوحيدية إن اصحاب الديانات السماوية حظوا بأنبياء كثر، لأنهم قوم مُغالون ومتطرفون، ويجنحون إلى التمسك بالدين، إلى الحد الذي يدفعهم إلى إنكار الآخر، وتكفيره، والسعي إلى تحطيمه أحياناً.
لنعترف بأن التطرف في الفكر الديني في منطقتنا لم يعد تهمةً تلتصق بطرف واحد، بل تنطبق على كثيرين من أهل الديانات، ومن أهل المذاهب المختلفة داخل هذه الديانات، ففي أهل السنة متطرفون، ومن بين الشيعة من هم كذلك. وترى الأمر نفسه عند أصحاب الديانات المسيحية، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك الحال نفسه بين معتنقي اليهودية الذين يمسكون، الآن، بزمام الأمور، سواء بين اليهود في المهجر، أو الآخرين المقيمين على أرض فلسطين.
قد يعزو بعضهم التطرف إلى الفقر والبطالة. لا شك أن هذين العاملين يكوّنان البيئة الحاضنة للتطرف، لكن المتتبع للمتطرفين في كل الأديان والأقطار يرون كثيرين من هؤلاء ينحدرون من أسر غنية موسرة، فما الذي يدفع الغني الموسر إلى التطرف؟
النظريات التي تتحدث عن التطرف وأسبابه كثيرة. ولعل العودة إلى الفلسفة الوجودية، الدينية منها (كيركغارد) أو الملحدة (سارتر وجان جينيه وغيرهم)،
يعتقدون أن التطرف يعطي للأشخاص العاديين فرصة للقوة، وهم أشبه بالحراس الذين يتمتعون بسلطة منع الدخول، أو الخروج، أياً كان المستوى الوظيفي لمهنة الحراسة.
لكن السؤال الذي لا تجيب عليه هذه الفكرة الفلسفية: ما هي العوامل التي تدفع مهمشاً ما إلى التطرف، إذ ليس كل المهمّشين مشاريع تطرف؟ فما هي العوامل الدافعة لتحويل التهميش إلى عمل متطرف؟
لعل ذلك يكمن في أسباب نفسية، يدركها أهل الاختصاص في هذا المجال، فهنالك الرموز الخيالية، والقدوات التي تقدم للشباب في وسائل الإعلام المختلفة.
إذا نظرت إلى بعض المحطات الفضائية العربية الوكيلة لمحطات عالمية، فسترى أبطالاً يرتكبون جرائم ضد من يسمون أشراراً، وهؤلاء الأبطال كثر، لا يكادون يحصون، مثل سوبرمان، وبات مان، وسبايدر مان، والدبور الأخضر، والشبح، والمحولون (ترانسفورمرز)، وكثيرين غيرهم. ولهؤلاء رموزهم وحركاتهم. هذا هو النموذج الذي يقدمه أهل الحركات المتطرفة في محاربتهم "الأعداء" من غير المسلمين، أو من المسلمين الضالين، أو من أهل الديانات والطوائف الأخرى.
إذا كان الشاب المغرّر به يبحث عن وسيلة لتحقيق أحلام يقظته، والهروب من واقعه الساكن غير المثير، فسيجد فرصته للالتحاق بحركة مثل داعش، تدعي أنها تريد إنصاف السنة من غيرهم، وأن تعيد الخلافة، ويرتدي أتباعها ملابس غامقة مثيرة، ويقتلون بالسيوف، ويلجأون إلى قطع الرقاب والحرق. وإضافة إلى هذا كله، هي توفر لمنتسبيها حياة معقولة من مباهج الدنيا.
ومن هنا، يأتي دور البيئة الحاضنة، فالشبان والفتيات في الوطن العربي، وفي إسرائيل، يتعرّضون يومياً لمن يذكّرهم بأنهم غير مهمين، فالبطالة بين صفوف الشباب تساوي، على الأقل، ضعف نسبتها بين من هم فوق سن الأربعين، وترتفع هذه النسبة عند الإناث.
وهم في بيوتهم قابعون عبئاً على جيل آبائهم الذي لم يورثهم سوى عالم تسود فيه المادية، والتفاوت المجحف في الدخول والثروات والفرص، ويستأثر به الأغنياء بالمقاعد الأولى، على الرغم من ضآلة مهاراتهم على حساب أبناء الآخرين المبدعين.
اقرأ أيضا: إعادة إعمار الوطن العربي
ويجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن العمل، وإن وجدوه فدخله لا يكفي لبناء حياة زوجية آمنة مستقرة. ومعاناة الفتيات أعلى من معاناة الشباب. فإذا وجدت من يعطيك الفرصة لتثور على هذا كله، فالأرجح أن مهمشين مهملين سيجدون في التنظيمات المتطرفة فرصة للتعبير والتنفيس، ومكاناً يُعتبرون فيه أقوياء، وحاجاتهم موضع نظر، ويغلف هذا كله تبرير سامٍ للتطرف، وهو محاربة الأعداء وبناء دولة الخلافة، فكيف لا يستجيب بعضهم لهذا النداء.
درس معظم هؤلاء التاريخ والدين، وحفظوه عن ظهر قلب، من دون السماح لهم بالتحليل والمقارنة والنقد، عندما يثور الشك في نفوسهم. لقد درسوا تاريخ الخلفاء الراشدين من دون أن يفهموا أسباب الفتنة الكبرى أيام الخليفة عثمان، والفتنة الكبرى الثانية بعد موقعتي الجمل وصفين. وحرّم على هؤلاء أن يفهموا أن القرآن يدرّس على مراحل، ولا يجوز أن تعرض عليهم آيات من سورتي التوبة والأنفال، قبل أن تتكون لهم أسس فهم الدين التي تجعلهم يؤمنون بأن دينهم دين سلام ووئام وإخاء، قبل أن يكون دين قتال وقتل وحروب.
على الرغم من كل هذه الأسباب، فإن نسبة الذين يرون أن حركات داعش وجبهة النصرة والقاعدة هي التي تمثل فكرهم قليلون عدداً، وفي معظم الدول العربية، لا تزيد نسبة هؤلاء عن 6% من مجموع السكان، ولكن تحويل هذه النسب إلى أرقام مطلقة يجعلها مخيفة.
وإذا كان 2% يرون في حركة داعش ما يمثل فكره، فإن عُشر هؤلاء على الأقل يكون قابلاً للتجنيد، إذا توفرت له الظروف المناسبة ليلتحق بها. ونحن نعلم أن عدد سكان الوطن العربي بات يزيد على 350 مليوناً. هذا يعني أن عدد القابلين المؤيدين الذين يرون فيهم تمثيلاً لآرائهم يصل إلى سبعة ملايين، ومن بين هؤلاء قد يكون سبعون ألفاً قابلين للتجنيد، باستثناء القادمين من أوروبا ودول أخرى.
ومتى ما هزمت داعش عسكرياً، ستتحول إلى الإرهاب الأمني والتفجير والأعمال الانتحارية. ووجود سبعين ألفاً داخل الوطن العربي يشكل عدداً مخيفاً، بغض النظر عن نسبته المئوية. وإذا وصل إلى هؤلاء من يغويهم، ويغسل عقولهم ويجندهم لخدمته، فإن كلفة ذلك، بشرياً وأمنياً واقتصادياً، ستكون وخيمة.
يجب أن نضع الحقائق في نصابها، وأن نسعى إلى محاربة التطرف، بدءاً من احتواء البيئة الحاضنة له، ومروراً بالنظر في الإعلام والتعليم والثقافة الدينية، وانتهاءً بتحسين وسائل الاستكشاف والمحاربة، لمن يصرون على أن التطرف هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن ذواتهم.
اقرأ أيضا: النفط والسياسة والاقتصاد
لنعترف بأن التطرف في الفكر الديني في منطقتنا لم يعد تهمةً تلتصق بطرف واحد، بل تنطبق على كثيرين من أهل الديانات، ومن أهل المذاهب المختلفة داخل هذه الديانات، ففي أهل السنة متطرفون، ومن بين الشيعة من هم كذلك. وترى الأمر نفسه عند أصحاب الديانات المسيحية، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك الحال نفسه بين معتنقي اليهودية الذين يمسكون، الآن، بزمام الأمور، سواء بين اليهود في المهجر، أو الآخرين المقيمين على أرض فلسطين.
قد يعزو بعضهم التطرف إلى الفقر والبطالة. لا شك أن هذين العاملين يكوّنان البيئة الحاضنة للتطرف، لكن المتتبع للمتطرفين في كل الأديان والأقطار يرون كثيرين من هؤلاء ينحدرون من أسر غنية موسرة، فما الذي يدفع الغني الموسر إلى التطرف؟
النظريات التي تتحدث عن التطرف وأسبابه كثيرة. ولعل العودة إلى الفلسفة الوجودية، الدينية منها (كيركغارد) أو الملحدة (سارتر وجان جينيه وغيرهم)،
لكن السؤال الذي لا تجيب عليه هذه الفكرة الفلسفية: ما هي العوامل التي تدفع مهمشاً ما إلى التطرف، إذ ليس كل المهمّشين مشاريع تطرف؟ فما هي العوامل الدافعة لتحويل التهميش إلى عمل متطرف؟
لعل ذلك يكمن في أسباب نفسية، يدركها أهل الاختصاص في هذا المجال، فهنالك الرموز الخيالية، والقدوات التي تقدم للشباب في وسائل الإعلام المختلفة.
إذا نظرت إلى بعض المحطات الفضائية العربية الوكيلة لمحطات عالمية، فسترى أبطالاً يرتكبون جرائم ضد من يسمون أشراراً، وهؤلاء الأبطال كثر، لا يكادون يحصون، مثل سوبرمان، وبات مان، وسبايدر مان، والدبور الأخضر، والشبح، والمحولون (ترانسفورمرز)، وكثيرين غيرهم. ولهؤلاء رموزهم وحركاتهم. هذا هو النموذج الذي يقدمه أهل الحركات المتطرفة في محاربتهم "الأعداء" من غير المسلمين، أو من المسلمين الضالين، أو من أهل الديانات والطوائف الأخرى.
إذا كان الشاب المغرّر به يبحث عن وسيلة لتحقيق أحلام يقظته، والهروب من واقعه الساكن غير المثير، فسيجد فرصته للالتحاق بحركة مثل داعش، تدعي أنها تريد إنصاف السنة من غيرهم، وأن تعيد الخلافة، ويرتدي أتباعها ملابس غامقة مثيرة، ويقتلون بالسيوف، ويلجأون إلى قطع الرقاب والحرق. وإضافة إلى هذا كله، هي توفر لمنتسبيها حياة معقولة من مباهج الدنيا.
ومن هنا، يأتي دور البيئة الحاضنة، فالشبان والفتيات في الوطن العربي، وفي إسرائيل، يتعرّضون يومياً لمن يذكّرهم بأنهم غير مهمين، فالبطالة بين صفوف الشباب تساوي، على الأقل، ضعف نسبتها بين من هم فوق سن الأربعين، وترتفع هذه النسبة عند الإناث.
وهم في بيوتهم قابعون عبئاً على جيل آبائهم الذي لم يورثهم سوى عالم تسود فيه المادية، والتفاوت المجحف في الدخول والثروات والفرص، ويستأثر به الأغنياء بالمقاعد الأولى، على الرغم من ضآلة مهاراتهم على حساب أبناء الآخرين المبدعين.
اقرأ أيضا: إعادة إعمار الوطن العربي
ويجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن العمل، وإن وجدوه فدخله لا يكفي لبناء حياة زوجية آمنة مستقرة. ومعاناة الفتيات أعلى من معاناة الشباب. فإذا وجدت من يعطيك الفرصة لتثور على هذا كله، فالأرجح أن مهمشين مهملين سيجدون في التنظيمات المتطرفة فرصة للتعبير والتنفيس، ومكاناً يُعتبرون فيه أقوياء، وحاجاتهم موضع نظر، ويغلف هذا كله تبرير سامٍ للتطرف، وهو محاربة الأعداء وبناء دولة الخلافة، فكيف لا يستجيب بعضهم لهذا النداء.
درس معظم هؤلاء التاريخ والدين، وحفظوه عن ظهر قلب، من دون السماح لهم بالتحليل والمقارنة والنقد، عندما يثور الشك في نفوسهم. لقد درسوا تاريخ الخلفاء الراشدين من دون أن يفهموا أسباب الفتنة الكبرى أيام الخليفة عثمان، والفتنة الكبرى الثانية بعد موقعتي الجمل وصفين. وحرّم على هؤلاء أن يفهموا أن القرآن يدرّس على مراحل، ولا يجوز أن تعرض عليهم آيات من سورتي التوبة والأنفال، قبل أن تتكون لهم أسس فهم الدين التي تجعلهم يؤمنون بأن دينهم دين سلام ووئام وإخاء، قبل أن يكون دين قتال وقتل وحروب.
على الرغم من كل هذه الأسباب، فإن نسبة الذين يرون أن حركات داعش وجبهة النصرة والقاعدة هي التي تمثل فكرهم قليلون عدداً، وفي معظم الدول العربية، لا تزيد نسبة هؤلاء عن 6% من مجموع السكان، ولكن تحويل هذه النسب إلى أرقام مطلقة يجعلها مخيفة.
وإذا كان 2% يرون في حركة داعش ما يمثل فكره، فإن عُشر هؤلاء على الأقل يكون قابلاً للتجنيد، إذا توفرت له الظروف المناسبة ليلتحق بها. ونحن نعلم أن عدد سكان الوطن العربي بات يزيد على 350 مليوناً. هذا يعني أن عدد القابلين المؤيدين الذين يرون فيهم تمثيلاً لآرائهم يصل إلى سبعة ملايين، ومن بين هؤلاء قد يكون سبعون ألفاً قابلين للتجنيد، باستثناء القادمين من أوروبا ودول أخرى.
ومتى ما هزمت داعش عسكرياً، ستتحول إلى الإرهاب الأمني والتفجير والأعمال الانتحارية. ووجود سبعين ألفاً داخل الوطن العربي يشكل عدداً مخيفاً، بغض النظر عن نسبته المئوية. وإذا وصل إلى هؤلاء من يغويهم، ويغسل عقولهم ويجندهم لخدمته، فإن كلفة ذلك، بشرياً وأمنياً واقتصادياً، ستكون وخيمة.
يجب أن نضع الحقائق في نصابها، وأن نسعى إلى محاربة التطرف، بدءاً من احتواء البيئة الحاضنة له، ومروراً بالنظر في الإعلام والتعليم والثقافة الدينية، وانتهاءً بتحسين وسائل الاستكشاف والمحاربة، لمن يصرون على أن التطرف هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن ذواتهم.
اقرأ أيضا: النفط والسياسة والاقتصاد