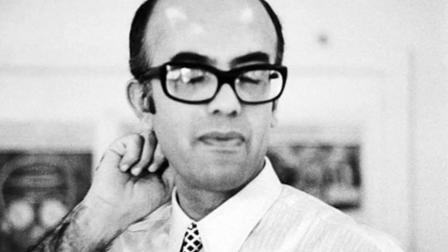تعود بدايات الاستشراق الأولى إلى العصور الوسطى في أوروبا. وما فتئت إنجازات المُستشرقين ومناهجهم تتنامى حتى صارت بمثابة نظام فكري مكتملِ الجوانب، رغمَ تناقضاته، يضمّ المعرفة التحليلية لتاريخ الشرق وآدابه وحضاراته وأنظمة المجتمع فيه، كما ينطوي على رومانسية عارمة وحنينٍ جيّاشٍ لسحر الشرق وجمالياته المتخيَّلة، ميّزا الحركات الأدبية والفنية التي تغذّت منه؛ وأشهرها الرومانسية الألمانية.
لكنّه هذا النظام تحوّل - وهُنا مفارقته الكبرى التي أجلاها إدوارد سعيد في كتابه "الاستشراق" - إلى مَجمع نَقائض، أي: متخيَّل يختزل فيه المستشرقون كل النقائض التي يرفضها الغرب عن ذاته، فصار الشرق الوجهَ الآخر المكبوت المرفوض، آخر بلا عقلانية ولا أنظمة دولة. سحرٌ وخيال وامتداد.
ازدهرت تيارات الاستشراق بشكل خاص في نهاية القرن التاسع عشر، لا سيما في أعمال المدرسة الفيلولوجية الألمانية، برئاسة نولدكه، التي تخصّصت في القرآن وتاريخ نزوله وترتيبه في المصاحف. وما يزال الاستشراق يعرف تحولاتٍ كبرى يَحق لنا اليوم أن نُراجِع أهمّها لاستكشاف ملامح هذا القطاع الفكري الدقيق.
إجمالاً، تنبني مسيرة التكوين العامّة لهذا النوع من المثقّفين على دراسة اللغة العربية القديمة بأحد المعاهد الأوروبية، والاطلاع على ما يلازمها من مظاهر حضارية وأدبية، ويضاف إلى هذا المُقرّر دراسة بعض اللغات الشرقية الأخرى؛ مثل الفارسية والتركية والعبرية والآرامية، ولكن باعتبارها جميعاً، بما فيها العربية، لغاتٍ ميتة، مكتوبة بل مخطوطة.
ومع انبعاث اللغة العربية المعاصرة، بعد هجعتها أبنيتها التوليدية والنحوية لقرون مضت، تقَوّض التصوّر التقليدي للاستشراق، وافتقد المستشرق أرضيته المفضّلة وهي الفيلولوجيا بما هي اشتغالٌ على تحقيق النصوص القديمة، فانخرق مجال عمله بسبب ما ينتجه العرب في العصر الحديث من أدب ونُظُم، وبتغيّر موضوع العمل تغيَّرت المناهج والنتائج وطرائق الاستكشاف.
كما عرف الاستشراق هيمنة العلوم الإنسانية الحديثة وطغيان خطابها على قطاعاته التقليدية، فاستُعيض عن الدراسات النسقية ذات المنحى التجريدي- كما فعل جوزيف شاخت في أبحاثه عن الفقه الإسلامي مثلاً- بسوسيولوجيا القانون، ودرْسه في مجتمعٍ بعينه، في فترة تاريخية محدّدة، كما هو شأن الباحث برنار بوتيفو في تطوّرات القانون، في مصر وسورية، في العصر الحديث.
من جهة ثانية، تركّزت الأبحاث على الآداب والظواهر الاجتماعية والسياسية الحديثة، على حساب الاعتناء بالنصوص القديمة وخبايا التراث وقضايا المخطوطات، فاقتصر عمل المستشرقين الجدد على متابعة الشأن العربي، أو إحدى جوانبه، ولا ضير بعد ذلكَ إن استقطبتهم وسائل الإعلام، فملأوا الشاشات بتحاليل، بعضها استهلاكي سريع.
رافق هذه التحوّلات بروز هنّات بنيوية، منها الضعف في التكوين اللغوي الأصلي، والاقتصار على عناصر باهتة من اللهجات، مما يقلّص إمكانية التعامل مع المصادر الأولى والعودة إلى أمّهات الكتب. ولضمور الكفاءة اللغوية تبعاتٌ خطيرة على التأويل والفهم، منها الاقتصار على سطحي المسائل عوض الخوض في تضاعيف المعنى، ودلالات الخطاب على الذهنية الثقافية العميقة.
كما تواصلت في أعمال بعضهم النظرة الاستعلائية إلى العرب، وإلى ما يُنتجونه في ميادين اختصاصهم، فهُم لا يعودون إليه، ويصرّون على اعتبار الخطاب العربي عن العرب قاصراً مَنهجياً، إضافة إلى إصرارهم على تطبيق المقولات الإناسية التي انبثقت من دراسة المجتمعات الأخرى، ولا صلة لها بالحضارة العربية، كتطبيق مفاهيم الإثنوجرافيا الثقافية على مجتمعات البادية العربية، مع أنها نتجت عن ملاحظة القبائل البدائية في أميركا اللاتينية.
ويشبه هذا التوجّهَ الربطُ المتسرّع بين التراث اليهودي - المسيحي ونصوص الإسلام، إفقاداً لها من كل خصوصية، ونزعاً لها من بيئتها الخاصّة، باعتبارها مجرّد تعبير عن صُوَر أصلية، منحدرة من التراث الديني والفلسفي للغرب. وآخر مظاهر هذا الربط المتسرّع، اعتبار النص القرآني وقصصه مجرّد تناص مع سرديات التوراة والأناجيل، أو أخبارٍ كتبها يهود وآراميون في القرن الثاني للهجرة، ولك في كتاب كريستوف ليكسمبورغ مثال واضح.
ظلَّ المستشرق المعاصر يكافح ضد تاريخه وضد أعمال أسلافه التي ارتبط بعضها بالحركات الاستعمارية والنزاعات الإثنو-مركزية، واقترن بعضها الآخر بالتشكيك في نصوص الإسلام التأسيسية، حتى صار يفضّل مصطلح "المستعرب".
في أيامنا، فقَد الاستشراق قاعدته المعرفية وصار قطاعاً من قطاعات الخطاب عن الآخر، يسهم فيه الباحث العربي بنفس كفاءة زميله الأوروبي، بعد أن زالت بينهما الحدود، يتشاركان نتائج البحث ويحدّدان معاً مجال تخصّص الاستعراب.
اقرأ أيضاً: جوزيف مسعد.. كشف استشراق الداخل