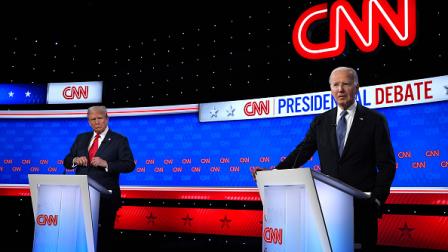لكن أعداد الجنود القتلى في صفوف الاحتلال لا تعني المهجرين في الداخل الفلسطيني سوى كونهم الأداة التي رحلتهم عن بيتهم وقريتهم وإن بقوا لاجئين/ مهجرين في الوطن. سارعت حكومات إسرائيل إلى إسباغ وصف "الغائبون/الحاضرون" عليهم، ليتحول مع الوقت إلى دليل إدانة للاحتلال وتأكيد على جرائم الصهيونية في حق فلسطين وشعبها. إنهم الغائبون الحاضرون، غائبون عند مستندات الدولة وأوراقها، بما يسهل سلب أراضيهم ومصادرتها، لكنهم حاضرون، ذاكرة شعب حي ودليل إدانة على التطهير العرقي.
حاضرون في الوطن
هم يعدّون اليوم نحو 380 ألف فلسطيني يعيشون ويسكنون على مرمى حجر من بيوتهم الأصلية، إذ لا تجد قرية أو بلدة أو حتى "مدينة" فلسطينية لا يعيش فيها فلسطينيون هجّروا من بيوت لا تبعد أكثر من مئات الأمتار عن مقر إقامتهم وعيشهم.
في الناصرة أهالي صفورية، وفي طمرة مهجرو الرويس واليامون، وفي باقة مهجرون من المنشية، وفي جت المثلث مهجرون من الجلمة، أما وادي عارة وأم الفحم فيحتضنان آلافا من مهجري قرى الروحة، وإلى دالية الكرمل وعسفيا لجأ أهالي أم الزينات، وفي الطيرة يتواجد أبناء قرية مسكة. وعلى الساحل الفلسطيني، أو ما تبقى منه يعيش مهجرو المفجر في جسر الزرقاء والفريديس ومعهم مهجرو زمارين، فيما انتقل أهالي طيرة الكرمل، أو من استطاع منهم إلى ذلك سبيلاً، إلى حيفا، ومثلهم من عين غزال وصرفند وإجزم.
إلى الساحل الفلسطيني سيتدفق، اليوم الخميس، عشرات الآلاف من فلسطينيي الداخل، للمشاركة في مسيرة العودة التقليدية الواحدة والعشرين تحت شعار: "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، هكذا يأمل عضو إدارة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، المهندس سليمان الفحماوي.
وتلتحم مسيرة العودة التقليدية هذا العام بمسيرات العودة في قطاع غزة، مخلفة زخماً يرفد حق العودة الفلسطيني المقدس، الذي لا تنازل عنه. هذا ما يبث الأمل ويشيعه بحسب الفحماوي، المهجّر أصلاً من قرية أم الزينات، التي محاها الاحتلال. يوضح الفحماوي، في حديث مع "العربي الجديد" أنّ جمعاً كبيراً ممن يشاركون في مسيرات العودة في السنوات الأخيرة هم من جيل الشبان والشابات الذين انضموا لقافلة العودة. ويضيف "نحن بانتظار عشرات الآلاف من فلسطينيي الداخل والحشود الكبيرة لمسيرة الساحل إلى عتليت وقرى الساحل الأخرى: إجزم وجبع وصرفند وكفر لام وعين غزال والطيرة". ويعتبر الفحماوي أن العدد الكبير للمشاركين من فلسطينيي الداخل من غير المهجرين في الداخل يعكس حجم الوعي الفلسطيني الجمعي بأهمية العودة وحق العودة وتكريس هذا الحق في نفوس الأجيال الناشئة حتى بين من لم يولدوا في عائلات المهجرين في الداخل، وهو إنجاز تراكمي لنشاط الجمعية التي انطلقت قبل 22 عاماً مع تأسيسها لحماية حقوق اللاجئين والمهجرين في الداخل.
وبحسب الفحماوي فإن واقع المهجرين في الداخل وقضيتهم وحقهم في العودة بات اليوم أمراً محورياً في حياة المجتمع الفلسطيني في الداخل. يقول: "نحن نشعر اليوم بأن هذه القضية هي من الدرجة الأولى التي وضعت على طاولة النضال الشعبي الفلسطيني بالداخل وتبنتها كافة الأحزاب وكافة الهيئات والمؤسسات وعلى رأسها أيضاً لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل. وهي القضية رقم واحد التي تطرح على الساحة الفلسطينية في الداخل وعلى مجمل جدول أعمال القضية الفلسطينية، وهي قضية لها امتداد كبير خارج الوطن أيضاً".
أنا من بيسان...
"أنا المهجرة من بيسان وإن لم أولد فيها فأمي جاءت من بيسان". بهذه الكلمات بدأت الناشطة الفلسطينية رلى نصر مزاوي حديثها مع "العربي الجديد". تقول مزاوي "أمي مهجرة من بيسان، وأنا ولدت بعد النكبة خارج بيسان، لكنني أشعر نفسياً أنني أنا المهجرة من بيسان... والدتي لم تتحدث في البدايات عن بيسان ولا عن التهجير، كانت لسنوات تحبس حزنها وألمها ومأساتها بسبب صدمة الاقتلاع والخوف في أيام الحكم العسكري الذي فرضه الاحتلال على الناس".
وتضيف "أنا أشعر بأنني أنا المهجرة اليوم حتى بعد سبعين عاماً، أهلنا في بيسان هُجروا منها وهم الغالبية العظمى. هناك من صار لاجئاً في الأردن، وقسم منهم مثل أمي في الناصرة".
وتتابع "أنا الجيل الثاني للنكبة. نكبة مهجري الداخل، نحن نتحدث عن 385 ألف شخص هجروا من بيوتهم وبلداتهم وأرضهم. هؤلاء من بقوا من أصل 800 ألف تم تهجيرهم في حرب النكبة خلالها وقبلها... لكننا نلاحظ بعد سنوات من العمل الدؤوب استمرار تدفق الناس بأعداد أكبر على المشاركة في مسيرات العودة". تكرر مزاوي خلال حديثها مع "العربي الجديد" عبارة "أنا مهجرة نفسياً". وتضيف "أنا لم أهجر من بيسان. ما حدا مسكْني وزتّني من بيسان لكنني عشت في بيت كانت الأم فيه مهجرة، وكان التهجير حاضراً طيلة الوقت، كانت بيسان حاضرة في بيتنا طيلة الوقت وعندي شعور بأن عليّ مسؤولية، نحن أبناء الجيل الثاني علينا مسؤولية استعادة هذا الحق، قضية العودة هي قضية حق وليست مجرد قضية إنسانية صرفة".
تقول مزاوي "جيلنا، هو الجيل الثاني، ونحن نحمل الراية وننقلها للجيل الثالث، لأن الجيل الأول لم يتحدث كثيراً، سكت طويلاً وعندما تحدث، تحدث في داخل البيت، كان طيلة الوقت خائفاً بسبب الحكم العسكري، وكان الخوف كبيراً، الرواية نُقلت داخل الأسرة للأولاد، أما اليوم فقد انكسر حاجز الخوف، عندنا أبناء الجيل الثاني، ونحن ننقله لأبنائنا في الجيل الثالث. أنا تم الاعتداء عليّ في التهجير، ولن أسمح لهذا الاعتداء بالاستمرار، أريد حقي".
ومثل المهندس سليمان الفحماوي ترصد مزاوي دور الجيل الشاب، وليس فقط من أبناء المهجرين، في قيادة الحراك المختلف بشأن ملف العودة. تقول "عندما أنظر للمسيرة أرى وألاحظ أعداد الشباب المشاركين فيها في السنوات الأخيرة، وهي زيادة هائلة خصوصاً بالنسبة للشباب والصبايا، أكثر من 70 في المائة هم من غير المهجرين".
وبالنسبة إليها فإن "التهجير وقع على الجميع، ولم يقف عند من هجروا وظلوا داخل الوطن أو باتوا لاجئين خارج الوطن". وترى، استناداً إلى تخصصها في علم النفس، أنه "حتى من لم يهجر من بيته، ومن قريته، وجد نفسه، بعد النكبة يعيش في بيئة جديدة تغيرت كلياً غير التي كبر وترعرع فيها. لم يعد حوله الأصحاب والأصدقاء، ولا جيران القرية المجاورة. ومن كانوا معه في المدرسة لم يجدهم. لقد انقلبت عليه الدنيا بين ليلة وضحاها. تغير نظام الحكم وبات غريباً في بيئة لم يألفها غير التي عاشها، الخوف الذي عاشه من بقي هو أيضاً تهجير، كل الفلسطينيين، من مهجرين أو من غير المهجرين، يدركون اليوم ويعيشون هاجس العودة وتكريس هذا الحق".
لا فائدة ترجى من القضاء
تشير أربع حالات فلسطينية "خاصة" وربما يمكن القول مميزة، إلى عدم جدوى التعويل على القضاء الإسرائيلي. فمن بين مئات القرى التي هجرت حظي سكان أربع قرى بقرارات صدرت عن المحاكمة الإسرائيلية العليا، توجب إعادتهم إلى قراهم، بعد أن أثبتوا أنهم لم يكونوا غائبين. هذا ما حدث مع قرار قضائي بحق أهالي إقرث وبرعم المشهورتين. كما صدر قرار قضائي لصالح أهالي الغابسية، وآخر لصالح قرية الجلمة، لكن رد الحكومة الإسرائيلية كان بداية بإعلان مناطق هذه القرى مناطق عسكرية مغلقة ومنع العودة إليها، ومن ثم لاحقاً قصفها وتدميرها كما حدث في كفر برعم عام في 17 سبتمبر/أيلول 1953 حتى لا يبقى ما يعود إليه الناس، وألحقت أراضي هذه القرى بعد مصادرتها إما بدائرة أراضي إسرائيل أو منحت للمستوطنات الزراعية التي أقيمت في الموقع وأخذ بعضها نفس الاسم كما في حالة كيبوتس برعم.
****************
عتليت على ساحل فلسطين
يصف المؤرخ الفلسطيني، وليد الخالدي، في كتابه "كي لا ننسى" قرية عتليت بأنها "انتصبت على تل من الحجر الرملي يشرف على البحر المتوسط وتحيط بها من جهة الشرق أراض زراعية ساحلية ومن الجنوب الغربي أحواض كبيرة من الأراضي الزراعية، وأحواض كبيرة للتبخر لاستخراج الملح". كما ورد اسم القرية في كتاب معجم البلدان للجغرافي العربي ياقوت الحموي (المتوفى عام 1229) ذاكراً أنها حصن اسمه الأحمر. وقد بنى الصليبيون خلال الفترة الصليبية حصناً كبيراً أطلقوا عليه اسم حصن الحجاج.
بعد انسحاب الصليبيين من الموقع سكن أناس من نسل قبيلة العويرات، عتليت وجوارها. وسجل العام 1596 وجود مزرعة في عتليت تدفع الضرائب لخزينة الدولة العثمانية. مع بدء تكريس أطماع الحركة الصهيونية في فلسطين مطلع القرن العشرين، أقامت الحركة الصهيونية عام 1903، في بدايات حركة الاستيطان، مستعمرة أطلق عليها نفس الاسم استخدمت خلال معارك الحرب العالمية الأولى مركزاً لعصابات حركة نيلي الصهيونية التي تخصصت منذ البدايات بالعمليات الاستخباراتية وجمع المعلومات مساندة للقوات البريطانية.
انضمت قرية عتليت الفلسطينية في العشرينيات من القرن الماضي إلى هيئة تعاونية إقليمية لتحسين أوضاع المزارعين، وبلغ عدد سكانها عام 1938، 508 أشخاص فيما كان عدد سكان مستعمرة عتليت اليهودية 224 مستوطناً، إلا أن عدد العرب في عتليت الفلسطينية تراجع مع حلول العام 1944-1945 إلى 150 نسمة: 90 مسلماً و60 مسيحياً، ولم يبق من الأرض في أيدي العرب سوى 15 دونماً، 3 منها مزروعة بالحبوب و11 دونماً مروياً ومستخدماً للبساتين. لا يوجد تاريخ محدد ومعروف، بحسب الخالدي، لسقوط القرية ولا كيفية احتلالها ووقوعها بقبضة الاحتلال الإسرائيلي.