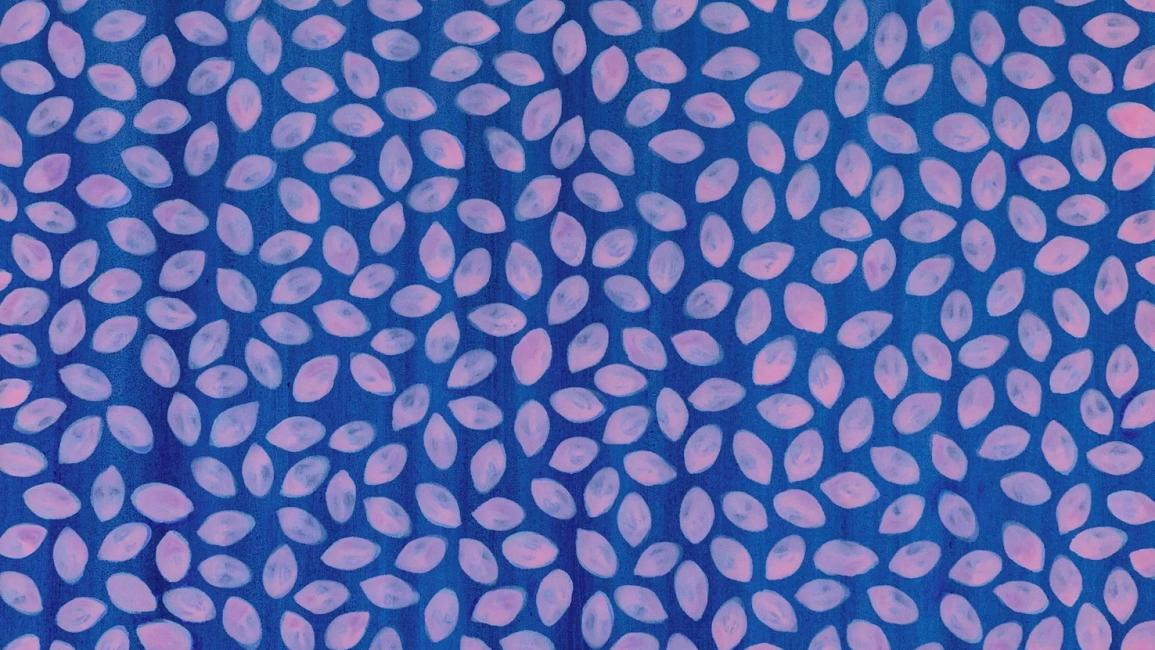أنا لستُ في بيروت
(دانيال أورسن عبّارة)
أنا لستُ في بيروت، أكرّر لنفسي، حين أستيقظ ليلاً ينقصني الهواء، وأنا على عتبة الاختناق. الكهرباء ليست مقطوعة، ولا حاجة لأيّ مولّدات بوجود التيّار الكهربائي 24/24 ساعة. وإذ لا يقتنع عقلي شبه النائم بما أردّده لإقناعه، أنهض من فراشي، وأتجّه مباشرة إلى زرّ الإضاءة. وبعد أن أطمئنّ إلى فاعليته، أنتقل إلى النافذة، لأتأكّد من كوني بعيدة، في مدينةٍ أخرى ظُلمتها عادية، وتتخلّلها بعضُ غرف مضاءة هنا وهناك، شوارعُ مُنارة، وأنوارٌ تشهد على سير الحياة الطبيعيّ. ومع ذلك، أبقى أشعر أن ثمّة عتمة تُطبق على صدري. أجل، هي عتمة بيروت التي تستقرّ وتنتشر في داخلي كبقعة حبر سوداء تتشرّبها، مثل الورق النشّاف، خلايا روحي. لستُ أدري لما أسمّي هذي ظلمة وتلك عتمة، هل لأنّ الظلام من فعل الليل، في حين تُفتعل العتمة افتعالاً، جالبةً الغمّ والهمّ. ألا يُقال ظُلمة الليل وعتمة القبر؟ لا، لا يقال. لكنّها بالفعل ظلمة الليل وعتمة القبر محفورتان هنا في الذاكرة التي تورّق كلّ ربيع. العتمة تينع كلّ ربيع، كلّ نيسان، كلّ حرب، وبيروت التي تقضمها العتمة وتمحوها بالتدريج، تنهض في الظلام لتقضم بدورها هدأةَ الليل.
"بيروت غارقة في العتمة" أقرأ نهاراً، فتزحف نحوي الظلالُ ليلاً، وتغمرني كما تغمر المياه صخرةً لا تزحزحها الأمواج. العتمة بئرٌ، وبيروت تمضي نزولاً في البئر، حتى تغمرها العتمة. أما أنا، فأقفز من سريري مذعورةً، غير قادرةٍ على فعلٍ بائسٍ كالشهيق والزفير بانتظامٍ ومعاً. أهلاً بالأرق إذاً، الأرق الصافي الأصيل الذي لا يشغله عن نفسه أيّ دخيل، ذاك الذي يصحبه بردٌ، وهنٌ، وعجزٌ عن ارتكاب أي فعلٍ سواه، كالقراءة أو تشغيل التلفاز، الأكل أو التلهّي بأمر ما. الأرق العلّة الانتظار. الأرق الرخيص غير الرومنطيقي منزوع الصفات الخالي من كلّ دسم أو مذاق. الأرق الفقير، البائت، قاتل وظائف العقل، الجرثومي. بانتظار أوّل خيوط الفجر وحلول بقعة ضوءٍ تنذر بإمكانية العودة أخيراً إلى الفراش.
هكذا، في كلّ ليل، مذ غادرتُ قبل أن تغرق بيروت كلّياً. كأنما السَّهر على العتمة يحدّ من توسّعها ويمنعها من الانتشار. وهكذا، أغفو في مدينةٍ بعيدة، وأصحو في ذروة الليل، في بيروت، عندما تصمت المولّدات ليستبيح غولُ العتمة المكان، وتستيقظ أشباح الذاكرة التي لمّا تلتئم بعد. "عتمتنا" هي صخرة سيزيف، لا تني تتدحرج إلى قاعٍ يبتعد أكثر فأكثر، بينما تكبر هي وتثقل. لا أحبّها هذي القصة، ولا أجدها معبّرة، فسيزيف الذي تمكّن من خداع إله الموت وتكبيل يديه بالأصفاد، بعد أن سأله أن يجرّبها، لم يكن بتلك الفطنة والذكاء كما تصفه الأسطورة، بل على العكس. إذ ما معنى أن تخدع الموت وتمنعه من قطاف الأرواح حين تكون/ تصير الحياة ضحلةً وبخسةً بهذا الشكل؟ بل ما الذي يمنع "البطل" سيزيف من التوقّف عن حمل الصخرة ودحرجتها صعوداً إلى أعلى الجبل، هو المدرك عن تجربةٍ أنّها ستعاود السقوط من جديد؟ هل حرن سيزيف وعاند الآلهة، فأرخت عليه عتمة أزلية، عتمة ما قبل التاريخ؟
*
تصعد "ن" إلى الطابق التاسع مثل رجل آليّ يسيّره وقودُ الغضب والقرف والمسبّات. تشتم طابقاً إثر طابق، الناسَ وآلهةَ الإغريق وحظّها العاثر الذي جعل رأسها "يسقط" على هذي الأرض بالذات. تصل إلى شقّتَها مقطوعة الأنفاس، تُلقي من يديها أكياسها اللعينة على حافّة المجلى، ثم تجلس فوق أرضية المطبخ، مشلولة الساقين، غير قادرةٍ على الحركة. لم تزل هناك صخرتان أو ثلاث أمام باب المصعد، ستنتظر قليلاً قبل أن تعاود النزول، دقائق معدودة وتكتمل أجزاءُ "صخرتها" بين يديها.