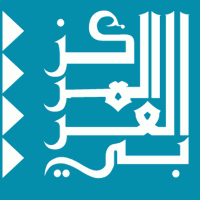تصاعد حدّة القمع الأمني في تونس يكشف عمق مأزق الرئيس
متظاهر في تونس يواجه شرطة مكافحة الشغب في ذكرى سقوط بن علي (14/1/2022/Getty)
بعد مرور نحو ستة أشهر على الانقلاب الرئاسي على الدستور في تونس، ومُضيّ الرئيس قيس سعيّد، قُدمًا، في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحها للمرحلة القادمة، والتي تهدف إلى تغيير الدستور لتعزيز سلطاته، أخذت جبهة المعارضة تتسع بانضمام مزيد من الشرائح الاجتماعية والقطاعات المهنية، وانخراط أحزاب وتيارات سياسية جديدة في الحراك المدني المناهض للرئيس، بالتوازي مع دخول الأزمة المالية والاجتماعية مرحلةً تنذر بتداعيات خطِرة.
تصاعد حدّة القمع الأمني
مثّل تعاملُ السلطات مع الفعاليات التي دعا إليها حراكُ "مواطنون ضد الانقلاب"، وحزب العمال، وتحالف "الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية" (يضم التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري)، وشخصياتٌ اعتبارية ومثقفون وأكاديميون، بمناسبة ذكرى الثورة، تحوّلًا في مواجهة الحراك المعارض. ومع أن جميع التحركات الاحتجاجية السابقة قوبلت بأشكال عدة من التضييق والمنع وقَطْع الطرقات وعرقلة وصول المتظاهرين إلى وسط العاصمة، فإن المنسوب العالي من العنف الذي تعاملت به قوى الأمن مع المتظاهرين في العاصمة، يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2022، يُعد تحولًا لافتًا للانتباه.
وما إن أعلنت القوى المعارضة قرارها المتمثّل بتنظيم مسيرات في شارع الثورة، وسط العاصمة، بمناسبة ذكرى الثورة، حتى سارعت حكومة الرئيس سعيّد إلى منع التجمعات والتظاهرات. ورغم أن بيان الحكومة برّر القرار بالعمل على احتواء الموجة الجديدة لجائحة "كورونا" (كوفيد - 19)، فإنّ الحراك المعارض رأى في تزامن القرار مع الدعوات التي أُطلقت للاحتجاج على إجراءات الرئيس سعيّد واقتصار الحظر على التظاهرات والإبقاء على المدارس والجامعات والمطاعم والمقاهي مفتوحة، رغم الاكتظاظ الذي تشهده، استهدافًا خفيًّا للتحرّكات المبرمجة.
قوبل العنف ضد المتظاهرين السلميّين بمناسبة ذكرى الثورة بحملة استنكارٍ واسعة، وأجّج المعارضةَ تجاه سياسات الحكومة
عمدت قوى الأمن، يوم 14 كانون الثاني/ يناير، مبكرًا، إلى إقامة حواجز أمنية لمنع الوصول إلى وسط العاصمة؛ ما اضطرّ المحتجّين إلى التجمع في الشوارع الفرعية، حيث لاحقتهم الشرطة، بأعداد كبيرة، مستخدمةً الهراوات، والغاز المسيل للدموع، والدرّاجات النارية، وخراطيم المياه الملوثة والممزوجة بالغاز والمواد الكيماوية الحارقة، وشنّت حملة اعتقالات امتدّت إلى عشرات الناشطين، وشملت الاعتداءات الصحافيين والمارّة وناشطي الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وأدّت إلى سقوط قتيل أُعلن عن وفاته بعد أيام من اختفائه. وقد أرجعت السلطات أسباب وفاته إلى جلطة دماغية، في حين أكّد المحتجون وجماعات سياسية وحقوقية تعرّضه للتعنيف قبل اعتقاله، وجرى تداول صُورٍ وأشرطة فيديو للحظة إصابته في المظاهرة.
قوبل العنف ضد المتظاهرين السلميّين بمناسبة ذكرى الثورة بحملة استنكارٍ واسعة، وأجّج المعارضةَ تجاه سياسات الحكومة؛ إذ ندَّد حزب التيار الديمقراطي، وحزب التكتل، والحزب الجمهوري، في بيان مشترك، بـ "القمع الممنهج وبتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب"، مع تحميل "رأس سلطة الانقلاب قيس سعيّد ووزير داخليته توفيق شرف الدين" مسؤوليةَ ذلك. أما النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فاعتبرت أنّ ما جرى إمعانٌ في استخدام "الخيارات القمعية في إدارة الشأن العام لسلطة تقاعست في مواجهة الفساد والإرهاب والفقر والتهميش". وأصدرت نقابة الصحفيين بيانًا مشتركًا مع 21 منظمة حقوقية، من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومحامون بلا حدود، اعتُبر فيه أن "توظيف الأمن في التصدّي لمناهضة سياسة رئيس الدولة لن تثني معارضيه عن مواصلة الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل التغيير والمحافظة على مكسب الديمقراطية والحريات العامة التي افتكها الشعب بالشوارع"، وتعهّدت جهات البيان بأن "تظل يقظة من أجل التصدي لسطوة البوليس والنقابات الأمنية".
ندّدت رئاسة مجلس النواب، أيضًا، بـ "الاعتداءات السافرة التي مسّت قيادات سياسية ومدنية ومواطنين نزلوا للتعبير عن آرائهم مدنيًا وسلميًا"، مؤكّدةً أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية". ودانت حركة النهضة "منع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم والوصول إلى شارع الثورة والاعتداء على الرموز السياسية الوطنية وتسليط أشكال متنوعة من العنف البوليسي ضدهم"، مطالبةً بـ "وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والتعدّي على الحريات، وخاصة حرية التعبير، وإطلاق سراح الموقوفين وتمكين الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب والمحامين من الوصول إليهم ومعاينة حالتهم".
باستحواذ الرئيس على جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية، لم يبقَ خارج سلطته سوى القضاء، ويسعى جاهدًا إلى احتوائه
معركة القضاء
مع أن هجوم سعيّد على السلطة القضائية بدأ منذ ليلة الانقلاب بإعلانه تولّي النيابة العامة بنفسه، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغط المجلس الأعلى للقضاء، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت منحىً تصعيديًّا في لهجته. ففي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، أصدر سعيّد مرسومًا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، وينصّ على "وضع حدٍّ للمنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".
قوبل قرار سعيّد باستهداف المجلس الأعلى للقضاء، من خلال حرمان أعضائه من مِنَحِهم، بدعوة المجلس القضاة إلى "التمسّك باستقلاليتهم"، وإدانة "التدخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج ضدهم"، والتنبيه إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المراسيم"، مع تأكيد "تمسّكه بصلاحياته الترتيبية"، و"مواصلة أداء مهامه دفاعًا عن استقلال القضاء".
والواقع أن الرئيس، باستحواذه على جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية، لم يبقَ خارج سلطته سوى القضاء، وأنّه يسعى جاهدًا إلى احتوائه؛ إذ أكد سعيّد في أكثر من مناسبة رفصه أحد أهم مقومات النظام الديمقراطي، وهو استقلال القضاء، بنفيه أنّ القضاء سلطة مستقلة، واعتباره إيّاه إدارةً من إدارات الدولة، وأنه لا دور له سوى تطبيق القوانين التي تصدرها السلطات؛ وهي في الحالة التونسية الراهنة المراسيم الصادرة عن الرئيس سعيّد نفسِه، أي إنّ الرئيس يريد أن يكون القضاة موظفين عنده. ويجد الخطاب المتوتر للرئيس تجاه السلطة القضائية مبرّراته في أحكام أصدرتها دوائر قضائية، في المدة الأخيرة، أُطلق بمقتضاها سراح عدد من المعارضين الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالإساءة إلى الرئيس، وأُبطلت بمقتضاها أيضًا قرارات اتخذتها وزارة الداخلية متمثّلة بوضع ناشطين سياسيين تحت الإقامة الجبرية.
معركة الإعلام
لم يكُن قطاع الإعلام بمنأى من الحرب التي يشنها الرئيس سعيّد على جبهات متعدّدة. فقد وجّه، في مناسبات سابقة، انتقادات لوسائل الإعلام المملوكة للدولة وطالبها بتعديل خطّها التحريري ومَنْح نشاطاته أولويةً في التغطية الإعلامية، ولم يفوّت أيَّ فرصة للتذكير بأن الإعلام، بحسب رأيه، على غرار القضاء ومؤسسات أخرى، خاضع للفاسدين واللوبيات والجهات السياسية. والحقيقة أن موقف وسائل الإعلام السلبي، وعدم تحمّله مسؤوليته في الدفاع عن الديمقراطية، يُعدّان من أهم أسباب وصول سعيّد إلى السلطة.
لوحظ في الآونة الأخيرة خُلوّ البرامج السياسية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية من أي مشاركة للأحزاب؛ بما فيها الأحزاب المؤيدة لسعيّد
تزايدت في الأسابيع الأخيرة وتيرة الاعتداءات والتضييق على الإعلام، وعلى الإعلاميين بالتوازي مع تصاعد لهجة الرئيس ضدهم. ففي 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، تعرض أكثر من عشرين صحافيًّا للتعنيف على يد قوى الأمن أثناء تغطيتهم المسيرات التي دعت إليها المعارضة، رغم حملهم شارات تدل على هويتهم المهنية. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، حاصرت قوة أمنية على متن عشرات العربات؛ من بينها عربات تابعة لوحدة مكافحة الإرهاب، في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري أيضًا، مقر التلفزيون الرسمي، واقتحمته، ودخل أفراد منها قاعة البث، وأجبروا العاملين على إلغاء إضراب كانوا يعتزمون تنفيذه.
وفي سياق توجيه خط الإعلام التحريري على نحو يخدم توجّه الرئيس لوضع جميع مرافق الدولة في خدمة مشروعه، ومحاصرة أي صوتٍ معارض له، أصدرت رئاسة الجمهورية تعليماتٍ لمحطات التلفزيون والإذاعات الرسمية متعلقة بمنع منتسبي الأحزاب السياسية من دخول مقارّها أو المشاركة في برامجها؛ وهو أمرٌ غير مسبوق منذ ثورة 2011. ورغم أن مديرة التلفزيون الرسمي نفَت وجود مثل هذه التعليمات، فإن أكثر من جهةٍ أكدت ذلك؛ إذ أكّد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا الأمر، ووصف الإجراء بأنه "يهدّد بشكل خطير حرية الصحافة ويكرّس النزعة الفردية في السلطة". وما يؤكد توجيه مثل هذه التعليمات إصدار حركة الشعب؛ المؤيدة لسعيّد، بيانًا عبّرت فيه عن "استغرابها من هذا القرار الذي يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي هو ملك لجميع التونسيّين والتونسيات". وقد لوحظ في الآونة الأخيرة خُلوّ البرامج السياسية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية من أي مشاركة للأحزاب؛ بما فيها الأحزاب المؤيدة لسعيّد، في مقابل تخصيص مساحة لتغطية كلمات الرئيس وبثّها كاملة.
انكشاف مأزق الرئيس
يُظهِر تتبُّع الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، منحى تصاعديًّا في توجهها؛ إذ انطلقت بتجميد مؤقت لعمل مجلس النواب، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة بعد الثورة؛ بما فيها حرية التعبير والتظاهر، لتصل، بعد ستة أشهر، إلى تجميد نهائي لمجلس النواب، وتعليق جلّ فصول الدستور، ومصادرة جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، والتضييق على استقلالية القضاء، ومحاصرة الإعلام، وقمع حرية التظاهر والتعبير، ومحاصرة العمل الحزبي.
ومع أن المدى الذي ذهب إليه الرئيس أثار استغرابًا في بعض الأوساط التونسية التي أيدته في البداية، فإنّ المتتبع لخطابه وسلوكه السياسي يدرك أنه كان ذاهبًا في هذا الاتجاه منذ لحظة الانقلاب على الدستور.
لم يبقَ من الأحزاب التي تدعم سعيّد سوى حركة الشعب، ومكونات حزبية أخرى لا تحظى بأيّ تمثيل برلماني أو دعم شعبي
لا شك في أن التجاذبات الحزبية والبرلمانية، وفشل الحكومات المتعاقبة في إحداث نقلةٍ ملموسةٍ في الوضع المعيشي، قد هيَّآ الأرضية للانقلاب على الدستور، ودفعَا شرائح اجتماعية متعدّدة إلى تأييد إجراءات سعيّد، في البداية، أملًا أن يحصل تغيير إيجابي، لكنّ الشهور الستة التي تلَت الانقلاب كشفت عن محدودية أفق الخطاب والسلوك الشعبوي الذي يعتمده الرئيس، وعجزه عن الوفاء بوعوده؛ فقد ازدادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءًا. ويُتوقَّع، وفق المؤشرات المتوافرة، أن تكون المرحلة القادمة أشد صعوبةً في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها الميزانية العامة، وتفاقم العجز وارتفاع المديونية، وحذّر المموّلين الخارجيين وصعوبة الشروط التي يفرضونها للمضيّ في أي عملية إقراض.
في ضوء تراجع مستوى التأييد السياسي والحزبي للرئيس؛ إذ لم يبقَ من الأحزاب التي تدعمه سوى حركة الشعب، ومكونات حزبية أخرى لا تحظى بأيّ تمثيل برلماني أو دعم شعبي، وفي ضوء الإحباط الذي أصاب قاعدة دعمه الاجتماعية أيضًا؛ بسبب تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية، وهو ما بدا في فشل التنسيقيات المؤيدة له في تنظيم أي فعالياتٍ تُذكر، يُتوقَّع أن يزداد اعتماد سعيّد على أجهزة الأمن للتضييق على الإعلام والقضاء والهيئات الوطنية وقَمْع المُنتقدين لسياساته.
وقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سغما كونساي" (Sigma Conseil) تراجع مستوى ثقة التونسيين بالرئيس سعيّد في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021 أربع درجات (62%) عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر (66%)، وخمس عشرة درجة عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر (77%). وكما يشير الاستطلاع نفسه، فإن 47% من التونسيين المستجيبين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي يعتبرون أن تونس تسير في الطريق الخطأ.
في ضوء ذلك، يعتمد الرئيس في المرحلة الراهنة على انقسامات جبهة المعارضة وغياب الرؤية والقدرة لديها على حشد الفئات الشعبية التي مثّلت نقطة الارتكاز لثورة 2011. وعلى الرغم من أن سياسة الإقصاء والتشهير التي ينتهجها لم تَستثنِ أيَّ طرف؛ بما فيها الأطراف التي ساندته في البداية، فإنّ قوى المعارضة ما زالت أسيرةَ تجاذباتِها وحساباتها الأيديولوجية، وما زالت عاجزةً عن الاتفاق على مشروعٍ جامع للحفاظ على مكتسبات الثورة ووقف الاندفاع السريع نحو الحكم الفردي، لكنّ هذا الوضع لن يدوم طويلًا على الأرجح، في ظلّ انكشاف عجز الرئيس عن تغيير الواقع الذي زعم إنّه جاء لتغييره.