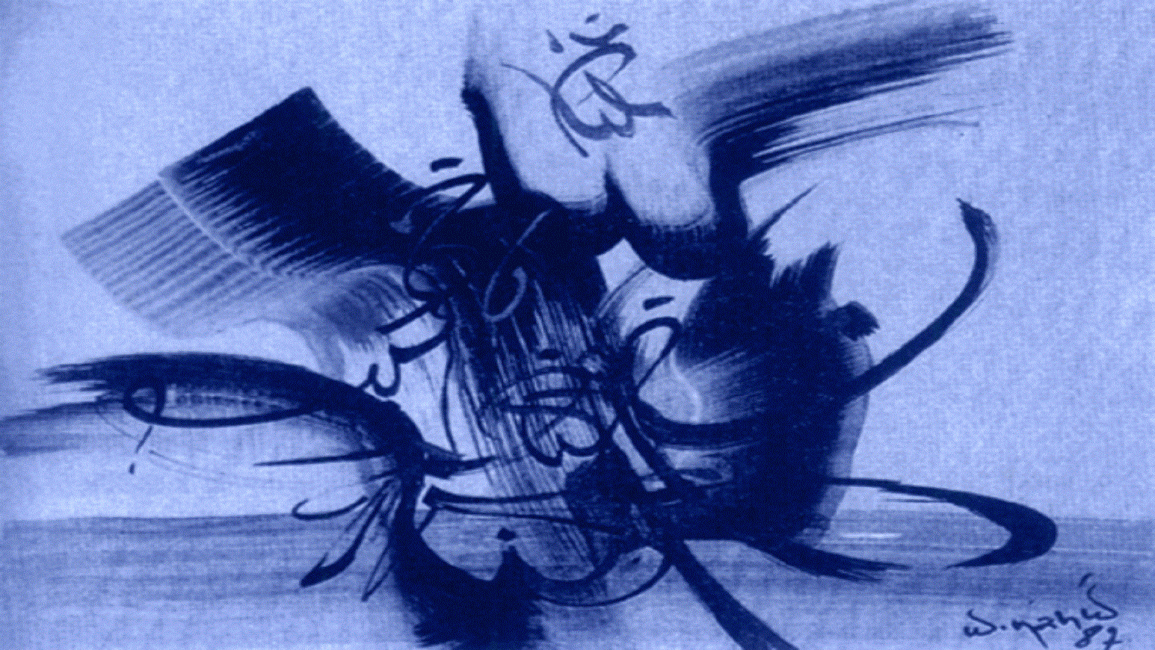قيمة الشهادة الجامعية في مصر
(وجيه نحلة)
في أوروبا والدول المتقدّمة، لا تقوم المجتمعات أو تنهض بالموظفين الإداريين والخبراء الأكاديميين، وإنما على أكتاف التطبيقيين المهنيين والفنيين. لذلك لا ينخرط في الدراسات الجامعية الأكاديمية إلا عدد محدود، وفي تخصصات معينة تتطلب تأهيلا أكاديميا عالي المستوى. وغالباً تنحصر هذه التخصّصات في القانون والطب والتربية. ومعروفٌ أن أصحاب تلك التخصّصات هم الأعلى دخلاً في كل الدول المتقدّمة. وعدا تلك المهن وقليل مثلها، لا يحتاج العاملون في مختلف الوظائف والمهن إلى تأهيل أكاديمي جامعي، وإنما فقط إلى تأهيل تخصّصي يستوفي الجوانب التطبيقية التي تتوافق مع سوق العمل واحتياجات المجتمع الفعلية.
في مصر المحروسة، ترسّخ منذ عقود طويلة وهم أن التعليم الجامعي هو فقط الجيد والضروري، ليس فقط للحصول على فرصة عمل متميّزة، وإنما أيضا قبل ذلك لتأمين قيمة أدبية واحترام لدى المجتمع. ورغم انحسار فرص العمل، وتوقف اضطلاع الدولة بدور المشغل لأولئك الحاصلين على مؤهلات عليا، إلا أن الصورة الذهنية للمؤهل الجامعي لم تتغيّر في المجتمع، خصوصا مع اقتران التعليم العالي بالتحضّر وتهذيب السلوك وتنمية الثقافة. مقابل اقتران شهادات التعليم قبل الجامعي، خصوصاً الفني، بتدهور ثقافي وأخلاقي، وتضاؤل تحضّر أصحابها. حتى صار من يحمل شهادة غير جامعية، في الذهنية العامة، يساوي الأُمّي غير المتعلم أساساً.
على التوازي، لم تعمل الحكومات المصرية المتعاقبة على تصحيح هذه الصورة. ولا حتى تعديل الميزان المختلّ في إدارة فرص العمل وضبط مخرجات التعليم حسب احتياجات سوق العمل، فاستمرأت التجاوب مع قناعات الطبقة المتوسطة وتطلعاتها نحو الوظائف ذات البريق، والتي تطوّرت من الطبيب والمهندس إلى المصرفي ورائد الأعمال والمرشد السياحي والمترجم اللغوي وأخصائي التغذية أو العلاج الطبيعي. من دون تقريب أو تكييف للمحتوى التعليمي، لا الجامعي ولا ما قبله، لخدمة هذه التخصّصات، وتأهيل كوادر مناسبة لها. وتدريجياً، صارت زيادة عدد الجامعات غاية نهائية، وليست هدفاً يجرى تخصيصه حسب التخصصات المطلوبة. وأصبحت كل الجامعات تتضمن التخصّصات التقليدية نفسها، المكرّرة غير المطلوبة في سوق العمل، خصوصاً علوم التجارة والقانون والآداب (فلسفة، اجتماع، تاريخ...). بل صارت الشهادات المتخصصة في التربية أو التعليم هي الأخرى عبئاً على أصحابها، بعد أن توقف التكليف الحكومي للمدرّسين، لعدم وجود موارد مالية.
على التوازي، تعرّض التعليم الفني قبل الجامعي لجريمة متكاملة بإهمال مؤسّساته ونظمه التعليمية والكوادر الخاصة به، حتى صار ملاذاً فقط لمن فشلوا في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام. وبدلاً من الاهتمام والارتقاء بالتعليم الفني، ليسدّ بمخرجاته حاجات سوق العمل المهني التي لا تحتاج، بالطبع، إلى تأهيل عالٍ يستلزم دراسة جامعية أربع سنوات. وقد سارت الحكومات المصرية أخيرا على نهج سابقاتها، فتركت التعليم الفني قبل الجامعي على حاله جثة هامدة. وراحت تُنشئ كلياتٍ فنيةً متخصّصة في قطاعات بعينها، وهي تحديداً الاتصالات والإلكترونيات. وأطلقت عليها كليات "تكنولوجية"، لتجذب إليها انتباه المجتمع المتمسّك بالشهادة الجامعية. وبدلاً من زيادة عدد هذه الكليات والتوسع في تخصّصاتها الفنية، حلا مؤقتا ومرحليا، إلى حين تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، تسير الحكومة المصرية الحالية على النهج نفسه بقبول مئات آلاف من الطلبة الجامعيين في الكليات التقليدية ذات التخصّصات النظرية والأدبية غير المطلوبة. لتُضاف تلك الأعداد الضخمة إلى طابور طويل يمتدّ إلى الوراء سنوات، بل عقود، اصطفّ خلالها الملايين من أصحاب المؤهّلات الجامعية العاطلين عن العمل. والغريب أنّ تلك الحكومة التي تبطش بالمواطنين وتطردهم من مساكنهم لإقامة منتجعات ترفيهية، هي نفسها التي تجاري المجتمع في التشبث بالشهادة الجامعية، رغم أن هذه الشهادة لم تعد ذات قيمة ولا مردود، لا على الدولة ولا المجتمع نفسه.