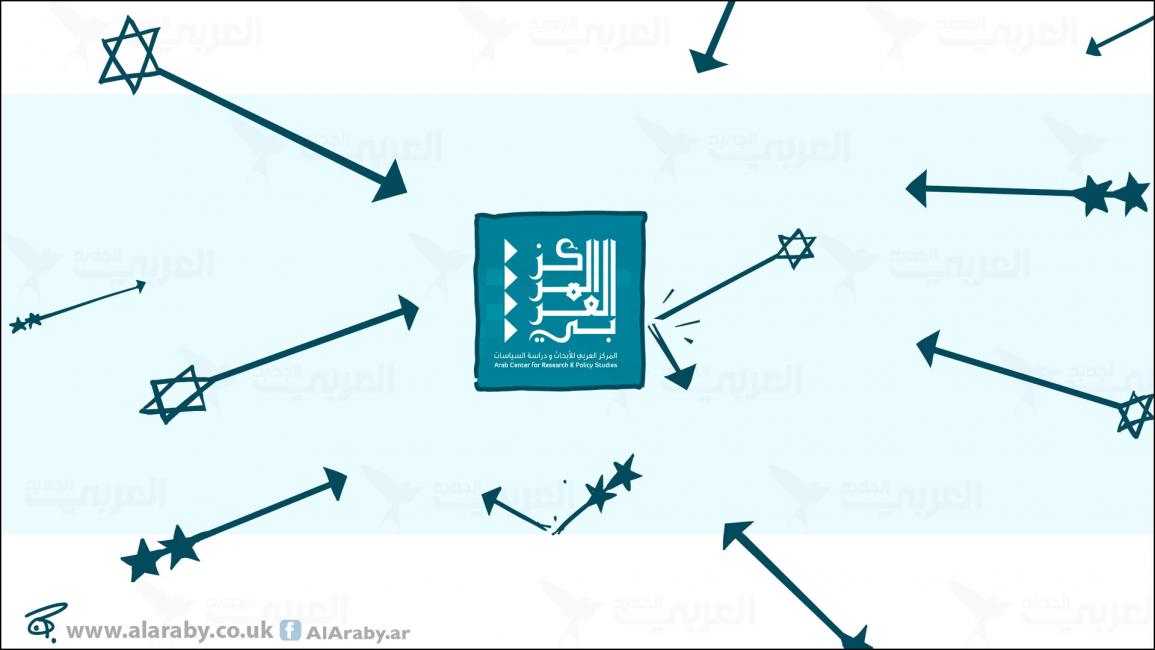02 نوفمبر 2024
في الأيديولوجيا القامعة
من المفارقات التي شابت حدث تشويش بعضهم على فعاليات مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات "استراتيجية المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي ونظام الأبارتهايد"، المنعقد أخيراً في تونس، أنّ المهاجمين رفعوا شعارات معارضة للتطبيع، والحال أنّ المؤتمر قائم أصلاً لمناهضة التطبيع، والبحث في استراتيجياتٍ ممكنةٍ لمواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية. ومن العجيب أنهم نعتوا الحاضرين بالخونة، والحال أنّ أغلب المشاركين لهم مساهماتهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر. ومن اللافت أنّ المشاغبين وصفوا ضيوف المؤتمر والمشرفين عليه بالرجعية، والحال أنّ لأغلب هؤلاء بصمات ومصنّفات في الفكر التقدّمي العربي. كما أنّ الجهة البحثية المنظمة لذلك الملتقى التفاكري أصدرت ما يزيد عن 150كتاباَ وخمس مجلّات دورية محكّمة في رصد حركة الفكر العربي المعاصر، وأبرز مشاغله وإحداثاته. والتعطيل المتعمّد لأشغال المؤتمر يتعارض ومبدأ الحرّية الأكاديمية وأساليب الاحتجاج العلمي على الرأي الآخر.
ويمكن، من منظور تحليلي أنتروبولوجي، اعتبار ذلك العمل الفوضوي الذي أقدمت عليه الجماعة، بما اعتراه من مفارقاتٍ عجيبة، فعلاً دالّا على وعي أيديولوجي مأزوم داخل السياق السياسي التونسي خصوصاً، والسياق العربي عموما. ومعالم الأزمة متمثلة في أنّنا إزاء متأدلجين لا يتعاملون مع الأيديولوجيا باعتبارها منظومةً من المبادئ والأفكار المنفتحة على الآخر، بل باعتبارها منظومةً مغلقة، ترتقي إلى مقام العقيدة، وتنبني على ادّعاء امتلاك الحقيقة والتأسيس للذات عبر تقويض الآخر. ومن هذا المنطلق، كان سلوك القلّة المشاغبة قائما على الاختزال والإقصاء في آن، فقد راهنت على ترويج وهم أيديولوجي، مفاده بأنّها تحتكر مشروع مناهضة التطبيع، والدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنّها مؤتمنة دون غيرها على عروبة فلسطين وتونس على السواء، وأنّ من خالفها الرأي أو المنهج في التعاطي مع تعقيدات النزاع العربي ـ الإسرائيلي، إنّما هو على ضلالةٍ أو على عمالةٍ أو غير ذلك من التهم المسبقة، والأحكام الجاهزة التي يستحضرها المتأدلج، لينسب ما يراه حقا لنفسه، وليسفّه الآخرين. وهذا التوجّه العصبوي يحمل طيّه رغبةً في الوصاية على الناس، وسعياً إلى مصادرة اختلافهم، وإحلال ثقافةٍ نمطيةٍ، شعاراتيّة، بديلا عن ثقافة التنوّع والتحليل، والمأسسة والمقاربات العقلانية الواقعية في قراءة الشأن الفلسطيني، وهو أمر غير مستغربٍ من جماعةٍ اختارت إعلان الوفاء لمعمّر القذّافي والولاء لبشار الأسد، في أثناء احتجاجها على المؤتمر، والاثنان معروفان بتفكيرهما الأحادي ونظامهما الحكمي الشمولي، وبارتكابه انتهاكاتٍ واسعة في حق معارضيه. وكلاهما استغلّ القضية الفلسطينية، ليظهر أمام شعبه في صورة البطل القومي الذي يدافع عن قضايا الأمّة وحقوقها. وفي المقابل، يمنع شعبه من حقه في التداول السلمي على السلطة، والعيش في كنف الحرّية والعدالة والديمقراطية...
وتلك مفارقة أخرى من مفارقات المنجز الأيديولوجي، القومي، العربي المعاصر، تحتاج إلى
مزيد التدبّر والنظر. وتمنّيت لو قرأ المشوّشون على المؤتمر ورقته الخلفية ومحامله الفكرية، ليبيّنوا محتواه وأهدافه، قبل أن يحتجّوا عليه بتلك الطريقة الفجّة التي تسيء لصورة تونس الديمقراطية بعد الثورة، وتمنّيت لو حضروا بطريقةٍ سلميةٍ، وجادلوا المتدخّلين أفكارهم، وناقشوهم تصوّراتهم، على نحو يساهم في إثراء حركة التلاقح الثقافي والتنافذ الفكري بين الحاضرين. كما تمنّيت لو اطّلع المتهجّمون على عزمي بشارة على بعض كتبه وإصداراته ومحاضراته في الشأن الفلسطيني، وفي الانحياز إلى الشعوب العربية المضطهدة، والتنظير لمشروع مجتمع مدني ديمقراطي، عربي، حتّى يتبيّن لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن الظاهر أنّ غلبة الهوى الأيديولوجي تجعل بعضهم لا يرى الأمور إلّا بعينٍ واحدة، فيعيش العمر كلّه محروماً من متعة الاطلاع على فكر الآخر ومحاورته، والتفاعل معه والإفادة منه.
والواقع أنّ الأيديولوجيا هنا تصبح سلطةً قامعة للذات والآخر في آن، فالأنا المتأدلجة تجد نفسها مسيّجةً بأسوار التعصّب الأيديولوجي السميكة، وغير قادرةٍ على توظيف قدراتها الذهنية في رؤية الأشياء والظواهر من منظور متعدّد الأبعاد، والآخر يجد نفسه موضوع إقصاء منهجي، أو ضحيّة تعصّب عشوائي، من جمهور المتأدلجين الراديكاليين. والناظر في سيرة الجماعات الحيّة المتقدّمة، يجدها طوّرت تمثلاتها الأيديولوجية، أو جعلتها أكثر مرونة ومواكبة لمستجدّات الواقع، في حين دخلت جماعاتٌ أخرى عصر ما بعد الأيديولوجيا، لوعيها بقيمة ثقافة الاختلاف وقصور العقل الأيديولوجي المغلق.
أمّا في السياق العربي عموما، والتونسي خصوصاً، فقد اتجهت أغلب الأعمال النقدية والجهود البحثية الأكاديمية إلى نقد التراث السياسي والفقهي، وإلى التركيز على نقد الإسلاميين الذين دُفع بعضهم، بسبب الحكم أو المحن أو المعارضة، إلى القيام بمراجعات جزئية، محدودة. وفي المقابل، مازال المنجز الأيديولوجي، العلماني العربي المعاصر، بتفريعاته المختلفة، بعيداً عن مجهر النقد والتقويم والمراجعة، وهو ما ساهم في ارتهان ناسٍ كثيرين إلى قوالب أيديولوجية كلاسيكية، وشعارات طوباوية بالية، زادت من تفريق المواطنين وجعلتهم رهائن للطائفية الأيديولوجية... لذلك، من المهمّ اليوم إعادة بناء المنجز الأيديولوجي وتطويره ونقده، والتوجه نحو دمقرطة التفكير واحترام الغيرية، تأسيساً لمجتمع مدني حرّ.
ويمكن، من منظور تحليلي أنتروبولوجي، اعتبار ذلك العمل الفوضوي الذي أقدمت عليه الجماعة، بما اعتراه من مفارقاتٍ عجيبة، فعلاً دالّا على وعي أيديولوجي مأزوم داخل السياق السياسي التونسي خصوصاً، والسياق العربي عموما. ومعالم الأزمة متمثلة في أنّنا إزاء متأدلجين لا يتعاملون مع الأيديولوجيا باعتبارها منظومةً من المبادئ والأفكار المنفتحة على الآخر، بل باعتبارها منظومةً مغلقة، ترتقي إلى مقام العقيدة، وتنبني على ادّعاء امتلاك الحقيقة والتأسيس للذات عبر تقويض الآخر. ومن هذا المنطلق، كان سلوك القلّة المشاغبة قائما على الاختزال والإقصاء في آن، فقد راهنت على ترويج وهم أيديولوجي، مفاده بأنّها تحتكر مشروع مناهضة التطبيع، والدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنّها مؤتمنة دون غيرها على عروبة فلسطين وتونس على السواء، وأنّ من خالفها الرأي أو المنهج في التعاطي مع تعقيدات النزاع العربي ـ الإسرائيلي، إنّما هو على ضلالةٍ أو على عمالةٍ أو غير ذلك من التهم المسبقة، والأحكام الجاهزة التي يستحضرها المتأدلج، لينسب ما يراه حقا لنفسه، وليسفّه الآخرين. وهذا التوجّه العصبوي يحمل طيّه رغبةً في الوصاية على الناس، وسعياً إلى مصادرة اختلافهم، وإحلال ثقافةٍ نمطيةٍ، شعاراتيّة، بديلا عن ثقافة التنوّع والتحليل، والمأسسة والمقاربات العقلانية الواقعية في قراءة الشأن الفلسطيني، وهو أمر غير مستغربٍ من جماعةٍ اختارت إعلان الوفاء لمعمّر القذّافي والولاء لبشار الأسد، في أثناء احتجاجها على المؤتمر، والاثنان معروفان بتفكيرهما الأحادي ونظامهما الحكمي الشمولي، وبارتكابه انتهاكاتٍ واسعة في حق معارضيه. وكلاهما استغلّ القضية الفلسطينية، ليظهر أمام شعبه في صورة البطل القومي الذي يدافع عن قضايا الأمّة وحقوقها. وفي المقابل، يمنع شعبه من حقه في التداول السلمي على السلطة، والعيش في كنف الحرّية والعدالة والديمقراطية...
وتلك مفارقة أخرى من مفارقات المنجز الأيديولوجي، القومي، العربي المعاصر، تحتاج إلى
والواقع أنّ الأيديولوجيا هنا تصبح سلطةً قامعة للذات والآخر في آن، فالأنا المتأدلجة تجد نفسها مسيّجةً بأسوار التعصّب الأيديولوجي السميكة، وغير قادرةٍ على توظيف قدراتها الذهنية في رؤية الأشياء والظواهر من منظور متعدّد الأبعاد، والآخر يجد نفسه موضوع إقصاء منهجي، أو ضحيّة تعصّب عشوائي، من جمهور المتأدلجين الراديكاليين. والناظر في سيرة الجماعات الحيّة المتقدّمة، يجدها طوّرت تمثلاتها الأيديولوجية، أو جعلتها أكثر مرونة ومواكبة لمستجدّات الواقع، في حين دخلت جماعاتٌ أخرى عصر ما بعد الأيديولوجيا، لوعيها بقيمة ثقافة الاختلاف وقصور العقل الأيديولوجي المغلق.
أمّا في السياق العربي عموما، والتونسي خصوصاً، فقد اتجهت أغلب الأعمال النقدية والجهود البحثية الأكاديمية إلى نقد التراث السياسي والفقهي، وإلى التركيز على نقد الإسلاميين الذين دُفع بعضهم، بسبب الحكم أو المحن أو المعارضة، إلى القيام بمراجعات جزئية، محدودة. وفي المقابل، مازال المنجز الأيديولوجي، العلماني العربي المعاصر، بتفريعاته المختلفة، بعيداً عن مجهر النقد والتقويم والمراجعة، وهو ما ساهم في ارتهان ناسٍ كثيرين إلى قوالب أيديولوجية كلاسيكية، وشعارات طوباوية بالية، زادت من تفريق المواطنين وجعلتهم رهائن للطائفية الأيديولوجية... لذلك، من المهمّ اليوم إعادة بناء المنجز الأيديولوجي وتطويره ونقده، والتوجه نحو دمقرطة التفكير واحترام الغيرية، تأسيساً لمجتمع مدني حرّ.