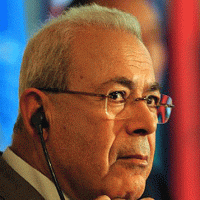02 سبتمبر 2024
المعارضة السورية أمام معركة مصيرها
مع غياب كامل للسوريين، في النظام والمعارضة، تم التوقيع في أستانة يوم 4 مايو/ أيار الجاري، على اتفاق خفض العنف الذي يشمل أربع مناطق، تضم أجزاء من محافظة إدلب واللاذقية وحماة وحلب وحمص ودرعا والقنيطرة. وهي المناطق التي تشكّل خطوط الجبهة الرئيسية المتبقية بين قوى المعارضة ومليشيات النظام السوري المتعدّدة الجنسيات. يهدف الاتفاق الذي تعتبره الدول الثلاث الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، "إجراءً مؤقتاً مدته ستة أشهر" قابلة للتمديد بموافقة الضامنين، إلى وقف أعمال العنف بين الأطراف المتنازعة، ووقف استخدام أي نوعٍ من السلاح، بما في ذلك طائرات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وتأهيل البنية التحتية، وتأمين الشروط المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين في العودة. ومن المفترض، حسب الاتفاق، أن تشكل الدول الضامنة قوات خاصة لإقامة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة المناطق الأمنية.
وباستثناء تعبير الخارجية الأميركية عن شكّها في إمكانية نجاح هذا الاتفاق الذي يجعل من طهران، حسب تعبيرها، ضامنة له، وهي أحد المسؤولين الرئيسيين عن استخدام العنف، كما يتجاهل سجل النظام السوري السيئ في تنفيذ الاتفاقات السابقة، لم تظهر ردود فعل ذات مغزى، لا عن الدول العربية الداعمة للمعارضة، ولا عن تجمع أصدقاء الشعب السوري، ولا ممثلي الأمم المتحدة.
لا ينبغي أن يكون لدى أي إنسان وهمٌ حول مغزى الاتفاق الذي وقعته الدول الثلاث التي أعلنت نفسها بشكل ذاتي، صاحبة المبادرة في إيجاد حل للنزاع السوري. وفي ما وراء ذلك، تأكيد وصايتها غير الشرعية على سورية، ورسم مستقبلها بغياب جميع الأطراف السورية
والدولية. وليس هناك من يعتقد بين الأطراف، الدولية والسورية جميعا، أن الهدف من هذا الاتفاق كان بالفعل تخفيف مستوى العنف، أو توفير المزيد من المذابح والأرواح البشرية، أو أنه جاء من وحي أي حافز أخلاقي أو إنساني، كما أن من المؤكد تقريبا أنه لن يكون في تطبيقه أفضل من الاتفاقات التي سبقته، وأنه سيستخدم، كما استخدم غيره، من أجل قضم مزيد من المواقع لقوات المعارضة، وتضييق الخناق عليها، بذريعة ضرورات فصلها عن الفصائل "الجهادية" والمتطرّفة، وأنه سوف يعمّق الشرخ القائم في ما بين أطرافها، وإنه لن يُحترم، في النهاية، إلا من جانبٍ واحد، وسيكون بالضرورة اتفاق الزوج المخدوع. فبصرف النظر عن الديباجة التبريرية، يندرج هذا الاتفاق في سياقٍ واضح، لا يزال يترسخ منذ أكثر من ثلاث سنوات، هو سياق تراجع المعارضة وانكفائها على خط الدفاع الذي لا تزال تقف عليه منذ عدة سنوات، وتنتقل فيه من مواقع متقدّمة إلى مواقع أكثر تراجعاً، على المستويين السياسي والعسكري. كما يندرج في سياق خسارة المعسكر الإقليمي والدولي المناصر للمعارضة تفوقه لصالح صعود المحور الروسي الإيراني الذي جعل من الممكن أن تدخل إيران في فريق الدول الراعية للاتفاق، ومن ورائه للحل، وهي الطرف الأكثر انخراطاً في الحرب ضد الثورة والمعارضة، وأن تتحول إلى ضامن لوقف النار والسلام، في وقتٍ تشكل مليشياتها القوة البرية الأولى في حماية معسكر النظام، بينما تبدو الدول العربية وجامعتها كما لو أنها قبلت بتهميشها تماماً، بما في ذلك الدول التي وقفت سنواتٍ طويلة إلى جانب المعارضة.
لكن في ما وراء ذلك، وأهم منه، أن هذا الاتفاق، الذي لا يختلف في جوهره وأهدافه عن الاتفاقات والمصالحات والهدن المحلية التي اعتمدها النظام خطة طويلة المدى لتفتيت المعارضة واحتوائها، جزء من الاستراتيجية الروسية العسكرية والسياسية التي سعت، بجميع الوسائل، وأهمها الطيران الحربي، إلى تغيير خريطة الصراع على الأرض، من خلال العمل على ضرب تواصل قوى المعارضة، وعزلها في مواقع ثابتة، وإنهاء الحقبة التي سيطر عليها الصراع الشامل، بين الثورة والمعارضة من جهة والنظام من جهة ثانية، ومن ثم إلى تحويل الثورة إلى بؤر تمرّد مغلقة، ومحاصرتها سياسيا، بعد أن تمت محاصرتها عسكريا، ومن وراء ذلك استعادة المبادرة وإعطاء التفوق والأسبقية لمليشيات النظام من جديد، بصرف النظر عن تناقضاته وخراب أركانه، وتهافت مرتكزاته وشرعيته.
أخطر ما جاء به هذا الاتفاق أنه أوحى للعالم، وللمجتمع الدولي، أننا لم نعد أمام قضية ثورة ضد نظام جائر ودموي، ولا حتى في مواجهة حرب أهلية شرسة، وإنما أمام دول ثلاث منخرطة في الصراع، تنسّق في ما بينها من أجل تمكين السلطة المركزية للدولة من استعادة سيطرتها على حركة (أو حركات) المعارضة والتمرّد التي وقفت في وجهها وقاومتها سنوات طويلة. وكذلك، أن طهران لم تعد أحد المسؤولين الرئيسيين عن تمويل الحرب، وتمديد أجل النزاع، وإنما جزءٌ من الحل، وأن الأمر قد تحوّل، منذ الآن، من أزمة سياسية مستعصية إلى مسألةٍ تقنية، تتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين فرق المراقبة الدولية المؤهلة للقيام بذلك. وبالفعل، بدأت تعليقات صحافية كثيرة تشير إلى هذا الاتفاق كما لو كان يمثل بداية الحل. وهذا ما يتماشى مع الخطة الروسية التي تريد أن تستفرد بالحل، وتفرض الصيغة التي تنسجم بشكل أكبر مع مصالحها ورهاناتها. هكذا ضعف وسيضعف أكثر شعور المجتمع الدولي بالحاجة العاجلة للبحث عن حلٍّ يرضي تطلعات السوريين الذين ثاروا على نظام الأسد الدموي، ولن يتساءل أحدٌ، بعد الآن، عما إذا كان هذا الاتفاق يقود نحو تسويةٍ سياسيةٍ فعليةٍ تتفق ومضمون قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإنما عما إذا كان من الممكن إنجاح الاتفاق ووقف إطلاق النار فحسب.
لم تخطئ فصائل المعارضة السورية، إذن، في رفضها التوقيع على الاتفاق إلى جانب الدول
الثلاث، احتجاجا على إدخال طهران طرفا ضامنا للحل السياسي والسلام، في حين أنها كانت، ولا تزال، المسؤول الأول عن قرار تمديد أجل الحرب، وخوضها حتى النهاية، والتي لا يخفي مسؤولوها حجم المجهود الحربي الهائل الذي قدّموه في قتال الشعب السوري، والسعي إلى القضاء على ثورته بأي ثمن، سواء على شكل قواتٍ برية مليشياوية، أو مساعدات مالية وسياسية ولوجستية. كما لم تخطئ الهيئة العليا للمفاوضات التي ذهبت إلى أبعد من ذلك، في إدانة الاتفاق، واعتبرته مقدمةً لتقسيم سورية.
يعكس هذا الرفض خوف أطراف المعارضة السورية من نتائج هذه الاتفاق، العسكرية والسياسية، وفي مقدمها تكريس الدول الثلاث راعيةً للحل السياسي في سورية، ومصادرة إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله، كما يعكس قلق السوريين والمعارضة من تطبيع دور إيران في سورية الحاضرة والجديدة، لكنه لا يمكن أن يشكل ردّا على الاتفاق الذي ستضطر الفصائل إلى احترام بنوده، وتطبيقه، مهما كان الأمر، خصوصاً أن تركيا التي "تمثل" الفصائل في هذا الاتفاق، وفي المفاوضات التي تجري في أستانة، هي شريك رئيسي في إعداده وأحد ضامنيه .
يحتاج وقف التدهور المتواصل في الموقف العسكري والسياسي لفصائل المعارضة ردّاً من نوع آخر، أي رداً استراتيجياً، لا يكتفي بردود الأفعال التي درجت على اتباعها في السنوات الطويلة الماضية، وكانت نتائجها ما وصل بها الحال اليوم من تراجعٍ مستمر وتفرّق وخصام. وهذا يعني، في الوضع الراهن، بناء استراتيجية مستقلة وفعالة للمقاومة من المعارضة والفصائل، تختلف عن التي اتبعتها في السنوات الماضية، والتي قامت على ردود الفعل والتسليم للأصدقاء والحلفاء والذهاب فصائل مشتتة إلى المفاوضات، وانتهت بها إلى طريق مسدود. وقد كانت من دون نقاش نموذجا لاستراتيجية الفشل التي لم يكفّ الرأي العام السوري، الثوري والمعارض، عن التنديد بها منذ سنوات، من دون أن يحصل على أي رد إيجابي من فصائل عسكرية، تدّعي التضحية من أجل الثورة وأهدافها، بينما ترفض أي مبادرةٍ لبناء جسم وطني عسكري واحد وقيادة موحدة مشتركة، عسكرية وسياسية، تعكس إرادة السوريين في التحرّر والمقاومة ورفض تأهيل النظام، وتعزّز موقفها الإقليمي والدولي بتأييدهم وثقتهم، فالشرط الأول لمنع الآخرين، من الدول والمؤسسات والتكتلات، من مصادرة قرار السوريين، والتفاوض عنهم والحلول محلهم، وقطع الطريق على تقسيم سورية، أو استخدام الاتفاقات الفنية، مثل اتفاق خفض العنف، أو إقامة المناطق الأمنية، والفصل بين الفصائل والجبهات، ذريعة للتمهيد لهذا التقسيم، هو توحيد قوى المعارضة والثورة السورية، وتحقيق وحدة قيادتها. كل ما دون ذلك من احتجاجات وإدانات وشكاوى يدخل في باب التعبير عن المشاعر والسخط، لكنه لا يشكل استراتيجيةً للمقاومة، وتأكيد التمسك بالقرار الوطني، ولا يغيّر كثيرا في المنحى التراجعي الذي يميّز مسيرة المعارضة اليوم. مع العلم أن هذا الاتفاق يشكل آخر امتحانٍ للمعارضة، وهو الذي سيقرّر مصيرها.
وباستثناء تعبير الخارجية الأميركية عن شكّها في إمكانية نجاح هذا الاتفاق الذي يجعل من طهران، حسب تعبيرها، ضامنة له، وهي أحد المسؤولين الرئيسيين عن استخدام العنف، كما يتجاهل سجل النظام السوري السيئ في تنفيذ الاتفاقات السابقة، لم تظهر ردود فعل ذات مغزى، لا عن الدول العربية الداعمة للمعارضة، ولا عن تجمع أصدقاء الشعب السوري، ولا ممثلي الأمم المتحدة.
لا ينبغي أن يكون لدى أي إنسان وهمٌ حول مغزى الاتفاق الذي وقعته الدول الثلاث التي أعلنت نفسها بشكل ذاتي، صاحبة المبادرة في إيجاد حل للنزاع السوري. وفي ما وراء ذلك، تأكيد وصايتها غير الشرعية على سورية، ورسم مستقبلها بغياب جميع الأطراف السورية
لكن في ما وراء ذلك، وأهم منه، أن هذا الاتفاق، الذي لا يختلف في جوهره وأهدافه عن الاتفاقات والمصالحات والهدن المحلية التي اعتمدها النظام خطة طويلة المدى لتفتيت المعارضة واحتوائها، جزء من الاستراتيجية الروسية العسكرية والسياسية التي سعت، بجميع الوسائل، وأهمها الطيران الحربي، إلى تغيير خريطة الصراع على الأرض، من خلال العمل على ضرب تواصل قوى المعارضة، وعزلها في مواقع ثابتة، وإنهاء الحقبة التي سيطر عليها الصراع الشامل، بين الثورة والمعارضة من جهة والنظام من جهة ثانية، ومن ثم إلى تحويل الثورة إلى بؤر تمرّد مغلقة، ومحاصرتها سياسيا، بعد أن تمت محاصرتها عسكريا، ومن وراء ذلك استعادة المبادرة وإعطاء التفوق والأسبقية لمليشيات النظام من جديد، بصرف النظر عن تناقضاته وخراب أركانه، وتهافت مرتكزاته وشرعيته.
أخطر ما جاء به هذا الاتفاق أنه أوحى للعالم، وللمجتمع الدولي، أننا لم نعد أمام قضية ثورة ضد نظام جائر ودموي، ولا حتى في مواجهة حرب أهلية شرسة، وإنما أمام دول ثلاث منخرطة في الصراع، تنسّق في ما بينها من أجل تمكين السلطة المركزية للدولة من استعادة سيطرتها على حركة (أو حركات) المعارضة والتمرّد التي وقفت في وجهها وقاومتها سنوات طويلة. وكذلك، أن طهران لم تعد أحد المسؤولين الرئيسيين عن تمويل الحرب، وتمديد أجل النزاع، وإنما جزءٌ من الحل، وأن الأمر قد تحوّل، منذ الآن، من أزمة سياسية مستعصية إلى مسألةٍ تقنية، تتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين فرق المراقبة الدولية المؤهلة للقيام بذلك. وبالفعل، بدأت تعليقات صحافية كثيرة تشير إلى هذا الاتفاق كما لو كان يمثل بداية الحل. وهذا ما يتماشى مع الخطة الروسية التي تريد أن تستفرد بالحل، وتفرض الصيغة التي تنسجم بشكل أكبر مع مصالحها ورهاناتها. هكذا ضعف وسيضعف أكثر شعور المجتمع الدولي بالحاجة العاجلة للبحث عن حلٍّ يرضي تطلعات السوريين الذين ثاروا على نظام الأسد الدموي، ولن يتساءل أحدٌ، بعد الآن، عما إذا كان هذا الاتفاق يقود نحو تسويةٍ سياسيةٍ فعليةٍ تتفق ومضمون قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإنما عما إذا كان من الممكن إنجاح الاتفاق ووقف إطلاق النار فحسب.
لم تخطئ فصائل المعارضة السورية، إذن، في رفضها التوقيع على الاتفاق إلى جانب الدول
يعكس هذا الرفض خوف أطراف المعارضة السورية من نتائج هذه الاتفاق، العسكرية والسياسية، وفي مقدمها تكريس الدول الثلاث راعيةً للحل السياسي في سورية، ومصادرة إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله، كما يعكس قلق السوريين والمعارضة من تطبيع دور إيران في سورية الحاضرة والجديدة، لكنه لا يمكن أن يشكل ردّا على الاتفاق الذي ستضطر الفصائل إلى احترام بنوده، وتطبيقه، مهما كان الأمر، خصوصاً أن تركيا التي "تمثل" الفصائل في هذا الاتفاق، وفي المفاوضات التي تجري في أستانة، هي شريك رئيسي في إعداده وأحد ضامنيه .
يحتاج وقف التدهور المتواصل في الموقف العسكري والسياسي لفصائل المعارضة ردّاً من نوع آخر، أي رداً استراتيجياً، لا يكتفي بردود الأفعال التي درجت على اتباعها في السنوات الطويلة الماضية، وكانت نتائجها ما وصل بها الحال اليوم من تراجعٍ مستمر وتفرّق وخصام. وهذا يعني، في الوضع الراهن، بناء استراتيجية مستقلة وفعالة للمقاومة من المعارضة والفصائل، تختلف عن التي اتبعتها في السنوات الماضية، والتي قامت على ردود الفعل والتسليم للأصدقاء والحلفاء والذهاب فصائل مشتتة إلى المفاوضات، وانتهت بها إلى طريق مسدود. وقد كانت من دون نقاش نموذجا لاستراتيجية الفشل التي لم يكفّ الرأي العام السوري، الثوري والمعارض، عن التنديد بها منذ سنوات، من دون أن يحصل على أي رد إيجابي من فصائل عسكرية، تدّعي التضحية من أجل الثورة وأهدافها، بينما ترفض أي مبادرةٍ لبناء جسم وطني عسكري واحد وقيادة موحدة مشتركة، عسكرية وسياسية، تعكس إرادة السوريين في التحرّر والمقاومة ورفض تأهيل النظام، وتعزّز موقفها الإقليمي والدولي بتأييدهم وثقتهم، فالشرط الأول لمنع الآخرين، من الدول والمؤسسات والتكتلات، من مصادرة قرار السوريين، والتفاوض عنهم والحلول محلهم، وقطع الطريق على تقسيم سورية، أو استخدام الاتفاقات الفنية، مثل اتفاق خفض العنف، أو إقامة المناطق الأمنية، والفصل بين الفصائل والجبهات، ذريعة للتمهيد لهذا التقسيم، هو توحيد قوى المعارضة والثورة السورية، وتحقيق وحدة قيادتها. كل ما دون ذلك من احتجاجات وإدانات وشكاوى يدخل في باب التعبير عن المشاعر والسخط، لكنه لا يشكل استراتيجيةً للمقاومة، وتأكيد التمسك بالقرار الوطني، ولا يغيّر كثيرا في المنحى التراجعي الذي يميّز مسيرة المعارضة اليوم. مع العلم أن هذا الاتفاق يشكل آخر امتحانٍ للمعارضة، وهو الذي سيقرّر مصيرها.