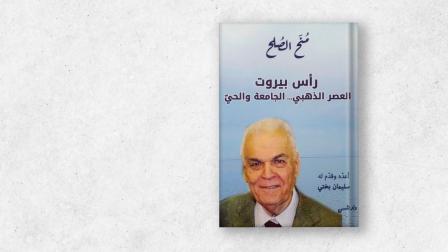يتصدى كتاب "مديح البياض: في الخطاب الفلسطيني الممنوع" للشاعر والروائي والناقد الفلسطيني محمد الأسعد، الصادر هذا الشهر عن "دار الفارابي"، لدور التأريخ الثقافي، ويرسم المشهد الثقافي الفلسطيني من خلال شبكة العلاقات التي تحكمه ومناخاته، مستعملاً أدوات المؤرّخ والمبدع والصحافي في آن.
يضيء الأسعد في كتابه -الذي يعتمد على مقالات للمؤلف ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي- كواليس الحياة الثقافية الفلسطينية، في خضم تفاعلات المؤسّسات والشخصيّات.
يدرس مثلاً انعكاس ما كان يحدث في "منظمة التحرير الفلسطينية" على "اتحاد الكتاب الفلسطينيين"، في مقال "نبات الظل" والذي يطرح فيه نظرية طريفة حول المثقف الفلسطيني منطلقاً من حيثيات "مؤتمر صنعاء" (1984) التي كان شاهداً عليها وناقداً لها.
يقول الأسعد: "أمام الكاتب أو الفنان الفلسطيني المبدع طريقان لتحقيق وجوده كفنّان؛ الطريق الأول اعتماده على جهده الذاتي في بناء نفسه وخوض صراع البقاء منفرداً لتحقيق ما يطمح إليه من تأثير في الوسط الفلسطيني والعربي والعالمي".
ويضيف: "في مثل هذا الطريق يتعرّض الفنّانُ لأعاصير الطبيعة الاجتماعية والسياسية من دون حماية تقريباً، وينمو هكذا معتمداً على التربة الطبيعية، أي الوسط الاجتماعي الشعبي، وعلى الهواء النقي والشمس الطبيعية بحرّها وبردها".

أما الطريق الثاني، والذي يعتبر الأسعد -قبل ثلاثة عقود- أن محمود درويش هو نموذجه الأبرز، ويخص هذا النموذج بنقد لاذع: "طريق الاعتماد على الرعاية الخارجية، رعاية توفّرها المؤسسة أو الحزب أو المنظمة، بكل ما تتضمّنه هذه الرعاية من تجهيز وتسويق ونسج علاقات وبث إيحاءات في مختلف الاتجاهات".
هنا يُعرّج صاحب "أطفال الندى" على تحليل الدور الثقافي الذي كانت تلعبه منظمة التحرير، إذ كتب آنذاك: "مثلت أجهزة منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشوئها هذا الدور بشكل ملحوظ، دور التأثيث والتسويق والتجهيز".
بعد ذلك، يستكمل الأسعد تشريحه لمثقف الطريق الثاني، حيث "لا يتعرّض الفنان أو الكاتب إلى الأعاصير، ولا ينمو في تربة طبيعية. إنه ينمو في بيت زجاجي تحميه المحرّمات، تماماً مثل نبات الظل الذي تحيط به الأضواءُ الصناعية فتزيده تألقاً، وتشتغل أجهزة التكييف لتحافظ على درجة حرارة مناسبة لحساسيته، إذ إن نبات الظلّ مصاب بالحساسية ضد أي طارئ من عالم ما وراء الزجاج".
من خلال هذه الطريقة في النظر إلى الأشياء، نقرأ بقية مقالات عمل الأسعد، والتي تبرز فيها شخصية ناجي العلي كشخصية محورية تدور حولها الأسماء والمواقف والمواضيع، ومن خلالها نكتشف بقية وجوه المشهد الثقافي الفلسطيني ومواقعهم وخلفياتهم. بل يمكن القول أنه كتاب عن ناجي العلي وفنّه مكتوب من ناقد عاصره وجمعته به أكثر من وشيجة.
لعل من أروع ما كُتب عن صاحب حنظلة هذه الكلمات للأسعد التي نقرؤها في مقال "ناجي.. أيها المدهش" (30 يوليو 1987) حين يقول: "سانتياغو نصّار الذي ابتكره غارثيا ماركيث هو الوحيد الذي مضى إلى موته تحت الضوء، والوحيد الذي راقب الجميع موته المعلن. وناجي ليس ابتكار مؤلف بل ابتكار شعب، ولذا لم يكن يعرف موعد اغتياله فقط، بل ملامح الجناة أيضاً".
يعرّج الأسعد، طيّ هذا الكتاب، على انتقادات جمة للمشهد الثقافي، أو يطرح الأسئلة التي طالما انشغل أو سكت عنها بقية المثقفين، كسؤاله عن سبب عدم قراءة العالم لنا. عموماً، ونحن نقرأ هذا العمل سنقول مثلما قال الأسعد في مقاله "تطبيع العقل الفلسطيني": "لقد تأخر هذا المقال كثيراً".