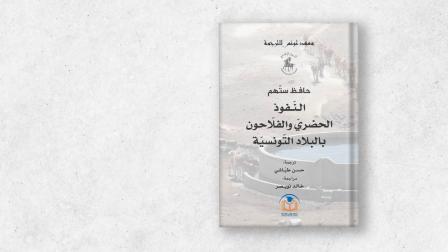في بداية التحديث العربي، منذ منتصف القرن التاسع عشر تحديداً، اعتقد بعض الراغبين في التحديث والتجديد، أن إحياء القديم يوفر للإنسان العربي قاعدة أساسية يطوّر منها "حداثته" في شتى الشؤون الفكرية، ولم يتخذ من مبتكرات القديم المادية أساساً، لأن ليس هناك من عاقل يعتقد بجدوى تسليح الجيوش بالمنجنيق أو إحياء قوافل التوابل والحرير، أو حفر الآبار في الصحراء، أو إحياء مهنة الوراقين وتربية الحمام الزاجل.
ومع ذلك بدا أن تقديس من كانوا يُسمّون حتى ذلك الزمن، وفي بعض زوايا الزمن الراهن أيضاً، بالأوائل، والمتقدّمين، امتدّ إلى مجالات الفكر والشعور بما يشبه العودة إلى تربية الحمام الزاجل، واستخدام المنجنيق، والسيف والرمح، وتسيير القوافل، في هذه المجالات الفكرية والفنية والأدبية.
وتحوّل "الأوائلُ" إلى آباءٍ للحداثة العربية إذا أريد لها أن تكون "أصيلة" كما زعموا، على أساس أن "المتأخرين"، أي نحن سكان الحاضر، لا بد أن تكون حداثتنا سليلة ذلك "المحدث" بزمنه ومستوياته المعرفية وغاياته وطرائقه، بل وطرائفه أيضاً.
ولماذا؟ لأن هناك مطلق حداثة، وبإمكان كاتب "متأخر" يعيش في القرن العشرين أن يكتشف نسباً بين شاعر فرنسي مثل بودلير وشاعر عباسي مثل أبو تمام، وقل مثل ذلك عن شخصيات أخرى تعايشت في أذهان بعض دعاة الحداثة العرب على رغم اختلاف أزمنتها وأمكنتها. بل وبإمكان أي قبيلة معزولة أن تتحدث عن "حداثتها"، وتلتمس شيئاً من ملامحها "الأصيلة" في العصر الحجري، ما دامت صناعة واستخدام فأس حجرية تعتبر حداثة مقارنة باستخدام شظايا حجرية عادية، ويمكن أن تقف هذه القبيلة في مطلع القرن الحادي والعشرين وتفاخر الحضارة المعاصرة بتقنيتها "الحداثية" تلك، بل وحقها في أن تكون متقدمة، في الطليعة دائماً، في التصوّر والفعل.
هذا النحو من الفكر لم ينحسر تماماً، بل نجده يعود بين فترة وأخرى، ويعيد التناشز إلى الحياة، ويشقق جغرافية وجودنا المعنوي والمادي. حين نودّ معرفة أصول التقانات المعاصرة وتعليمها نلجأ إلى الفكر العلمي المعاصر، ولكن حين نود معرفة أصول تقلّباتنا الفكرية وأوهامنا، والخروج من كهف أفلاطون الذي لا نرى العالم على جدرانه بل نرى أشباحه، نلجأ إلى جمهرةٍ من سادة أقبية الماضي الذين قدمناهم كأوائل، ووقفنا خلفهم بوصفنا أواخر!
الأمر لم يعد يحتمل مغالطة من هذا النوع، وتناشزاً، لأن الحداثة التي ضربت ولا تزال تضرب جدران الكهوف الحجرية، وأكواخ القش والطين، وتقتلع الأطناب والأوتاد، وحتى أنفاق الخلندات العمياء، محددة بزمن ومستويات معرفية وطموحات وصلها الإنسان على سلم "تقدّمه".
بهذا المعنى ليس ثمة مقياس إلا مقياس الحضارة المعاصرة للحداثة، بكل جوانبها السلبية والإيجابية. وليس هناك ما يفرض، منطقياً، أن تكون شروط الزمن الراهن ذات صلة نسب، أبوة أو بنوة، بما سبقها من شروط أزمنة غابرة. المنطقي والماثل حالياً قيام قطيعة معرفية، وخاصة في وسط يعتبر الماضي "متقدماً" و"الحاضر" متخلفاً، مع كل أشكال ترويج تربية الحمام الزاجل وصناعة المنجنيق في عالم الفكر. وهذا هو أساس كل حداثة.
الحداثة الراهنة تعني قطيعة معرفية. هي حداثة المتقدمين والأوائل فعلاً، سكان الحاضر، وشروطها مختلفة عن شروط طرائف الجاحظ وتذمّر أبي حيان التوحيدي وخيالات الحلّاج. أفقها أوسع، مفتوح على نهضات علمية وفكرية ورؤى للإنسان وعالمه مختلفة جذرياً. هي سليلة جغرافية إنسانية بل وطبيعية مختلفة، تمازجت فيهما الأعراق واللغات والأمكنة، وألقت فيها ثورة الفيزياء الحديثة وشتى الثورات الفلسفية، أضواءً على جغرافية كون إنساني وطبيعي مجهول.
حداثة الأزمنة الراهنة تماثل الثورة، وكل ثورة من هذا القبيل، سواء كانت في الجماليات الأدبية أو الفنية أو النظريات العلمية، تقتضي حتماً إعادة النظر في ما ورثناه عمن يسمّون "الأوائل"، وإعادة تنظيم سياق الزمان والمكان مجدداً. من يلقي الضوء هنا وينير العقل الإنساني هو الحاضر، وليس الماضي كما جرى عليه التقليد.
بتشبيه بسيط؛ لو تخيلنا الماضي والحاضر على شكل منارتين، وسألنا من منهما تلقي ضوءاً على الأخرى، لهدانا الحس البسيط إلى أن منارة الحاضر الحي هي التي تضيء الماضي وليس العكس. من منارة الماضي لا تصل إلينا إلا ومضات شبيهة بومضات نجوم انطفأت منذ زمن سحيق، ولا تؤكد هذه الومضات إلا أن علينا أن نطلق أضواء منارتنا في اتجاه الماضي والمستقبل على حد سواء.