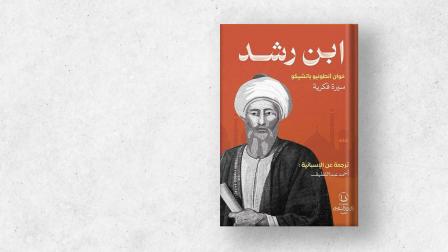فنانون مغاربة يستلهمون موت الطفل السوري عيلان
كان يكفي لصورة واحدة أن تحرّك المشاعر، وتجوب آفاق العين في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث الحساسية لصيقة بالمسام، وببشرة اليومي. لقطة ملتقطة من لُقى البحر، تلتهمها عدسة الكاميرا لتصبح أشبه بالأيقونة. جثة صبي تكاد تبدو وكأنها تشرب البحر لينضب ماؤه، فتعبرها صور رجال الهاربين من إسلام يدمّر حاضرهم بعد أن بنى مجد ماضيهم.
الصورة هنا شهادة عن شهادة / استشهاد. تمكين للموت أن يتجمَّد ليقول: الموت عصيٌّ على التصوير والتشخيص والتمثيل. ولم يكن لغير الصورة الفوتوغرافية اقتطاع الحدث، وجعله كينونة للحاضر وشعارًا لانهيار حضارة بكاملها: حضارة القاتل وحضارة الشاهدين على القتل.
كان يكفي لآلة صغيرة محمولة على هوى الضوء، إضاءة ما يدلهمُّ في ليل الحاضر. كي تبوح لنا بأن لا شيء يمكن أن يعبر في اللحظة عن الطابع البارد للموت، غير صورة تحترق بلون الأحمر الذي يرتديه الصبي. والصبي في غيابه يمتطي الأرض والرمل واليابسة. يدير ظهره لنظرنا وحضورنا وكأنه بعد أن امتطى اليمّ يمتطي صهوة التراب. اسمه إيلان السوري.
هنا يحضرني هذا الاسم من ذاكرة أخرى ليست ببعيدة."أيلان وليل الحكي" عنوان نصّ حكائي لرجل جاوز الستين، ولم ينشر أبدًا قبل هذا السن. مناضلٌ في حركة اليسار المغربي اسمه عمران المليح. يهودي من أواخر المنددين بالصهيونية.
تحكي هذه الرواية المكتوبة بطريقة غريبة وشخصية ومتداخلة،عن فورة المغاربة في أحداث 1965، ثم انتفاضات أواخر السبعينيات وأخيرًا ثورة الخبز سنة 1981.هل ثمة فارق بين ما يحدث اليوم وما حدث آنفًا؟ طبعًا وأي فارق. إلا أن إيلان اسم لأقلية قد تكون بالمشرق أو بالمغرب، لكنّها تتحدث عن ليل الحكاية.
حكاية إيلان مكتوبة بطريقة أغرب؛ ثمة حكايتان: تلك التي تكتبها الصورة، وتلك التي كتبتها الصحافة بعْديًا وهي تحاور الأب وخالة الصبي المقيمة بأميركا. وهناك أيضا الحكاية الرمزية التي صارت تكتب هنا وهناك، كما حين يحاكي ثلاثون فنانًا وضعية الصبي ويلبسون ما يشبه لباسه ويتواترون على شاطئ من شواطئ بلاد المغرب ليجسدوا ملحمة لا بطولة فيها سوى انهيار الإنسان.
اقرأ أيضاً: سحر التصوير
من حكاية إلى أخرى، تكون الصورة هي المبتدأ والمنتهى. صورة لا تُحتمل، لا تتحمّل، ولا يُغتفر موضوعها. صورة تدفع بالشرط الإنساني إلى حدوده القصوى. هذه الصورة "اللا تُحتمل" ليست أوّل صورة ولا آخرها. فعالم الإنترنت اليوم يسهّل تداول هذا الطابع التراجيدي للصورة في مفارقاتها. لنتذكر تلك الصورة لصبي فلسطيني بحجم حبة حمص يواجه دبابة بحجم عمارة. أو لنسترجع صورة مقتل الصبي محمّد الدرة (في الشهر نفسه، هذا الأيلول الأسود) من عام 2000، التي أوقفتنا أمام حدود إنسانيتنا.
وقبلها صورة كيفن كارتر Kevin Karter المصور الجنوب إفريقي المناهض للتمييز العنصري سنة 1994، التي قدّمت صبية تكسو بشرتها عظامها، ووراءها نسرٌ جارح ينتظر وفاتها. أثارت الصورة زوبعة من النقاش، ثم تبيّن أن الصبية لم تكن بعيدة عن عائلتها، وأنها كانت فقط كعائلتها في السودان، تنتظر حصتها من الطعام. ونظرًا إلى كثرة الاتهامات ضدّ المصور، غاص كيفن في الكآبة ثم انتحر.
لكن، لماذا يحتاج الفن إلى الفاصل الزمني والمسافة، كي يمارس التأمّل وترجمة المباشر في حدّيته إلى متخيل؟ لماذا يكون الموت حدًا لا تلتقطه في عنفه المباشر والفوري إلا الصورة والكاميرا؟ ثم حين تتوارى يغدو الموت موضوعًا فنيًا؟
تضعنا أهمية هذه الأسئلة أمام أمرين يكون الزمن والحاضر والإحساس لحمتهما: العيني المنقول بوساطة الحكاية أو بوساطة الصورة، ثم تناقل وتواتر الحكاية البصرية أو اللغوية
ومهما كان طابع التواتر والتناقل، المتعاطف يشبه صورة النسر الرابض في انتظار موت الصبية السودانية في دارفور، فإننا أمام الصورة، لا يمكننا إلا عيش مفارقة وجودنا وعجزنا الإنساني في أن نكون في مستوى ما نبتغيه أخلاقًا. أما الزمن فإنه يجعل الصورة القادرة على أن تكون فورية واستعادية، رمزية وإيحائية، صورة توقف الزمن. لكن قيمتها ليست في ذاتها بل في سياقها.
أما الفنّ حين يستعيد الحدث نفسه، فيمنحه طابعًا مغايرًا، قد يستغل الجانب الاستطلاعي الفوري للصورة، لكنه يحولها إلى شهادة تاريخية. الفرق بين الصورة الصحفية والفنّ هو أنهما وجهان لعملة واحدة؛ الصورة الصحفية واجهتها الراهن واللحظة والفعل والتأثير، أمّا الصورة الفنية فواجهتها المدى البعيد، لكنها تبغي التأثير أيضًا. تتبع الصورة الاستطلاعية الحدث، فتظهره للسطح وتركز عليه في غمرة المتشابك والمتوافر من الأحداث. صورة كيفن كارتر وجهت الأنظار لدارفور رغم كل شيء، وكذلك كان حال صورة محمّد الدرة وصورة إيلان السوري. الصورة الاستطلاعية سياسية المبتدأ والخبر، أما الفنية فإنسانية المقصد والموئل، مهما كانت سياسية.
ثمة صبي تلتقطه الصورة في موته، وتحوله في مجهوليته ومعلوميته إلى رمز لمأساة شعب ولوضاعة الإنسانية في انهيار قيمها وبشاعة مآلها. وثمة صبي سوري آخر يولد من جديد في الصورة. بعد وفاة أمه في تركيا وبقائه وحيدًا، يسجل فيديو ويبعثه إلى ملك البلاد التي يعيش فيها أبوه مع زوجته الثانية. يحول الصورة إلى رسالة يطلب فيها تأشيرة الحق في الالتحاق بالأب. صورتان إذن، والرسالة واحدة: الموت والحياة كوجهين لعملة واحدة.
ما تحققه الصورة الفوتوغرافية كما صورة الفيديو حاليًا يدخل في باب التواصل الراهن، في زمنيته وتواتر أحداثه. غداً ستأتي صور أخرى كي تنطبع مؤقتًا في ذاكرتنا لتمحو ما سبقها أو تتراكب على صور أخرى. ليس للصورة الصحافية ذاكرة قوية، مهما كانت قدرتها على الإقناع. إنها تكتسب ذاكرتها من أمرين: أن تتحول من حكاية إلى تاريخ، أو أن تصبح موضوعًا لعمل فني، سواء كان تشكيلًا أو مسرحًا أو سينما. أي أن تتحول من صورة غير محتملة إلى صورة محمولة في المتخيل الجماعي.
الصورة هنا شهادة عن شهادة / استشهاد. تمكين للموت أن يتجمَّد ليقول: الموت عصيٌّ على التصوير والتشخيص والتمثيل. ولم يكن لغير الصورة الفوتوغرافية اقتطاع الحدث، وجعله كينونة للحاضر وشعارًا لانهيار حضارة بكاملها: حضارة القاتل وحضارة الشاهدين على القتل.
كان يكفي لآلة صغيرة محمولة على هوى الضوء، إضاءة ما يدلهمُّ في ليل الحاضر. كي تبوح لنا بأن لا شيء يمكن أن يعبر في اللحظة عن الطابع البارد للموت، غير صورة تحترق بلون الأحمر الذي يرتديه الصبي. والصبي في غيابه يمتطي الأرض والرمل واليابسة. يدير ظهره لنظرنا وحضورنا وكأنه بعد أن امتطى اليمّ يمتطي صهوة التراب. اسمه إيلان السوري.
هنا يحضرني هذا الاسم من ذاكرة أخرى ليست ببعيدة."أيلان وليل الحكي" عنوان نصّ حكائي لرجل جاوز الستين، ولم ينشر أبدًا قبل هذا السن. مناضلٌ في حركة اليسار المغربي اسمه عمران المليح. يهودي من أواخر المنددين بالصهيونية.
تحكي هذه الرواية المكتوبة بطريقة غريبة وشخصية ومتداخلة،عن فورة المغاربة في أحداث 1965، ثم انتفاضات أواخر السبعينيات وأخيرًا ثورة الخبز سنة 1981.هل ثمة فارق بين ما يحدث اليوم وما حدث آنفًا؟ طبعًا وأي فارق. إلا أن إيلان اسم لأقلية قد تكون بالمشرق أو بالمغرب، لكنّها تتحدث عن ليل الحكاية.
حكاية إيلان مكتوبة بطريقة أغرب؛ ثمة حكايتان: تلك التي تكتبها الصورة، وتلك التي كتبتها الصحافة بعْديًا وهي تحاور الأب وخالة الصبي المقيمة بأميركا. وهناك أيضا الحكاية الرمزية التي صارت تكتب هنا وهناك، كما حين يحاكي ثلاثون فنانًا وضعية الصبي ويلبسون ما يشبه لباسه ويتواترون على شاطئ من شواطئ بلاد المغرب ليجسدوا ملحمة لا بطولة فيها سوى انهيار الإنسان.
اقرأ أيضاً: سحر التصوير
من حكاية إلى أخرى، تكون الصورة هي المبتدأ والمنتهى. صورة لا تُحتمل، لا تتحمّل، ولا يُغتفر موضوعها. صورة تدفع بالشرط الإنساني إلى حدوده القصوى. هذه الصورة "اللا تُحتمل" ليست أوّل صورة ولا آخرها. فعالم الإنترنت اليوم يسهّل تداول هذا الطابع التراجيدي للصورة في مفارقاتها. لنتذكر تلك الصورة لصبي فلسطيني بحجم حبة حمص يواجه دبابة بحجم عمارة. أو لنسترجع صورة مقتل الصبي محمّد الدرة (في الشهر نفسه، هذا الأيلول الأسود) من عام 2000، التي أوقفتنا أمام حدود إنسانيتنا.
وقبلها صورة كيفن كارتر Kevin Karter المصور الجنوب إفريقي المناهض للتمييز العنصري سنة 1994، التي قدّمت صبية تكسو بشرتها عظامها، ووراءها نسرٌ جارح ينتظر وفاتها. أثارت الصورة زوبعة من النقاش، ثم تبيّن أن الصبية لم تكن بعيدة عن عائلتها، وأنها كانت فقط كعائلتها في السودان، تنتظر حصتها من الطعام. ونظرًا إلى كثرة الاتهامات ضدّ المصور، غاص كيفن في الكآبة ثم انتحر.
لكن، لماذا يحتاج الفن إلى الفاصل الزمني والمسافة، كي يمارس التأمّل وترجمة المباشر في حدّيته إلى متخيل؟ لماذا يكون الموت حدًا لا تلتقطه في عنفه المباشر والفوري إلا الصورة والكاميرا؟ ثم حين تتوارى يغدو الموت موضوعًا فنيًا؟
تضعنا أهمية هذه الأسئلة أمام أمرين يكون الزمن والحاضر والإحساس لحمتهما: العيني المنقول بوساطة الحكاية أو بوساطة الصورة، ثم تناقل وتواتر الحكاية البصرية أو اللغوية
ومهما كان طابع التواتر والتناقل، المتعاطف يشبه صورة النسر الرابض في انتظار موت الصبية السودانية في دارفور، فإننا أمام الصورة، لا يمكننا إلا عيش مفارقة وجودنا وعجزنا الإنساني في أن نكون في مستوى ما نبتغيه أخلاقًا. أما الزمن فإنه يجعل الصورة القادرة على أن تكون فورية واستعادية، رمزية وإيحائية، صورة توقف الزمن. لكن قيمتها ليست في ذاتها بل في سياقها.
أما الفنّ حين يستعيد الحدث نفسه، فيمنحه طابعًا مغايرًا، قد يستغل الجانب الاستطلاعي الفوري للصورة، لكنه يحولها إلى شهادة تاريخية. الفرق بين الصورة الصحفية والفنّ هو أنهما وجهان لعملة واحدة؛ الصورة الصحفية واجهتها الراهن واللحظة والفعل والتأثير، أمّا الصورة الفنية فواجهتها المدى البعيد، لكنها تبغي التأثير أيضًا. تتبع الصورة الاستطلاعية الحدث، فتظهره للسطح وتركز عليه في غمرة المتشابك والمتوافر من الأحداث. صورة كيفن كارتر وجهت الأنظار لدارفور رغم كل شيء، وكذلك كان حال صورة محمّد الدرة وصورة إيلان السوري. الصورة الاستطلاعية سياسية المبتدأ والخبر، أما الفنية فإنسانية المقصد والموئل، مهما كانت سياسية.
ثمة صبي تلتقطه الصورة في موته، وتحوله في مجهوليته ومعلوميته إلى رمز لمأساة شعب ولوضاعة الإنسانية في انهيار قيمها وبشاعة مآلها. وثمة صبي سوري آخر يولد من جديد في الصورة. بعد وفاة أمه في تركيا وبقائه وحيدًا، يسجل فيديو ويبعثه إلى ملك البلاد التي يعيش فيها أبوه مع زوجته الثانية. يحول الصورة إلى رسالة يطلب فيها تأشيرة الحق في الالتحاق بالأب. صورتان إذن، والرسالة واحدة: الموت والحياة كوجهين لعملة واحدة.
ما تحققه الصورة الفوتوغرافية كما صورة الفيديو حاليًا يدخل في باب التواصل الراهن، في زمنيته وتواتر أحداثه. غداً ستأتي صور أخرى كي تنطبع مؤقتًا في ذاكرتنا لتمحو ما سبقها أو تتراكب على صور أخرى. ليس للصورة الصحافية ذاكرة قوية، مهما كانت قدرتها على الإقناع. إنها تكتسب ذاكرتها من أمرين: أن تتحول من حكاية إلى تاريخ، أو أن تصبح موضوعًا لعمل فني، سواء كان تشكيلًا أو مسرحًا أو سينما. أي أن تتحول من صورة غير محتملة إلى صورة محمولة في المتخيل الجماعي.