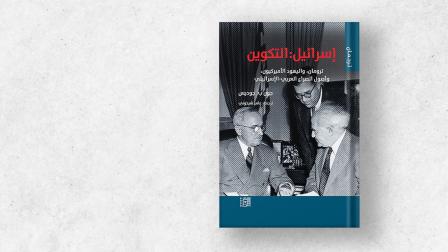ليسَ هذا الملحق الثقافي منبتًّا، أو منقطعَ الصّلة عن أسلافِه وزملائه من المنابرِ الثقافيّة العربيّة، المستمرّة منها أو تلك التي غابت. لا ادعاءَ مطلقًا بالبدء من أرضٍ عذراء، أو رسم دربٍ لم يتعبّد من قبل، إذ من شأن مقولةِ الإتيان "بما لم يأتِ به الأوائلُ"، نسف الفكرة الجوهريّة التي يقومُ الملحق عليها، من حيث هي تختزنُ في طيّات الشعريّة البليغةِ، معنىً سلبيًّا، يوحي أن الصّفرَ لا مفرّ، قدرُ الثقافة العربيّة.
هي ثقافتُنا بمحاسنِها قبل مساوئها، وبمآثرِها قبل مثالبِها. بتنوّعِها وغناها؛ مروحةٌ مفتوحةٌ، تجمع أجيالاً مختلفة من عمر العشرين إلى ما فوق الثمانين، من كتّاب مكرّسين إلى من تراوده رغبةُ الكتابة غبّ تفتّحها في نفسه. والفيصلُ الجامع لهذا الشتات -بعيداً من قمعٍ يصهرُ الكلّ في صورةٍ نمطية واحدة- الجمع بين أمريْن: الفائدة والمتعة.
إذ لا مقبول ثقافيًّا اليوم، الاتكاء على العواطف -وهي تفورُ وفق إيقاع التغيّرات الكبرى التي نعيشها- وحدها، لا بدّ من المعرفة، ولا بدّ من الفكر، مصبوبيْن في قالبِ الأسلوب الجذّاب لكتّاب متميّزين ومختلفين. والظنّ أن خيارًا مماثلًا، هو الأكثر عقلانيّةً في خِضمِ هستيريا الردح والردح المضاد، المنتشريْن بصورة واسعة في المنابر الإعلاميّة. هستيريا تناسب "داعش" الشغوفة بصورتها، والمفتونة بجرائمها، لكنها لا تناسب الثقافة العربيّة. لا طبلَ هنا ولا زمر، فالثقافة العربيّة راسخة بعيدًا من الهستيريا، ضدّها وضدّ داعش.
لا يعني الكلام أعلاه، أن أمورنا بخير، فلا أوهامَ على الإطلاق في ما يخصّ أوضاعنا المائلة صوبَ التردّي، والمنحدرة صوب قعر ينفتح على قعرٍ آخر، مثلما لا يعني أننا سننظرُ في انعكاسِ صورتنا، وقد جلت "الثورة" جزءًا منها، ونُفتن بجمالِها، ونصفقُ فرحًا بإنجازٍ مضى، من دون التأني واستخلاص الدروس. فأمورُنا نتاجُنا، نتاجُ عملنا، ونحن مقصّرون مهما ردّدنا مع الخطاب الضحل الواسع الانتشار: إنها لمؤامرة! لننصرف بعدها إلى اليأس، مرتاحين في الندب والبكائيّات.
من أجل هذا، كان لا بدّ من التعبير عن نِظرتنا للعمل الثقافي العربي، من خلال اختيار قصديّ يقول بالاحتفاء بالنقد في العدد الأوّل. وباختيار الدكتور محسن جاسم الموسوي ضيفًا أوّلَ، نرسل الرسالة الواضحة: النقد قبل أي شيء آخر. نقد قائمٌ على تضافرِ التراكُم والتجربة المميّزة. والأهمّ نظرةٌ مِلؤها الإيجابية للثقافة العربيّة، من حيث هي تنقدها في سياقها وضمن واقعها، فتعقد الصلة بين النصّ الأدبي والنقدي، وحضور المثقف، وعالم السياسية العربيّة الذي لا مفرّ مطلقًا من تأثيره في الثقافة العربية.
ها هنا المثقف لمن يريدُ أن يقرأه، لا أن يتذكّره عند كلّ أزمة ونكبة -وتاريخنا أزمات متتالية-، فيصرخ إذ تحفّ به الهستيريا: أين المثقف؟ فسؤالٌ مماثلٌ يعني أن الصارِخ يميلُ صوبَ الإخباري والشعارات الرنّانة، وتقودُه أوهامٌ كُبرى حيال واقعنا السياسيّ المتفننِ في تنكيل المثقف العربيّ وإقصائه ترغيبًا وترهيبًا.
منابرُ المثقفين العرب قليلة قبل أي شيء آخر، ومن المؤسِف حقًّا أننا لا نستطيع أن نعدّ اثنين وعشرين دوريةً عربيّة ثقافيّةً منتشرة، تقدّم الثقافة العربيّة بصورةٍ لائقة. لا، لا نستطيع في وطنٍ عربي، عددُ الدول فيه اثنان وعشرون دولة! وماذا لو وسّعنا زاوية النظر، فقارنّا بيننا وبين "الآخر"، من حيث عدد الدوريّات لا أكثر؟
منابرُنا قليلة، ولا مفرّ من العمل على زيادتها كلّما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، ولا مفرّ من الثقة بأسلافنا ومعاصرينا من المثقفين على اختلافهم وتباينهم، وإفساح المنابر للكلمة، الكلمة قرينة المعرفة. فليس إلّاها ما يبثّ الأمل في حياة عربيّة تبدو وكأنّها تسير صوب الانكسار، حيث الخرائط تميد من تحت سكّانها، والتشاؤم ينشئ موطئ قدمٍ، لن يلبث أن يتّسع، حال قرّرنا التوقف عن الكتابة والعمل. لا يتعلّق الأمر بالتفكير الرغائبي، إنما يتعلّق بالعمل فقط. فالعملُ صنو الأمل وقرينه الصادق في الأزمات، سواءٌ أكانت كبرى أم صغرى. وهو الجواب الأصلح لـ "داعش" الذي يقول كلّ يوم إنه ضدّ العقل والتفكير، وللاستبداد الذي أوصلنا إلى ما يُشبه قاعٌ صفصف.
ينضمّ الملحق، إلى إخوته من المنابر العربيّة الثقافيّة القليلة، منحازًا إلى الثقافة العربيّة الجادّة والممتعة في آنٍ معًا، وفي البال جواب عن المثل الفرنسيّ الذي يقول: "إنّ سنونوّةً واحدةً لا تصنعُ الربيع". صحيح، لكنّها إذ تنضمّ إلى السرب، تبشّر بالربيع.
هي ثقافتُنا بمحاسنِها قبل مساوئها، وبمآثرِها قبل مثالبِها. بتنوّعِها وغناها؛ مروحةٌ مفتوحةٌ، تجمع أجيالاً مختلفة من عمر العشرين إلى ما فوق الثمانين، من كتّاب مكرّسين إلى من تراوده رغبةُ الكتابة غبّ تفتّحها في نفسه. والفيصلُ الجامع لهذا الشتات -بعيداً من قمعٍ يصهرُ الكلّ في صورةٍ نمطية واحدة- الجمع بين أمريْن: الفائدة والمتعة.
إذ لا مقبول ثقافيًّا اليوم، الاتكاء على العواطف -وهي تفورُ وفق إيقاع التغيّرات الكبرى التي نعيشها- وحدها، لا بدّ من المعرفة، ولا بدّ من الفكر، مصبوبيْن في قالبِ الأسلوب الجذّاب لكتّاب متميّزين ومختلفين. والظنّ أن خيارًا مماثلًا، هو الأكثر عقلانيّةً في خِضمِ هستيريا الردح والردح المضاد، المنتشريْن بصورة واسعة في المنابر الإعلاميّة. هستيريا تناسب "داعش" الشغوفة بصورتها، والمفتونة بجرائمها، لكنها لا تناسب الثقافة العربيّة. لا طبلَ هنا ولا زمر، فالثقافة العربيّة راسخة بعيدًا من الهستيريا، ضدّها وضدّ داعش.
لا يعني الكلام أعلاه، أن أمورنا بخير، فلا أوهامَ على الإطلاق في ما يخصّ أوضاعنا المائلة صوبَ التردّي، والمنحدرة صوب قعر ينفتح على قعرٍ آخر، مثلما لا يعني أننا سننظرُ في انعكاسِ صورتنا، وقد جلت "الثورة" جزءًا منها، ونُفتن بجمالِها، ونصفقُ فرحًا بإنجازٍ مضى، من دون التأني واستخلاص الدروس. فأمورُنا نتاجُنا، نتاجُ عملنا، ونحن مقصّرون مهما ردّدنا مع الخطاب الضحل الواسع الانتشار: إنها لمؤامرة! لننصرف بعدها إلى اليأس، مرتاحين في الندب والبكائيّات.
من أجل هذا، كان لا بدّ من التعبير عن نِظرتنا للعمل الثقافي العربي، من خلال اختيار قصديّ يقول بالاحتفاء بالنقد في العدد الأوّل. وباختيار الدكتور محسن جاسم الموسوي ضيفًا أوّلَ، نرسل الرسالة الواضحة: النقد قبل أي شيء آخر. نقد قائمٌ على تضافرِ التراكُم والتجربة المميّزة. والأهمّ نظرةٌ مِلؤها الإيجابية للثقافة العربيّة، من حيث هي تنقدها في سياقها وضمن واقعها، فتعقد الصلة بين النصّ الأدبي والنقدي، وحضور المثقف، وعالم السياسية العربيّة الذي لا مفرّ مطلقًا من تأثيره في الثقافة العربية.
ها هنا المثقف لمن يريدُ أن يقرأه، لا أن يتذكّره عند كلّ أزمة ونكبة -وتاريخنا أزمات متتالية-، فيصرخ إذ تحفّ به الهستيريا: أين المثقف؟ فسؤالٌ مماثلٌ يعني أن الصارِخ يميلُ صوبَ الإخباري والشعارات الرنّانة، وتقودُه أوهامٌ كُبرى حيال واقعنا السياسيّ المتفننِ في تنكيل المثقف العربيّ وإقصائه ترغيبًا وترهيبًا.
منابرُ المثقفين العرب قليلة قبل أي شيء آخر، ومن المؤسِف حقًّا أننا لا نستطيع أن نعدّ اثنين وعشرين دوريةً عربيّة ثقافيّةً منتشرة، تقدّم الثقافة العربيّة بصورةٍ لائقة. لا، لا نستطيع في وطنٍ عربي، عددُ الدول فيه اثنان وعشرون دولة! وماذا لو وسّعنا زاوية النظر، فقارنّا بيننا وبين "الآخر"، من حيث عدد الدوريّات لا أكثر؟
منابرُنا قليلة، ولا مفرّ من العمل على زيادتها كلّما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، ولا مفرّ من الثقة بأسلافنا ومعاصرينا من المثقفين على اختلافهم وتباينهم، وإفساح المنابر للكلمة، الكلمة قرينة المعرفة. فليس إلّاها ما يبثّ الأمل في حياة عربيّة تبدو وكأنّها تسير صوب الانكسار، حيث الخرائط تميد من تحت سكّانها، والتشاؤم ينشئ موطئ قدمٍ، لن يلبث أن يتّسع، حال قرّرنا التوقف عن الكتابة والعمل. لا يتعلّق الأمر بالتفكير الرغائبي، إنما يتعلّق بالعمل فقط. فالعملُ صنو الأمل وقرينه الصادق في الأزمات، سواءٌ أكانت كبرى أم صغرى. وهو الجواب الأصلح لـ "داعش" الذي يقول كلّ يوم إنه ضدّ العقل والتفكير، وللاستبداد الذي أوصلنا إلى ما يُشبه قاعٌ صفصف.
ينضمّ الملحق، إلى إخوته من المنابر العربيّة الثقافيّة القليلة، منحازًا إلى الثقافة العربيّة الجادّة والممتعة في آنٍ معًا، وفي البال جواب عن المثل الفرنسيّ الذي يقول: "إنّ سنونوّةً واحدةً لا تصنعُ الربيع". صحيح، لكنّها إذ تنضمّ إلى السرب، تبشّر بالربيع.