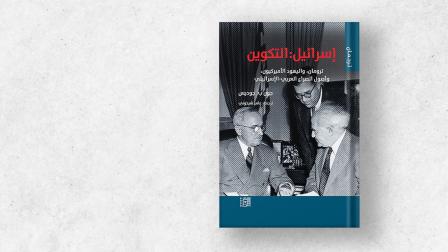في القرن التاسع عشر، افتتح هيغل مقولة فكرية حين تحدّث عن "نهاية الفن" وترك الباب موارباً للقول بنهايات أخرى. لعله لم يكن يتصوّر أن يخرج من معطفه خطاب موسّع حول النهايات والمابعديات وموت المفاهيم والحقول والتصوّرات وحتى الأشياء نفسها، فقد بات ذلك بعد عقود أمراً دارجاً في الفلسفة وفي المعارف التي تفرّعت منها بالتدريج وتتالت معها "الجنائز" (وكأن الأمر يتعلّق بـ وباء!)، فتحدّث نيتشه عن "موت الإله" وجاء بعده من يقول بخسوف الحضارة الغربية، والحضارة برمّتها (أوسفالد شبينغلر)، وما بعد الحداثة (جان فرانسوا ليوتار)، وموت الإنسان (ميشيل فوكو)، ونهاية التاريخ (فرانسيس فوكوياما استناداً إلى هيغل أيضاً)، وموت الصورة (ريجيس دوبريه)، ونهاية العمل (جيرمي ريفكين) ونهاية الواقع (جان بودريار) إلى غير ذلك، فالقائمة لم يعد من الممكن حصرها.
نهايات كثيرة لم تتحقّق، وأخرى ظهرت أعراضُها، وبعض منها بقي غير قابل للفحص إذ لا يتعلّق الأمر إلا باستعارة لغوية، ولعل في ذلك ما يُطمئن. غير أن الانتقال من وضعية إعلان النبوءة إلى تجسّد هذه الأخيرة بشكل ملموس ليس بالأمر الصعب، فمثلاً ها هو انتشار فيروسٍ يبدو وكأنه يمضي قدماً في تحقيق إحدى هذه النبوءات؛ موت الثقافة الذي أعلنه الفيلسوف الألماني كارل شميت (1888 - 1985)، وإن كان الأمر قد جرى ليس كما نظّر له صاحب كتاب "الديكتاتورية" حين اعتبر أن المنظومة التقنية- الاقتصادية تلعب دور حفّار قبر للثقافة.
أدّى انتشار فيروس كورونا إلى قارات مختلفة من العالم إلى الإعلان عن إلغاء القسم الأكبر من التظاهرات الثقافية؛ بين معارض الكتب، ومهرجانات المسرح والسينما، واللقاءات الأدبية والندوات العلمية والفكرية. لم يبق الكثير للقول بوجود ثقافة على الأرض. وفي هذه الحال، لنا أن نتساءل: ما الذي بقي من الثقافة حين تختفي فعالياتها؟
من المعلوم أن الثقافة قد أخذت تعريفات شتّى وتفسيرات متعددة لتنشّطها أو ركودها، وقد لا يختلف كثيرون على أن الثقافة في حاجة إلى فضاءات يلتقي فيها الناس ببعضهم في عملية تبادل للأفكار والمواقف والأذواق، وهو ما وفرته الأغورات والأكاديميات ثم الصالون فالساحات العامة وصولاً إلى إشراف الدولة المباشر على تهيئة فضاءات للحياة الثقافية من دور عرض وغاليريهات ومدن ثقافية متعددة الاختصاصات. لكن كلّ ذلك بات مغلقاً بسبب كورونا. ضُربت علاقات التلقي الثقافية وكأنها تلقت قصفاً بمدفعية ثقيلة في حين أن "الجاني" ليس سوى كائن مجهري لا تظهر أعراضه إلا بعد أيام من اندساسه في جسم الإنسان.
لكن انهيار منظومة الفعاليات الثقافية لا يعني موت الثقافة بالكامل، ففي هذا الوضع، بقي لـ"الحياة" الثقافية ما ورثته البشرية من العصور القديمة حين كان اللقاء مع فيلسوف أو كاتب لا يتم إلا من خلال الكتاب الذي يصل إلى جغرافيات بعيدة ويعبر إلى عصور أخرى.
لكن، وهنا تكمن المفارقة مع نبوءة كارل شميت، تجد الثقافة اليوم متنفّساً لها عبر التكنولوجيا.
التكنولوجيا التي من المفترض أن تخنق الثقافة تلعب اليوم دور المنقذ أو على الأقل دور آلة التنفس الاصطناعي، إنها البديل عن فضاءات الثقافة وها إن عددا من التظاهرات الملغاة قد وجدت في تقنيات مثل الاجتماع الإلكتروني أو تحويل المعارض إلى مواقع تفاعلية سبيلاً للوصول إلى جمهور لا يتاح له إلا الحد الأدنى من التنقّل. وإن كان يجدر القول إن ما توفّره التقنية يظل رفاهية متفاوتة التوزيع في العالم، وبالتالي فإن "شَلل" الحياة الثقافية يتجلّى بشكل متفاوت على سلّم الجغرافيا، فلا يخفى أن مناطق كثيرة تعيش فيها الثقافة حالة "الحجر الصحّي" حتى قبل ظهور كورونا.
في البلاد العربية، سرت كورونا ومعها شلل الحياة الثقافية قَدماً بقدم. حالة من التوقّف شبه التام تعيشها الثقافة العربية خصوصاً مع عدم التعوّد على استعمال البدائل التكنولوجية أو عدم توفرها، ولكن الأكثر إشكالية هو غياب شبه كامل لتصورّات للثقافة دون فضاءات مخصّصة حيث انبنت السياسات الرسمية على محاصرة الثقافة في أماكن يسهل مراقبتها، كما يتعلّق الأمر بما هو أبعد، فالنخب بمعناها الأوسع لا تبدو مهيّأة للتعامل مع وضعيات خارج روتين الحياة الثقافية المكرّسة.
مثلاً، مع إلغاء أو تأجيل معارض الكتاب في بغداد وتونس والرياض تجد صناعة النشر العربية نفسها في مأزق حقيقي لا نجد مثيله في عدة فضاءات ثقافية أخرى، حيث تمثل معارض الكتب في العالم العربي ركيزة من ركائز الاستمرارية الاقتصادية لمؤسسات النشر مع غياب قنوات توزيع منتظمة وبقاء معظم إنتاجات الكتب محلية مع انكفاء كل سوق على نفسها، من العراق إلى المغرب.
بفضل التوزيع الإلكتروني ووجود سياسات دعاية منتظمة للإصدارات الجديدة، لا يبدو أن مؤسسات النشر في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وغيرها من البلدان قد تضرّرت كثيراً من غياب المعارض، إذ تنحصر الخسائر في افتقاد فضاءات كانت تمنحها فرصة التعرّف على تجارب جديدة واقتناء حقوق التأليف والترجمة، أو تطوير نجومية بعض كتّابها. وبالتالي فإن ما خلّفه كورونا يظلّ مثل أي كارثة طبيعية تتفاوت درجات تأثيراتها السلبية بحسب وجود بنى متهيّئة للتعامل بمرونة مع هذه الوقائع.
ما يسري على واقع الكتاب العربي يمكن تعميمه على حقول ثقافية أخرى، من الفنون التشكيلية إلى الحياة الأدبية والتي أصبحت المهرجانات محرّكها الرئيسي في عالم اليوم. أيٌّ من هذه الحقول طوّر قدرات "مناعة" تجاه أزمات كالتي نعيشها اليوم؟ لن نتحدّث عن غياب التنظير حول الثقافة وتحوّلاتها، يكفي فقط أن ننظر في استعمالات تكنولوجيا التواصل كأبسط مثال.
عند الحديث عن كورونا يشير العلماء إلى قدرة هذا الفيروس على إحداث طفرات، ويبدو أن أيّ ثقافة في حال لم تطوّر طفرات مضادة، ضمن هذه الأزمة أو غيرها من الأزمات (بعضها دائم)، فهي من الهشاشة بحيث تظلّ مهدّدة بالبقاء في حالة من الشلل "حتى إشعار آخر".