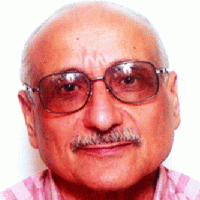06 نوفمبر 2024
موت الساسة أم موت السياسة
يخيّل للمراقب المحايد، وهو يتابع حمى الانتخابات البرلمانية العراقية المتصاعدة، أن ثمة موتا معلنا للسياسة بمفهومها السائد في أنها فن التعامل مع الشؤون العامة، سواء كان اللاعب في الحكومة أو في المعارضة. والحال أنك أن تشخص مشكلة، أن تضع لها حلا، أن تحقق مصلحة عامة، أن تشارك في القرار، وأن تحترم الآخر الذي يجرّب حظه مثلك، فهذا كله سياسة، لكنك إذا رصدت ما يجري في العراق، لن تجد شيئا من هذا القبيل، وقد يخطر في بالك أن تستعير من ابن خلدون أن الناس هناك يتبادلون الأكاذيب والمكائد والخديعة، حيث يتخلق كل من المرشح والناخب بما يفسد البصيرة، ويضعف الرؤية على التمييز بين حدي السيف.
هذا هو ما يحدث في العراق اليوم، ظاهرة عجز عن فعل سياسي ممنهج ورصين، حيث يعد كل ما يفعله المرشح أو الناخب أو الأطراف الأخرى مؤشرا على موت السياسة، وخارج دائرة العقل السياسي السوي.
يبيع الناخب صوته مقابل كيس بطاطه أو "بطانية" أو بضعة دولارات، وتنحصر تطلعاته في جملة مطالب رخيصة وتافهة، بطاقة هاتف نقال، أو سفرة إلى مرقد ابنة الحسن، أو وقود مجاني للمولدة، أو حتى سلة خضار تكفي الأسرة أسبوعا. ولا يختلف حال المرشح كثيرا عن حال ناخبه، لكن تطلعاته تفصح عن دناءة وفساد مستطير، يدفع مليون دولار كي يحتل الرقم واحد في القائمة الانتخابية، يمثل ذلك استثمارا مربحا، أربع سنوات كافية لمضاعفة المبلغ المدفوع مرات، وله بعد السنوات الأربع أن يجدّد استثماره، أو يرضى من الغنيمة بالإياب، أو يطوف بدولٍ يهمها تطمين مصالحها في العراق، عارضا خدماته ليحصل منها على ما قدّر له من رزق حرام.
هنا تموت السياسة، ويضطرب الفضاء العام وتشيع الفوضى، وواحد من وجوه موتها أيضا
بلوغ عدد الأحزاب التي سجلت نفسها لخوض المعركة الانتخابية أكثر من ثلاثمئة، وهو رقم قد يجعل العراق الأول في العالم، من حيث عدد الأحزاب، بما يؤهله للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكن معظم هذه الأحزاب تتشابه في ما تطرحه من شعاراتٍ شعبويةٍ رخيصةٍ، تخاطب الحاجات الآنية للمواطن البسيط، وتستثير الحس الطائفي لديه على نحو لافت، ولا تفصح عن مصادر تمويلها، وكما في الدورات الانتخابية السابقة، فمن غير المتوقع أن يمتد عمر هذا النمط من الأحزاب إلى أبعد من بضعة أشهر بعد الانتخابات، حيث تطوي أوراقها وتمضي. وهي اليوم تتبادل المواقع والمواقف والتحالفات في ما بينها على نحو انتهازي، لا يؤسس لها هويةً، ولا يضيف إليها مجدا.
حال ما يسمونه "المجتمع المدني" ليس أفضل، حيث إن المنظمات والجمعيات التي يفترض أن تراقب عملية الانتخابات، وأن تحمي حقوق المواطن، تسعى إلى إسباغ شفافية مفتعلة على العملية مقابل ثمن معلوم، مثل "الجيوش الإلكترونية" التي تجاوزت أعدادها رقما مخيفا، وكذلك الفضائيات التي تسخّر برامجها لتسفيه الفعل السياسي السوي، واعتماد البذاءات في النقد المتبادل بين اللاعبين.
وإنصافا، ليس هذا التواطؤ المرئي والمشخص الذي يدفع إلى موت السياسة نتاج الأعوام الخمسة عشر العجاف التي أعقبت الغزو فحسب، بل يرجع إلى أبعد من ذلك، حيث لم يقدر للعراق أن يشهد نظاما مؤسسيا منذ صعود "العسكرتاريا" والأحزاب الشمولية إلى سلطة القرار، والصراعات بين قوى محسوبة على الفضاء السياسي كان يمكن لو نمت طبيعيا أن تساعد على تجذير الممارسة السياسية، وكذلك تغييب أي هامش ديمقراطي، يفتح الطريق أمام المواطن لإبداء الرأي، والمشاركة في صنع القرار، وقد تكرّس ذلك النهج في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، في ظل ضغوط الحروب والحصارات وسياسات القمع والتطرّف الأعمى التي أسكتت أصوات الناشطين السياسيين في صفوف المعارضة، وغيبت أدوارهم، كما حجبت الفرصة التي قد تمكن من بروز سياسيين لهم رؤاهم ووجهات نظرهم الخاصة داخل صفوف الموالاة نفسها، وهذا ما دفع بالسياسة باعتبارها فن التعامل مع الشؤون العامة إلى حالة انكفاء، وصولا إلى موت بطيء بتدبير مسبق من الحاكم الذي يقبض على سلطة القرار، ويسقط المواطن في هوة العجز، وعدم القدرة على الفعل.
ومن هنا تصبح العملية الانتخابية الماثلة مجرّد ديكور لنظام سياسي هجين، يعمل على توطين موت الساسة وموت السياسة معا.
هذا هو ما يحدث في العراق اليوم، ظاهرة عجز عن فعل سياسي ممنهج ورصين، حيث يعد كل ما يفعله المرشح أو الناخب أو الأطراف الأخرى مؤشرا على موت السياسة، وخارج دائرة العقل السياسي السوي.
يبيع الناخب صوته مقابل كيس بطاطه أو "بطانية" أو بضعة دولارات، وتنحصر تطلعاته في جملة مطالب رخيصة وتافهة، بطاقة هاتف نقال، أو سفرة إلى مرقد ابنة الحسن، أو وقود مجاني للمولدة، أو حتى سلة خضار تكفي الأسرة أسبوعا. ولا يختلف حال المرشح كثيرا عن حال ناخبه، لكن تطلعاته تفصح عن دناءة وفساد مستطير، يدفع مليون دولار كي يحتل الرقم واحد في القائمة الانتخابية، يمثل ذلك استثمارا مربحا، أربع سنوات كافية لمضاعفة المبلغ المدفوع مرات، وله بعد السنوات الأربع أن يجدّد استثماره، أو يرضى من الغنيمة بالإياب، أو يطوف بدولٍ يهمها تطمين مصالحها في العراق، عارضا خدماته ليحصل منها على ما قدّر له من رزق حرام.
هنا تموت السياسة، ويضطرب الفضاء العام وتشيع الفوضى، وواحد من وجوه موتها أيضا
حال ما يسمونه "المجتمع المدني" ليس أفضل، حيث إن المنظمات والجمعيات التي يفترض أن تراقب عملية الانتخابات، وأن تحمي حقوق المواطن، تسعى إلى إسباغ شفافية مفتعلة على العملية مقابل ثمن معلوم، مثل "الجيوش الإلكترونية" التي تجاوزت أعدادها رقما مخيفا، وكذلك الفضائيات التي تسخّر برامجها لتسفيه الفعل السياسي السوي، واعتماد البذاءات في النقد المتبادل بين اللاعبين.
وإنصافا، ليس هذا التواطؤ المرئي والمشخص الذي يدفع إلى موت السياسة نتاج الأعوام الخمسة عشر العجاف التي أعقبت الغزو فحسب، بل يرجع إلى أبعد من ذلك، حيث لم يقدر للعراق أن يشهد نظاما مؤسسيا منذ صعود "العسكرتاريا" والأحزاب الشمولية إلى سلطة القرار، والصراعات بين قوى محسوبة على الفضاء السياسي كان يمكن لو نمت طبيعيا أن تساعد على تجذير الممارسة السياسية، وكذلك تغييب أي هامش ديمقراطي، يفتح الطريق أمام المواطن لإبداء الرأي، والمشاركة في صنع القرار، وقد تكرّس ذلك النهج في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، في ظل ضغوط الحروب والحصارات وسياسات القمع والتطرّف الأعمى التي أسكتت أصوات الناشطين السياسيين في صفوف المعارضة، وغيبت أدوارهم، كما حجبت الفرصة التي قد تمكن من بروز سياسيين لهم رؤاهم ووجهات نظرهم الخاصة داخل صفوف الموالاة نفسها، وهذا ما دفع بالسياسة باعتبارها فن التعامل مع الشؤون العامة إلى حالة انكفاء، وصولا إلى موت بطيء بتدبير مسبق من الحاكم الذي يقبض على سلطة القرار، ويسقط المواطن في هوة العجز، وعدم القدرة على الفعل.
ومن هنا تصبح العملية الانتخابية الماثلة مجرّد ديكور لنظام سياسي هجين، يعمل على توطين موت الساسة وموت السياسة معا.