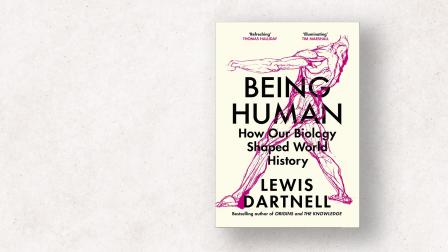في مدينة السلط الأردنية، أبصرَت هذه الطفلةُ - التي سيُجمع كثيرون على وصفها بأنّها مجموعة نساء في امرأة واحدة - النورَ في نهاية العشرينيات، لأبٍ فلسطيني وأُمّ لبنانية كان لزواجهما قصّة طريفةٌ سترويها ابنتُهما سلمى الخضراء الجيوسي في إحدى حلقات برنامج "رائدات" (إعداد وإخراج روان الضامن)، بثّتها قناة "الجزيرة" عام 2006.
كان والدُها صبحي الخضراء وخالُها صديقَين جمعهما "الجيش العربي" (1920 - 1956). ثم التحقا بالأمير فيصل (الذي سيُصبح الملك فيصل الأوّل لاحقاً) في دمشق. وفي بيت خالها هناك "رأى والدي أمّي، لأنّ الدرزيات كنّ يجلسن مع الرجال بغطاء الرأس، وأخبر خالي بأنّه يريد أن يتزوّج منها. وجَمَ خالي، وقال له إنّك طلبتَ الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن أعطيه لك؛ فأنا زعيمٌ في عشيرتي، والدروز لا يزوّجون بناتهم للخارج أبداً".
شعر الشاب صبحي بالحزن وانزوى بنفسه، فافتقده الأمير فيصل وأرسل وراءه. وحين علم بما يشغله، طمأنه بأنّ كلّ شيء سيكون على ما يُرام. وبالفعل؛ خلال أحد لقاءاته التي كان يُقيمها في ديوانه كلّ جمعة، قال لخالي إنّه يُريد أن يطلب منه أمراً ويخشى أن يردّه، فأجابه بأنّه سيلبّي طلبه أيّاً كان، ففاجأه بالقول: 'أريد أن نزوّج ابنتك لابننا صبحي'. أمام الوعد الذي قطعه، لم يكن أمام خالي سوى القبول بالأمر. وحينها أعلن الأمير فيصل أنّ 'كتْب الكتاب' سيكون الجمعة التالية في قصر أخيه الأمير زيد في المزّة".
كتبت قصيدتها الأُولى نهاية الثلاثينيات كانت في العاشرة من عمرها
في مدينة عكّا، عاشت سلمى طفولتها الأُولى، والتي لا تَحتفظ ذاكرتُها بالكثير منها. من بين القليل الذي تتذكّره "جامعُ الجزّار" الذي قالت إنّها كانت تترك مدرستها الابتدائية أحياناً لتذهب إليه. أمّا السبب، فهو أنّ الأذان كان يُرفَع، في بعض الأيّام، خارج أوقاته، للإعلان عن موت أحدهم، وكان حدوثُ ذلك يُثير في نفسها خوفاً من أن يكون من مات هو والدُها الذي تُخبرنا بأنّه كان مُحامياً وأحد مؤسّسي "حزب الاستقلال"، بينما كانت والدتُها، أنيسة يوسف سليم، "شاعرية المزاج، ومثقّفةً تقرأ بالعربية والإنكليزية". ومن تلك الطفولة البعيدة أيضاً، تستعيد سلمى أوّل قصيدة كتبَتها. كان ذلك بعد اغتيال الملك غازي عام 1939، وكانت في العاشرة من عمرها.
تضعُنا سلمى الخضراء الجيوسي، خلال المقابَلة، في الأجواء السياسية المضطربة في عكّا منتصف الثلاثينيات، والتي كان من بين أبرز محطّاتها الإضرابُ الكبير عام 1936. في هذه الأجواء المحتقنة، سيقتحم جنودُ الانتداب البريطاني المنزل العائلي عند الرابعة صباحاً لاعتقال والدها واقتياده إلى "معتقل المزرعة" قرب عكّا. ولأنّها الابنة البكر (يصغرها أخٌ وأختان)، ستجدُ نفسها أمام مسؤوليات جديدة: "كانت زياراتي القصيرة إليه، مع إخوتي، في السجن، تبدأ دائماً بمجموعةٍ من الأسئلة التي يوجّهها إليّ، ثمّ بقائمة من التعليمات، وتنتهي بحديث ودّي".
تستعيد الشاعرة والباحثة والمترجمة الفلسطينية الرائدة ذكرى "المظاهرات التي قدتُها وأنا صغيرة؛ في الثامنة والتاسعة من العمري. حين سمعتُ كلمة مظاهرة للمرّة الأُولى سألتُ عمّا تعنيه هذه الكلمة، ثمّ أصبحتُ ملكة المظاهرات في عكّا".
بسبب غياب ثانوية للبنات في مدينتها، أرسَلها والدُها إلى القدس للدراسة في "كلّية شْمِيتْ للبنات"، ثمّ التحقت بها أُختها بعد سنة من ذلك: "بسبب وجوده في السجن، كان يستدين لنُكمل دراستنا. لذلك كنتُ أشعر أنّني كلّما درست، أفي حقَّ والدَي". وهنا، تتحدّث الجيوسي عن مدى اهتمام الفلسطينيّين، خصوصاً في نابلس، بتعليم البنات خلال تلك الفترة.
اجتازت سلمى الخضراء الجيوسي المرحلة الثانوية بتفوُّق. وكانت محطّتها المقبلة هي "الجامعة الأميركية" في بيروت لدراسة الأدب العربي والإنكليزي. وبعد تخرُّجها، تزوّجت من زميل لها في الجامعة، انتقلت معه، بحُكم عمله الدبلوماسي، بين عددٍ من البلدان العربية والأجنبية: روما ومدريد وبغداد وبون... وعن ذلك تقول: "لا أجد صعوبةً في الغربة. أتأقلم حالاً مع المكان".
كنتُ في قلب الحركة الحداثية، لكنّني كنت أحترم التراث
تتوقّف سلمى عند الفترة البيروتية من حياتها، مُستعيدةً أيّام مجلّة "شعر" وأجواء أماسي الخميس في بيت يوسف الخال، والتي كانت "تُقام في حالةٍ من المرح، بحضور شعراء وكتّاب كبار". هنا، تُعرّج للحديث عن موقفها من الحداثة والتراث قائلةً: "كنتُ في قلب الحركة الحداثية، لكنّني كنت أحترم التراث، ولا أجد أنّ الانتقال إلى الحداثة يتطلّب نسخ التراث ونسيانه. كنتُ، بشكل حسّاس وغريزي، أفهم استمرارية الأدب وكيف أنه يُجبَل بدم الإنسان وذاكرته، ولم يكن من الممكن الانفصال عن ذلك التراث الغنّي الذي اقتربتُ منه في مكتبة والدي (تلك المكتبة التي نُقلت إلى دمشق قُبَيل النكبة)، لكنّني وقعتُ في حبّه حين كبرت ودرسته".
في عام 1960، وقد أصبحت أُمّاً لثلاثة أطفال، ستصدُر مجموعتها الشعرية الأُولى "العودة من النبع الحالم"، وتُترجم مجموعةً من الكتب من الإنكليزية إلى العربية. وبينما كان الأبناء على عتبة الجامعة، قرّرَت دراسة الدكتوراه في لندن: "قبل موته، قال لي والدي إنّه يُريدني أن أدرس أكثر. ومن جهتي، أردتُ أن أملأ الثغرات التي لم أدرسها في الجامعة، وهي كثيرة". ستُتوَّج هذه المرحلة بنيلها شهادة دكتوراه عام 1970 عن أطروحة حول "الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث".
يتذكّر ستيفان سبيرل، أستاذُ الأدب العربي في جامعة لندن، تلك المرحلة بالقول: "قبل ثلاثين سنة، في معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية في لندن، حين رأيتُ تلك السيّدة الأنيقة جدّاً والحيوية جدّاً، تحمل كتابَين ضخمين، فهمتُ من لون تجليدهما أنّهما رسالة دكتوراه. لم أكُن قد رأيتُ رسالة دكتوراه بهذه الضخامة من قبل، ولم أتخيّل أنّها ستكون، بعد نشرها، من المصادر الأساسية في تدريسي الأدب العربي"، قبل أن يُضيف: "لا يوجد من حقَّق ما حقّقته الجيوسي لصالح الأدب والثقافة العربيَّين في الغرب".
بعد ذلك، ستخوض سلمى تجربةَ التدريس في عدد من الجامعات العربية والأجنبية؛ من الخرطوم إلى الجزائر العاصمة وقسنطينة، ثمّ الولايات المتّحدة. لكنَّ حادثة صغيرة في "جامعة تيكساس" عام 1979، ستُحدث تحوُّلاً جذرياً في مسيرتها؛ كان ذلك حين خاطبها طالبٌ أجنبي بالقول: "أنتم لا تملكون ثقافة"، فأجابته: "سأُريك". تقول عن ذلك: "استعر شيءٌ في داخلي. وحزّ في نفسي أنّ العالَم العربي لا يهتمّ بنقل ثقافته إلى العالَم. وقد اتّفق، بعد فترة وجيزة، أن ألقيتُ المحاضرةَ السنوية في جامعة كولومبيا، وتناولتُ فيها 'وضْع الكاتب العربي اليوم'، وبعدها، اقترب منّي مدير 'منشورات جامعة كولومبيا للنشر' وطلب منّي أن أتعاون معه في تحرير مجموعة كبيرة من كتب الأدب العربي. حينها قرّرتُ ترك التدريس وبداية العمل على المشروع الجديد".
في هذه المرحلة، ستُصدر أوّل موسوعة للشعر العربي الحديث بالإنكليزية، والتي تطلّبت سبع سنوات من العمل وتضمّنت 93 شاعراً عربياً، قبل أن تُطلق عام 1980، مع عدد من الأكاديميّين في "جامعة ميشيغان"، مشروع "بروتا" الذي هدف، من خلال الترجمة، إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الغرب عن الحضارة العربية. وخلال 26 عاماً (حتى عام 2006)، أُصدرت ضمن المشروع قرابة أربعين مؤلّفاً، من بينها إحدى عشرة موسوعة، وكثيرٌ من الترجمات الشعرية والسردية. أنجزت الجيوسي كلّ ذلك مدفوعةً بشعور لا يفارقها بضرورة العمل وشعور لا يراودها بضرورة الراحة؛ هي التي تعمل ستّ عشرة ساعةً في اليوم، بما فيها أيّام العطل والأعياد.
مُجيبةً عن سؤال عمّا إذا كان ثمّة من حاول إحباطها، تقول: "لم يحاول أحدٌ ذلك. لكنّ الإحباط جاء من عدم تفهُّم المشروع عربيّاً وعدم الاكتراث بأهمّية الدخول بالثقافة العربية إلى العالَم، وهو أمرٌ لا يزال مستمرّاً إلى اليوم للأسف". لكنّ هذا لا يعني أنّ الباحثة والمترجمة لم تواجه عراقيل في مسيرتها. إحدى تلك المحاولات ما قام به أستاذٌ صهيونيٌّ كان ضمن لجنة النشر في "منشورات جامعة كولومبيا"، اعترض على نشر "موسوعة الأدب الفلسطيني"، بدعوى احتوائها ترجمةً لمذكّرات شخصية "ليست أدبية بما فيه الكفاية"، وهو الأمرُ الذي عرقل صدور الموسوعة، قبل أن ترى النور بعد تدخُّل من إدوارد سعيد.
في عام 1995، عادت إلى عكّا والقدس بعد غياب استمرّ لأكثر من خمسين عاماً
في عام 1985، ستكلّفها "الأكاديمية السويدية" بإعداد دراسة عن وضْع الأدب العربي الراهن، للاستعانة بها في تقييم عددٍ من الكتّاب العرب المرشّحين لجائزة نوبل، وقد كان لتلك الدراسةُ أثرها الكبير في حصول نجيب محفوظ على الجائزة بعد ثلاث سنوات من ذلك.
وفي عام 1995، شاركت في "مؤتمر أوروبا وفلسطين" في "جامعة بيرزيت"، وعادت إلى بيتها ومدرستها في عكّا والقدس بعد غياب استمرّ لأكثر من خمسين عاماً، وهو ما تكتفي بالتعليق عليه بكلمتَين كرّرتهما مرَّتين: "مؤلمٌ جدّاً".
ضمّت المقابلة، أيضاً، شهادات لعددٍ من المثّقفين العرب والأجانب، تحدّثوا فيها عن سلمى الخضراء الجيوسي وأهمّية ما قدّمته للثقافة العربية؛ فهذا خير الدين حسيب يقول إنّ الجيوسي "تُقدّم نموذجاً للمفكّر والمثقّف العربي الملتزم بقضايا أمّته"، وهذا نوري الجرّاح يقول: "عندما أفتّش الآن في الأسماء الثقافية العربية، نساءً ورجالاً، لا أجد كفئاً ونظيراً لسلمى في ما قدّمته للثقافة العربية على مفصل علاقة هذه الثقافة بالعالَم"، قبل أن يُضيف: "لم ألتق بها إلّا وكانت تحمل مشروعاً أو تتطلّع إلى مشروع وتُحاول أن تجد له مصادر. كانت مشغولةً، إلى جانب كونها ناقدة ومترجمة وكاتبة، بالبحث عن مصادر. ومن المؤسف أن ينشغل المبدع والناقد وصاحب الفكر بالبحث عن مصادر مالية لإنجاز مشروع طموح".
أمّا خلدون الشمعة، فيقول: "نشرَت أعمالها في دُور نشر شهيرة وكبيرة ولها توزيع هائل. ولهذا لا أتردّد في القول إنّها استطاعت أن تُقدّم نموذجاً ناصعاً للقارئ الأجنبي عن مستوى الأداء العربي الذي لا يقلّ عن مستوى أداء الباحثين الغربيّين عموماً"، بينما يقول إرنست ماكاروس، زميلُها المؤسّس في مشروع "بروتا": "لديها عقلٌ ناقدٌ جدّاً وذاكرة فوتوغرافية، وهي لا تتوقّف عن التفكير والعمل من أجل تحقيق هدفها. لديها طاقة هائلة وهي مُخلصة بالكامل لعملها".