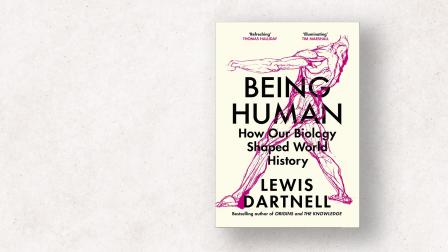كُتب الكثير حول الهوية المعمارية للمسجد الأموي في دمشق، ما إذا كانت بيزنطية، أم رومانية متأخّرة، أم ساسانية، أم سريانية، وسيقت أدلّة كثيرة وتخصصات حاولت أن تنسب هذا الصرح المذهل لإحدى تلك المدارس، سواء أكانت مدارس معمارية حقيقية، أم مجرد أفكار في رؤوس مردديها. ولكن، ما يمكن الجزم به هو أن هذا المسجد هو محصلة فنون زمنه، بل هو القنطرة العظيمة التي عبرت عليها العمارة الإسلامية نحو التفرد، وصولاً إلى تكامل ما اصطُلح على تسميته الحضارة العربية الإسلامية بجناحيها العباسي والأندلسي في فترة لاحقة.
تناقض صارخ
في تناقض صارخ مع الرؤية المكرَّسة في عدد من كتب التاريخ والأدب العربيين، حول استبداد حكام بني أمية، نجد أن المصادر العباسية تتحدث عن سعي الوليد بن عبد الملك (668 - 715م)، لتعديل معاهدة الصلح التي أفضت لفتح دمشق أبوابها أمام قوات خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح عام 634 أو 636 ميلادي، وهي تعديلات كانت تهدف للاستحواذ على كنيسة يوحنا المعمدان، للبدء ببناء المسجد الذي أراده الوليد عنواناً ورسالة لتكريس دمشق عاصمة لإمبراطورية تمتد من تركستان إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
لقد لاحظ الكثير من الدارسين المعاصرين أن الوليد فاوض مسيحيي دمشق طويلاً للحصول على مبنى الكنيسة مقابل منحهم عدداً من الكنائس الأُخرى بدلاً عنها، في الوقت الذي كان يمتلك فيه السلطة والقوة للاستيلاء على الكنيسة تماماً كما فعل غيره من الحكام البيزنطيين والساسانيين والرومان قبل ذلك، ولكن الوليد كان يعرف عواقب نقض المعاهدة، سواء على صعيد سياسات الأمويين التوفيقية مع سكان الشام المسيحيين أو على صعيد مواقف المعترضين في المعسكر الأصولي الإسلامي من "التبديل المذموم" الذي بدأ مع معاوية بن أبي سفيان. ومصطلح التبديل هنا يشمل المستحدثات جميعها التي اتُّهم الأمويون بها، وأهمها موضوع الخلافة والشورى، وكذلك سياسة اللين مع "أهل الذمة".
نصف المدينة صلحاً
كانت معاهدة الصلح التي عقدها أبو عبيدة بن الجراح ومنصور بن سرجون قد ضمنت للمسلمين السيطرة على نصف المدينة، وذلك بسبب الدخول إليها بعد حصار طويل من البابين الشرقي صلحاً، والغربي (الجابية) عنوةً، أو العكس في روايات أُخرى، قبل أن يمضيها عمر بن الخطاب كلها صلحاً حين استشير بالأمر، فحصل المسلمون وفق تلك المعاهدة على نصف معبد جوبيتير الشرقي مقابل احتفاظ المسيحيين بكنيسة يوحنا في الجزء الغربي من المعبد.
كانت خطة الوليد أن يهدم مسجد معاوية بن أبي سفيان الذي يحتل الزاوية الجنوبية الشرقية من المعبد، وأن يبني مكانه مسجداً على كامل مساحة المعبد الروماني، وهي مساحة مترامية الأطراف. وبقيت الكنيسة الصغيرة نسبياً حجر العثرة أمام مخططه، إذ كانت تحتل الزاوية الجنوبية الغربية من المعبد، بمساحة تقل عن عشر المعبد.
ولذلك طلب النصارى وسألهم أن يخرجوا له عن هذا المكان، ويعوضهم إقطاعات كثيرة عرضها عليهم، كما يقول المؤرخون المسلمون، وأن يعطيهم أربع كنائس لم تدخل في المعاهدة، وهي: كنيسة مريم، وكنيسة المصلَّبة داخل باب شرقي، وكنيسة تل الجبن، وكنيسة حميد بن درة التي بدرب الصقل، فأبوا ذلك أشد الإباء. فقال: ائتوني بعهودكم التي بأيديكم من زمن الصحابة، فأتوا بها، فقُرئت بحضرة الوليد، فإذا كنيسة توما - التي كانت خارج باب توما على حافة النهر - لم تدخل في العهد، وكانت في ما يقال أكبر من كنيسة مار يُوحنا، فقال الوليد: أنا أهدمها وأجعلها مسجداً، فقالوا: بل يتركها أمير المؤمنين وما ذُكر من الكنائس ونحن نرضى ونطيب له نفساً ببقية هذه الكنيسة، فأقرهم على تلك الكنائس، وأخذ منهم بقية هذه الكنيسة.
وثمة رواية أُخرى تزعم أنه أُجريت قياسات بينت أن الكنيسة دخلت في العنوة، وذلك أنهم قاسوا من باب شرقي ومن باب الجابية فوجدوا منتصف ذلك عند سوق الريحان تقريباً، فإذا الكنيسة قد دخلت في العنوة، فأخذها، وعندها وافقوا ورضوا بعرضه المذكور. وسواء أكانت الرواية الأولى صحيحة أم الثانية، فإن الأمر جرى بالتراضي ووفق مقايضة معلومة.
من يهدم كنيسة يُجن!
وزيادة في إسباغ بعد درامي على الحدث، يذكر مؤرخ دمشق ابن عساكر (1106 - 1176م)، نقلاً عن مصادر قديمة، أن الوليد بدأ بهدم المنارة الشرقية ذات الأضلاع المعروفة بالساعات بيديه بعد أن حذره النصارى من أن من يهدم كنيسة يُجن، فقال "أنا أحب أن أجن في الله، ووالله لا يهدم فيها أحد شيئاً قبلي". ويقول ابن عساكر إن "الوليد والأمراء هدموا جميع ما جدده النصارى في تربيع هذا المعبد (يقصد معبد جوبيتير) من المذابح والأبنية والحنايا، حتى بقي المكان صرحة مربعة، ثم شرع في بنائه بفكرة جيدة على هذه الصفة الحسنة الأنيقة، التي لم يشتهر مثلها قبلها".
وكلام ابن عساكر تؤكده ما ذهبت إليه الدراسات المعاصرة بأن مسجد الوليد أكبر بأكثر من عشر مرات من الكنيسة البيزنطية الصغيرة المقامة داخل سور المعبد الروماني المسماة كنيسة يوحنا المعمدان، إذ تشير الدراسات إلى أن مساحة المعبد الروماني كانت تبلغ 1600 متر مربع.
تحدٍّ كبير
منذ زمن الأباطرة الأنطونيين في القرن الثاني الميلادي، توقفت حركة بناء المشيدات الضخمة في دمشق، ولم تُبن في المدينة كنائس كبيرة تعادل تلك الموجودة في أرياف كورة أنطاكية، أو في مدن صغيرة مثل هيبوس على ساحل بحيرة طبرية، أو قيصرية بانياس في لحف جبل الشيخ، فما بالك بكنائس القدس وما حولها، أو أنطاكية، أو حتى بصرى الشام، ولعل السبب أن معظم سكان المدينة احتفظوا بعقائدهم "الوثنية" حتى زمن الإمبراطور جستنيان (482 - 565م)، كما يشير الفيلسوف الدمشقي داماسكيوس (458 - 538م)، ولذلك تزايد الاهتمام البيزنطي بالمدينة بعد هذا التاريخ، وتعاظمت أهميتها بعد طرد الفرس من بلاد الشام على يد هرقل عام 627، فكان التحدي كبيراً أمام الوليد الذي أراد أن يربط دمشق بصرح إسلامي غير مسبوق على الرغم من أن المسلمين ما زالوا أقلية في المدينة.
كانت متطلبات إقامة الصلاة بسيطة وواضحة، وكما شكّل مخطط المسجد النبوي في المدينة المنورة مصدر الإلهام لمساجد الفسطاط والكوفة والبصرة، كان الأمر كذلك في ما يخص الشكل العام الذي فكر فيه الوليد، فبرزت الحاجة لبناء قاعة صلاة مغطاة يرتكز سقفها على الأعمدة. وكان الأمر سيكون ميسراً لو كان تطاول المعبد الروماني من الشمال إلى الجنوب، كون القبلة التي يصلي إليها المسلمون هي مكة المكرمة إلى جهة الجنوب. ولكن شكل المعبد يتطاول من الشرق إلى الغرب بطول 160 متراً تقريباً، وهذه مساحة شاسعة لا يمكن تطبيق أنموذج البازيليكا التقليدية عليها، وهي بناء يتكون من ثلاثة أجزاء: الصحن المركزي المتوسط، والجناحان على جانبي البهو تفصل بينهما الأعمدة. ولذلك جرى تكييف شكل البازيليكا بما يتناسب مع الأفكار الجديدة.
القبّة المزدوجة
وعلى الرغم من أن التصميم الداخلي ذي الأجنحة الثلاثة الممتدة من الشرق إلى الغرب استخدم مزيجاً من الأعمدة والتيجان المأخوذة من المعبد الروماني الكلاسيكي، إلا أن المبالغة في ارتفاع الجناح المركزي قد حقق التوازن المطلوب في هذا التصميم غير المعروف مسبقاً، لا في العمارة الرومانية ولا البيزنطية، تُضاف إلى ذلك فرادة القبة ذات القوقعة المزدوجة، وهي القبة التي وصفها ابن جبير حين رآها بأنها "من أعظم ما شاهدناهُ من مناظر الدنيا الغريبة الشأن، وهياكلها الهائلة البنيان: الصعود أعلى قبة الرصاص المذكورة، القائمة وسط الجامع المكرم، والدخول في جوفها، مع القبة التي في وسطها كأنها كرة مجوفة داخلة وسط كرة أخرى أعظم منها؛ صعدنا إليه في جملة من الأصحاب المغاربة من مرقى في الجانب الغربي من بلاط الصحن كان صومعةً في القديم".
ويضيف: "تمشينا على سطح الجامع، وكله ألواح رصاص منتظمة، وطول كل لوح أربعة أشبار، وعرضه ثلاثة أشبار، وربما اعترض في الألواح نقص أو زيادة، حتى انتهينا من القبة المذكورة، فصعدنا إليها على سلّم منصوب، فحبونا في الممشى المطيف بها، وهو من رصاص، وسعته ستة أشبار، فلم نستطع القيام عليه لهول الموقف فيه، فأسرعنا الدخول في جوف القبة، فأبصرنا مرأى تحار فيه العقول، وجُلنا في فرش من الخشب العظام حول القبة الصغيرة الداخلة في جوف القبة الرصاصية على الصفة التي ذكرناها، ولها طيقان يبصر منها الجامع ومن فيه، فكنّا نبصر الرجال فيه كأنهم الصبيان في المحاضر. وهذه القبة مستديرة كالكرة، وظاهرها من خشب قد شُدَّ بأضلاع من الخشب الضخام موثّقة، ينعطف كل ضلع عليها كالدائرة، وتجتمع الأضلاع كلها في مركز دائرة من الخشب أعلاها. وداخل هذه القبة، وهو ما يلي الجامع المكرم، خواتيم من الخشب منتظم بعضها ببعض، قد اتصل اتصالاً عجيباً، وهي كلها مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب، مزخرفة التلوين، يرتمي الأبصار شعاع ذهبها، وتتحير الألباب في كيفية عقدها ووضعها لإفراط علوّها، ثمّ انصرفنا منحدرين، وقد قضينا عجباً عجاباً من هذا المنظر العظيم، شأنه المعجز وضعه المرتفع عن الإدراك وصفه، ويقال: إنه ما على ظهر الأرض أعجب منظراً، ولا أبعد سمواً، ولا أغرب بنياناً، من هذه القبة".
وقد احتفظ مصمم المسجد بالبرجين الجنوبيين لاستدعاء المصلين برفع الأذان من فوقهما، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها المئذنة في العمارة الإسلامية.
فناء المسجد
ما تبقى من مساحة المعبد الروماني تحول إلى فناء جرت استعارته من تصميم المسجد النبوي في المدينة المنورة، وجرى تعديل أماكن الأعمدة الرومانية ليجري توزيعها حول الفضاء المفتوح، وسُقّفت الأروقة بأسقف تشبه قاعة الصلاة الكبرى، فغدا البناء بدعة معمارية. وما كان معبداً رومانياً مدهشاً في انتظام أعمدته وتناظر زواياه ومبنى السيلاه، أي "قدس الأقداس" المرتفع الذي يتوسط ذلك كله، غدا صرحاً جديداً سوف يثير إعجاب واستغراب كل من يراه بعد تزيين جدرانه بالفسيفساء، وهي خطوة غير مسبوقة على صعيد تزيين الجدران المكشوفة للهواء الطلق.
لا شك في أن الخليفة الوليد قد جمع جيشاً هائلاً من الحرفيين المحليين، وكذلك المستدعين من الأقاليم الأخرى، مثل مصر، وبلاد الجزيرة الفراتية، لرصف أكبر لوحة فسيفساء جدارية في ذلك الوقت، اقتضت، بحسب تقديرات المؤرخ الأسترالي روس أ. بيرنز صاحب كتاب "تاريخ دمشق"، 28 طناً من الزجاج والمكعبات الحجرية، منها 12 طناً باللون الأخضر وحده، جرى رصفها كي تتألق على المساحة بأكملها، وتلمع مثل حديقة رائعة، كل مكعب فيها مائل بعناية لالتقاط الضوء عند رؤيته من الأسفل.
ويقول البرفيسور بيرنز، وهو أستاذ في جامعة مكواري في سيدني: "إن ما نراه الآن هو نسخة أدنى بكثير من النسخة الأصلية التي تعرضت للحريق أكثر من مرة، ولكنها لا تزال كافية لإعطاء إحساس بتأثيرها الطاغي".
تخيُّل الجنة
لقد جرت تغطية كل سطوح صحن المسجد، فوق الجدران السفلية، بمشاهد خيالية لما يمكن أن تكون عليه الجنة وهي زاخرة بالحياة، ولكن من دون تمثيلات بشرية أو حيوانية. وبدلاً من ذلك امتلأت المساحات المرسومة بسجادة كثيفة من النباتات والجداول ذات الخلفية الذهبية، تتخللها البساتين والقصور والمسطحات والمنازل، مصممة بأسلوب يبدو أنه يستعير عناصر شرقية وكلاسيكية، وكانت ذروة هذه الرسومات على المدخل الرئيسي والتي لا تزال ملامحها قائمة حتى اليوم لأسباب شتى، أهمها طبقة الكلس التي كان حكام دمشق يغطون بها الرسومات الجميلة منذ العصر المملوكي، كي لا تشغل الناس عن الصلاة، كما أفتى لهم بعض شيوخهم.
ويقول البروفيسور بيرنز: "كانت التفاصيل المعمارية عبارة عن مزيج من أشجار ونباتات الغوطة، مثل التين واللوز والرمان والتفاح والإجاص، وكذلك السرو". ويعلق: "صحيح أن البيزنطيين سعوا أيضاً لتزيين بعض الأسطح المرئية بفن هندسي أو تمثيلي، لكن لم يذهب أحد إلى هذا الحد قبل الوليد، لتغطية ليس فقط الجدران الداخلية، ولكن مثل هذه المساحة الخارجية الضخمة من الفسيفساء الغنية المتلألئة في وفرة من الألوان، عبر ألف متر مربع من واجهة الفناء ذي القناطر الرخامية وأعمدتها، فقدم هذا، ولا سيما للجمهور العربي، شيئاً لم يُشاهَد أي شيء يمكن أن ينافسه في العالم منذ ذلك الحين".
حِرفيون أقباط وسريان
استدعى هذا الجمال من مؤرخي ورحالة العصور الإسلامية اللاحقة مزاعم وروايات متخيّلة حول إرسال الملك البيزنطي بنائين، لأن الوليد هدده بهدم كنائس بيت المقدس إن لم يرسل العمال، وهي مبالغات نشأت في أثناء الحروب الصليبية، لأن الوثائق بينت جوانب من هوية العمال الذين بنوا المسجد الأموي، منها بردية إدارية عائدة لوالي الوليد على مصر قرة بن شريك العبسي، الذي طلب نجارين من صاحب أشقوة للعمل في بناء مسجد دمشق، حيث بيّنت الوثيقة أن النجار سوف يُدفع له أجره ومعيشته ونفقة سفره بالحق.
وجاء في نص الوثيقة: "بسم الله الرحمن الرحيم، من قرة بن شريك إلى بسيل صاحب أشقوة في صناع للعمل في بناء مسجد دمشق (...) فقد قسمنا على كورتك نجاراً وقدرنا أجره ومعيشته لستة أشهر وكتبت بذلك كتاباً أُرسل إليك وفيه قيمة ما يعطى في أجره ومعيشته ونفقته وسفره. فإذا جاءك كتابي هذا فأنفذ ما فيه وعجل بإرسال الصانع إلينا في بابليون وليأخذ الطريق البري إلى مكان البناء. وإذا علمت أن هذا الصانع من كورتك وهو نفسه الذي عمل على ذلك البناء عام الأول وأنه مستقر في كورتك فأرسله نفسه من جديد ومعه آلاته ليذهب من فوره لمباشرة عمله".
وثمة نقوش سريانية عُثر عليها في كامد اللوز في بقاع لبنان، توثق لمقلع حجارة من عهد الوليد بن عبد الملك، يقوم عليه حرفيون من بيت نوهدرا (دهوك الحالية) في شمالي العراق.
إعلان إمبراطورية
كان المسجد الأموي كما أراده الوليد، المركز المتلألئ لحضارة جديدة ستتطور رموزها المعمارية ذات النسب الهائلة في عهد الخلفاء الذين أتوا بعده، وخصوصاً شقيقه الأصغر هشام بن عبد الملك، صاحب المشيدات الضخمة في فلسطين والبادية، والمزينة بأروع الزخارف والحلول المبتكرة، ولذلك كان ينظر إلى مسجد دمشق الأموي وكأنه الإعلان الذي أراده الوليد عن ولادة إمبراطورية أكبر من إمبراطورية الإسكندر.
* كاتب وباحث سوري فلسطيني