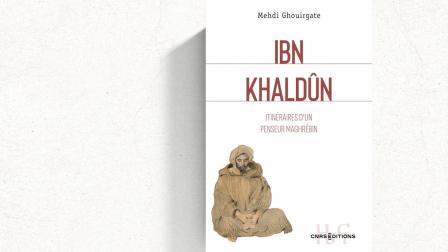"ذاكرتي مثل منخل يجمع الرمل
شعوري بالوقت ساعة رملية فارغة
حاسّةُ المكان لديّ بوصلةٌ منحرفة
العاقبة كانت أعظمَ ما تنعّمتُ به
وقد رتّقتُ ثقوبَ رأسي الضوئية".
تقودنا هذه الأسطر، من الديوان الثاني للشاعر الفلسطيني الدنماركي يحيى حسن (1995-2020)، إلى لحظاتٍ لامعة بصفائها، وإلى محاولته محاصَرَة ذاته وانتزاع اعترافٍ منها. وليس غريباً أن يعود القارئ من جديد إلى آخر ما كتبَه هذا الشاعر الشاب قبل موته المفاجئ والصادم، إلى نصوصه التي اعتُبرت من النقاط الأشدّ سطوعاً في خريطة الشعر الدنماركي المعاصر. وما تلك الرغبة من القارئ سوى رغبة في القبض على لغز الطاقة التي كانت تسك يحيى حسن. تلك الطاقة التي كانت، على الصعيد الشخصي، مبعث زهوٍ وانتشاء بالنسبة إليه. لأنها هي التي حرّكته، وهو في أوّل تفتّحه، إلى مركز الإبداع، حين دفعت به إلى كتابة أقوى النصوص التي جمعت العسر واليسر، لتزلزل المتعارف عليه والمسكوت عنه، بطريقته المدهشة.
بهذا اكتسب حسن هويّة كان قد حَلم بها، غير الهوية التي مُنِحَت إليه: هوية اللاجئ والمهاجر الطاعنة في الحطِّ من قيمته واختزاله إلى أحد هؤلاء الذين يخوضون في وحل الغيتوهات وعوالم العصابات لا غير.
ما دمتَ قد قبضتَ على الحياة بالكلمات فأنتَ حيٌّ يا يحيى
كان الشاعر في كتابه الأوّل ("يحيى حسن"، منشورات "غولديندال"، 2013) قد ذهبَ بعيداً في وصف الإجحاف الذي واجهه بكلّ جوانبه، مقارنة بكتابه الثاني ("يحيى حسن 2"، منشورات "غولديندال"، 2019)، وذلك عبر التقاطات ذكية بدقّة متناهية، وبلغة لوى بها ذراع شرقيّتها وغربيّتها.
لكنّ تلك الطاقة الفذّة كانت تقف خلف روح مُقَلقَلة، يائسة، لا قرار لها. بوادرها كانت حين بدأ يحيى حسن بالتعبير عن نفسه عبر فنّ الراب في أوّل مراهقته: ثورة على كلّ شيء، لم يسلم منها أحد، ولا حتّى هو نفسه. استمرّ مؤكّداً لنا، وبروح صبيانية متمرّدة وحرّة، أن لا أحد سينال منه. لا المتطرّفون في جاليته من المتأسلمين، ولا اليمينيون، ولا الموظّفون في كلّ الأمكنة التي أُلقي به فيها على مرّ حياته، من الإصلاحيات إلى السجون إلى المصحّات.
تلك الروح القلقة، ذلك الخذلان والعوز- رغم ادّعاءاتٍ هنا وهناك- بانت بوضوح في كتابه الثاني، وقد كان الأخيرَ للأسف الشديد. في قصائد هذا الديوان نجد المعوّقات وهي تحاصره بازدياد. ذلك الدرع الواقي من الرصاص الذي اقتضى أن يرتديه في كلّ مكان بسبب محاولات اغتياله، كان مرّةً مصدر اختيالٍ وزهْو، ومرّة مصدر ضيق وسخرية من نفسه ومن جهاز الحماية الذي رافقه، ومن نظام الدولة الذي اصطدم به.
قمّةُ تهكّمه تتبدّى في إحدى قصائده التي أظهر فيها أنّه لا بالبدلة الرجّالية، ولا بقميص المجانين كان يمكن له أن يُرضي جميع الفئات، وما الذي تبقّى له ويمكن تخيُّله أخيراً غير الكفن، وحده الذي سيليق بجسده؟ الاستياء كان في أشدّه، من حالة التمزّق التي كان محكوماً بها نفسياً، ومن العالم خارجاً، حين لم يُترَك له خيارٌ غير المخالفة (تقريباً الضياع) لتحفظ له كبرياءه. ذلك الكبرياء الذي كان فهمُه له، في جزء كبير منه، خاطئاً، وفق تربية قاسية ومتخلّفة وبيئة فقيرة بانفتاحها على الممكنات، والتي لم تكن قليلة.
أعدتُ مثل قرّاء كثر آخرين قراءة ديوانه الأخير. وفي ذكرى عيد ميلاده، التي مرّت الشهر الماضي (التاسع عشر من أيار/مايو)، كتبتُ إليه بطاقة أُرَبِّتُ عبرها على تلك الروح: "ما دمتَ قد قبضتَ على الحياة بالكلمات فأنتَ حيٌّ يا يحيى. يفتقدُكَ العالَم بشدّة لإيقاظه. حين نرى القبح وليس غيرك مَنْ تتلوّث يداه وأنت تجرؤ على جرِّهِ صاغراً إلى القصيدة. حين تتراكم المآسي ولا نملك غير أن نستمعَ لعصفِها، وقد أهلكَتْكَ تلك الطاقة الاستثنائية التي تكمن في الأسطر. قذائف، أسلحة، رمّانات يدوية، قنابل دخان، أسرّةٌ ذات أحزمة جلدية، وقمصان جنون.
أطلقوه ليخنق بهذيانه الأصوات المخاتِلة الناعمة".
أريدُ للناس أن يذكروني كأحدِ الذين لم يُقتَلوا لِلاشيء
هنا ترجمةٌ لقصائد مختارة من ديوانه الثاني والأخير، "يحيى حسن 2".
موعد مع دار النشر
مُنطلقاً من المجمّع السكنيّ
مرتدياً الدرع الواقي في عزّ الصيف
على السكّة صوب العاصمة
الحقائبُ تُثقِلُ روابطَ يدي بالسخط
وجهاز الأمن يراقبني
يُعرّيني عند نافذة عرْض دار النشر
إنهم يستلذّون بالشُبهات
ويفرغ كلٌ منهم حقيبةً
ملابس وسِباب تُقذَف على الإسفلت
أجمعُها
الأزعر يضربني على صدري
ويزعق بالدرع مثل مُخنّث
أقولُ إنّي لستُ سوى شاعر في طريقه إلى دار نشره
"أنتَ شاعر؟"، يسأل الشرطيّ المأمور
يتحقّق من رقمي الشخصي لاتّهامي
"أنتَ مجرم"، يقول الشرطي المأمور
أتصلُ بمحررّي
من أجل أن يضمنَ لهم سيولتي الشِعرية
وينقذني بمظهره الباعث على الثقة
المحرّر باسترناك يقترب من الشرطة أثناء أداء الواجب
يُهدَّد باعتقاله
فيعودُ متثاقلاً إلى دار النشر
مثل الغُرنوق
■ ■ ■
هياج
ارتديتُ درعاً واقياً من الرصاص تحت سترتي
منذ العام 2013
صدّقوني: تعبتُ منه،
رائحته صارت كريهة مثل عرق ثور
وأنا صرتُ عنزةً مُطارَدة.
■ ■ ■
في زيارة رسمية
أتسكّع في أوروبا
مع ديواني في جيب سترتي الداخليّ
حرّاسي يصوّبون خطوتي ويوجّهونني
المساكين عيشُهم في حياتي
أفضل بكثيرٍ منّي
يوقظونني حين أنام طويلاً
يرافقونني مثل ملكةٍ
يَشْكون من دخاني
وأردُّ بضربةٍ أسرعَ منهم
بُطْؤهم وخضوعهم
لا يتركان بي أثراً
حلمتُ بالاضطلاع بأدوار البطولة
ولكنّي حُجزتُ للأعمال القذرة
كنتُ جزءاً مهمّاً من رخائهم
ولكنهم شَكلّوا جزءاً كبيراً من انهياري
أُسكِّن عَصَباً في الوعي
بينما يراقبون اللا شيء
ويتشمّمون المعلومة
ذاكرتي مثل منخل يجمع الرمل
شعوري بالوقت ساعة رملية فارغة
حاسّةُ المكان لديّ بوصلةٌ منحرفة
العاقبة كانت أعظمَ ما تنعّمت به
ولقد رتّقتُ ثقوبَ رأسي الضوئية.
■ ■ ■
ضغطٌ متقاطع
أكادُ أُسْحَق ما بين هيكل سُلطتَيْن
واحدة متنفّذة مِن فوق فما دون
وأُخرى متنفّذة من تحت فما فوق
وأنا أعافرُ بذراعيّ وقدميّ.
■ ■ ■
حُبّ
كان علينا أن نحضن بعضنا البعض
ولكنّنا تصادَمْنا مثل حشرتَيْن
مداعبتي تخلّف نُدباً
كالشِّعْر لا يمكن تحاشيه
أنا الآن لكلّ هذا أُمَسِّدُ أحبّتي
حيث المكان الأقلّ ضرراً
حيث المكان الأقلّ وجعاً.
■ ■ ■
قصيدة قَمَرية
لا أودّ الرجوع إلى القمر
أقفُ بدرعي الواقي وأجامعكِ
في فناءٍ للمخلّفات
أريدُ للناس أن يذكروني كأحدِ الذين
لم يُقْتَلوا لِلا شيء
على هذه الأرض!