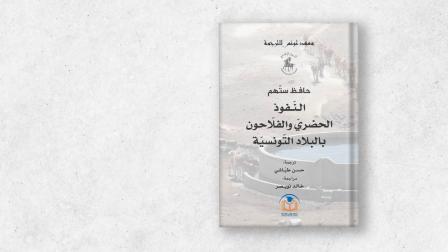مع أنها تقع على بعد عشرين كيلومتراً فقط من الحدود الغربية للجزائر، فإن الذهاب إلى مدينة وجدة في المغرب انطلاقاً من "مطار هوّاري بومدين"، في العاصمة الجزائرية، يتطلّب قطع مسافةٍ تزيد عن الألف كيلومتر؛ إذ ينبغي التوجُّه أوّلاً إلى مدينة الدار البيضاء في أقصى غرب البلاد، ثمّ قطع قرابة 600 كيلومتر أخرى للعودة مجدّداً إلى أقصى شرقه. وهذه الرحلة الطويلة نسبياً لا يفرضها فقط غياب خطّ جوّي يربط بين الجزائر ووجدة، بل استمرار إغلاق المعابر البريّة بين البلدَين منذ 1994.
بالوصول إلى "وجدة أنكاد"، وهو الاسم التاريخي للحاضرة التي أسّسها زعيم قبيلة مغراوة الأمازيغية زيري بن عطية عام 994، سيجدُ الزائر نفسه في مدينةٍ فسيحة، تتميّز بالهدوء مقارنةً مع عاصمة المغرب الاقتصادية مثلاً.
تجمع وجدة مزيجاً من العمارة الحديثة والمباني القديمة التي استلهم بعضُها من العمران الأندلسي، إلى جانب عددٍ من المعالم العمرانية الأوروبية؛ مثل "كنيسة سان لويس" التي تنتصب أمام مسجدٍ في شارع محمّد الخامس، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من مئة عام، وكانت أوّلَ كنيسة بناها الاستعمار الفرنسي بعد دخوله البلاد، وأيضاً "مدرسة سيدي زيّان"، غير بعيدٍ عنها، وهي، أيضاً، أوّل مدرسةٍ عصرية في المغرب، وقد بناها الفرنسيّون عام 1907، أي قبل خمس سنواتٍ من فرض الحماية، ولا تزال تفتح أبوابها للطلّاب إلى اليوم.
في وجدة، لا تخفى ملامح التقارب الكبير مع الجزائر على مستوى اللهجة والثقافة والموسيقى، فضلاً عن بعض العادات والتقاليد. وفي الشارع، يُمكن الاستماع إلى أكثر من حديثٍ عن الأثر الثقيل لاستمرار إغلاق الحدود على المدينة والتنمية فيها. لكن، وعلى ما يبدو، فإن حركةً أخذت تدبّ في السنوات الأخيرة وباتت تَعد بتغيير وجه المدينة. يتجلّى ذلك في إنجاز عددٍ من المرافق والمنشآت الاقتصادية والثقافية الحديثة؛ مثل المطار الجديد الذي افتُتح عام 2010، ومبنى المسرح الذي افتُتح في صيف 2014.
في 2018، أصبح "مسرح محمّد السادس"، الذي يتربّع على مساحة 6500 متر مربع ويضمّ قاعة عرض تستوعب 1200 مقعد إلى جانب قاعات وفضاءات أخرى، وجهة ثقافية أولى في عاصمة "المنطقة الشرقية" مع احتضان المدينة تظاهرةَ "عاصمة الثقافة العربية" ابتداءً من منتصف نيسان/ أبريل الماضي. وحتى ذهاب الاحتفالية إلى مدينة بورتسودان السودانية في آذار/ مارس المقبل، تستقبل وجدة أكثر من 900 نشاطٍ ثقافي وفنّي يشارك فيها قرابة 1200 شخصية ثقافية من المغرب وخارجه.
"المعرض المغاربي للكتاب" كان إحدى الفعاليات الثقافية التي احتضنها مبنى المسرح مؤخّراً. فبعد دورة أولى نُظّمت بين 21 و24 تشرين الأوّل/ أكتوبر من العام الماضي، عاد المعرض، الذي تنظّمه وزارة الثقافة والاتصال بالشراكة مع عددٍ من المؤسّسات، في دورة جديدة نُظّمت بين 18 و21 من الشهر الجاري تحت شعار "آداب مغاربية"، عرفت مشاركة 25 ناشراً من المغرب وبلدانٍ مغاربية أُخرى، بزيادةٍ ملموسةٍ عن الدورة السابقة التي عرفت مشاركة 17 ناشراً. ولئن بدا الرقم ضئيلاً، بالمقارنة مع معارض الكتاب الأخرى، فإن القائمين على التظاهرة يقولون بأنهم أعطوا الأولوية للكيف لا الكمّ، واعتمدوا معايير صارمةً في خياراتهم، بهدف حضور "أبرز وأفضل الناشرين".
نُظّم المعرض داخل خيمةٍ كبيرة قبالة مبنى المسرح، بينما خُصّص الأخير للندوات واللقاءات والورشات. وصل عدد الندوات إلى 34 ندوةً شارك فيها 120 محاضراً من أصل 350 مشاركاً من المغرب وبلدان عربية وأجنبية أخرى، وتناولت مواضيع متنوّعة تصبّ، بشكل أو بآخر، في ثيمة الدورة الثانية: "مقاربة الكوني"، والتي قال المنظّمون إنها تروم مساءلة علاقة الهيمنة بين المركز الغربي و"بقية العالم"، ومن ضمنه البلاد العربية.
أثارت الندوات قضايا فكرية مختلفةً؛ مثل: "الإسلام والحداثة"، و"المغرب الكبير: الصورة عند الآخر"، و"المشرق والمغرب الكبير: بين الأنا والآخر"، و"الشرق والغرب: أفقاً للتفكير"، وأخرى اتّخذت أبعاداً ثقافية وأدبية ولغوية؛ مثل: "سؤال الكتابة"، و"الكتابات المغاربية"، و"الكتابات النسوية"، و"الإبداع باللغة الأمازيغية"، و"أن تكون كاتباً بالعربية اليوم"، و"الترجمة والكوني"، و"متخيّل اللغات". بينما أضاءت أخرى على قضايا الثقافة والهجرة؛ مثل: "المهاجر اليوم"، و"الهجرة والعولمة".
وأفردت الدورة، التي حلّت كوت ديفوار (ساحل العاج) ضيف شرفٍ عليها بناشرَين اثنين وعدد من الكتّاب، مساحةً لمناقشة مسائل ذات علاقة بالثقافة الأفريقية في القارّة السمراء وخارجها؛ مثل: "الكتابة والإبداع في أفريقيا"، و"الجالية: هويّات أفريقية متعدّدة"، و"أيّ مكانة للكوني في الفضاء الأفريقي متعدّد الثقافات؟".
شاركت في الندوات أسماء ثقافية من مجالات إبداعية وأجيال مختلفة؛ من بينها: هدى بركات ورشا الأمير من لبنان، وحبيب السالمي وإيناس العبّاسي ومعز ماجد من تونس، وسميرة نقروش وأمل بوشارب من الجزائر، وميشيل خليفي وباسم النبريص وعبّاد يحيى ونجوان درويش من فلسطين، وهيفاء زنكنة من العراق، ومحمّد الأشعري وسامح درويش وثريا ماجدولين وسكينة حبيب الله من المغرب، وصباح السنهوري من العراق، وخلود الفلّاح من ليبيا، وكارل شكمبري من مالطا، وسيموني سيبيليو من إيطاليا. بدت هذه الاقتراحات محاولةً للانفتاح على أكثر من جيل وأكثر من مجال: الكتابة الأدبية من شعر وقصّة ورواية، والأكاديمية، والسينما، والخروج من دائرة الوجوه الضيّقة التي باتت حاضرةً بشكل قارّ في معظم معارض الكتاب العربية.
على أن المعرض لم يقتصر على الأسماء القادمة من "المركز"/ "المراكز" العربية؛ بل استضاف قرابة ثلاثين كاتباً من المنطقة الشرقية، وقّع بعضهم إصداراتهم على هامش فعالياته، كما هو الأمر بالنسبة إلى الشاعرَين جمال أزراغيد وعلي أزحاف.
عن الندوات، يقول رئيس المعرض، محمد المباركي إنها كانت "ناجحةً على مستوى المحاضرين ونوعية المواضيع التي طُرحت، وأيضاً على مستوى إقبال الجمهور"، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في ختام التظاهرة بأنّها "اتّسمت بحريّة مطلقة، بحيثُ لم تُمارَس أيّة رقابة على المشاركين".
بالموازاة مع الندوات الأدبية والفكرية، نُظّمت طيلة أيّام المعرض ورشات للقراءة والكتابة الموجّهة للأطفال، إضافةً إلى أنشطة أُقيمت في جامعة المدينة وعددٍ من مدارسها. كما أُقيمت عددٌ من الأمسيات الشعرية؛ أبرزها تلك التي احتضنتها "دار السبتي"، وهي مبنى تاريخي أثري يعود بناؤه إلى العام 1938، بمشاركة شعراء من عدة أجيال وحساسيات شعرية فتحضر على سبيل المثال قصيدة محمد بنّيس إلى جانب أصوات جديدة في الشعر المغربي مثل سكينة حبيب الله أو ديمة محمود من مصر. ويحضر صوت فكتور رودريغث نونيّث من كوبا، وكارل شكمبري من مالطا، كما سمعنا سميرة نقروش من الجزائر، ومعزّ ماجد من تونس وكلاهما يكتبان بالفرنسية.
انتهى المعرض بعد أربعة أيّام لكنه استمرّ بشكل آخر، من خلال قافلةٍ أعلن المباركي عن انطلاقها إلى عددٍ من القرى والأرياف بهدف تشجيع الأطفال وتلاميذ مدراس المناطق النائية على القراءة، وأيضاً من خلال هذا الانفتاح الذي تُبديه وجدة على الثقافة والعالم، كأنما ترفض أن تكون مجرّد "مدينة بعيدة".