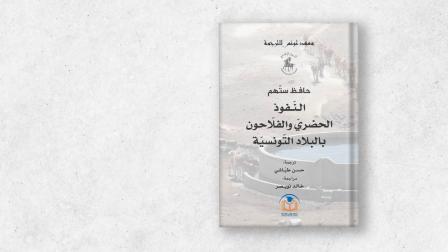لا تزال الأندلس تسحر المؤرخين والمفكرين والأدباء وتبعث فيهم الحنين إلى حِقبة القرون الثمانية التي شهدت الحضور العربي-الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية من عام 711 إلى عام 1492.
ولا تزال تلك الفترة وما تلاها تثير أسئلة حارقة ليس فقط حول العوامل التي أدت إلى زوالها، بل والأسباب الداخلية التي أسهمت في ازدهارها المذهل، حين كانت سائر أوروبا ترزح تحت نير الظلامية والتعصب. ولذلك شاع حول الأندلس بالذات، أكثر من أية منطقة أخرى في العالم، كمٌّ هائل من التخيّلات، فامتزجت في تصورها الحقائقُ بالأساطير.
من هنا قرر المؤرخ الفرنسي، المتخصص في التاريخ الإسباني، جوزيف بيريز (1931) إنجاز ما يشبه الحفر الأركيولوجي لهذه المادة الضخمة التي تشكلت، على مر العصور، من الصور والتمثلات التي نسجها المخيال الغربي-المسيحي حول الأندلس وسقوطها، من أجل تعرية دوافعها الدينية والحزبية وحتى الطبقية. فأصدر مؤخراً كتاب "الأندلس، حقائق وأساطير" (منشورات تايلندييه، باريس).
وفي البدء، يجدر التنويه إلى أنَّ Andalousie الحالية، بحسب التقسيم الإقليمي الإسباني، لا تضم كامل المنطقة التي اصطَلَح العرب على تسميتها بالأندلس، فهذه أوسع وأشمل، إذ ضمت وقتها إسبانيا وجزءًا من البرتغال.
يتعلق موضوع الكتاب بتفكيك "العقدة الكبرى"، التي طالما أرقت الضمير المسيحي، وهي التناقض الصارخ بين مبادئ المحبة والسلام التي يدعو إليها وبين ضراوة محاكم التفتيش والجرائم التي ارتكبت ضد العرب المسلمين، قبل وبعد أن يُخرجوا من ديارهم ويُسلبوا أموالهم. وللتخفيف من شعور الذنب هذا، نشطت المسيحية الأيبيرية المنتصرة في ابتكار "حب المورسكية" maurophilie بما هي إحساس بالتعاطف والشفقة إزاء المسلمين المُضطهدين.
ثم رسّخت الأعمال الأدبية وملاحم القرون الوسطى هذه النزعة حتى جعلت من المعارك التي دارت بين الفريقين وقتها مجرد "مواقع فُروسية نبيلة"، كما بنت أسطورة العيش المشترك بين الديانات الثلاث التي تمازجت في بوتقة واحدة. وفكك الكتاب عقدة ثانية: تلك التي ظهرت في المرحلة اللاحقة، الأقل وردية، حيث شاعت صورة جهالة المورسكيين واعتبارهم سببًا في تخلف إسبانيا وتأخر ظهور الحداثة فيها.
ولذلك يعسر تصنيف الكتاب في خانة التأريخ السياسي، كأعمال سابقة لبيريز حول إسبانيا. كما أنه ليس بتأريخ ثقافي يرصد ظواهر الفكر ومنتجاته الذهنية، كما تعودنا في معظم الكتابات التي تناولت تاريخ الأندلس، بل هو أقرب إلى التحليل الإناسي لأهم الأساطير التي نُسجت حول هذه المنطقة وما عاشته من أحداث منذ وصول طارق بن زياد عام 711 حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية.
 ويُذكر للمؤلف سعيه إلى تحقيق التوازن بين حقائق التاريخ ومنتجات الخيال التي تغذيها مخاوف الراهن ورغباته، فتؤثر في تأويل تلك الحقبة، مما يولد إما مَشاعر تحسُّر على "الفردوس المفقود"، أو بالعكس إحساسًا بكراهية الآخر المغاير، يُترجَم بخطابات مُعادية تنادي بتشويه فترة حكم المسلمين واعتبارها مجرد احتلال. ولئن تعوّد المؤرخون والمستشرقون التركيز على الفترة الكلاسيكية، فقد جهد صاحب "تاريخ إسبانيا" في ربط تلك الحقبة بأهم المتغيرات الآنية التي تسم إسبانيا اليوم مرورًا بما عرفته منذ القرن السادس عشر. فهي قراءة تمتد في الزمن وتغطي اثني عشر قرنًا، مع التركيز على القرون الوسطى.
ويُذكر للمؤلف سعيه إلى تحقيق التوازن بين حقائق التاريخ ومنتجات الخيال التي تغذيها مخاوف الراهن ورغباته، فتؤثر في تأويل تلك الحقبة، مما يولد إما مَشاعر تحسُّر على "الفردوس المفقود"، أو بالعكس إحساسًا بكراهية الآخر المغاير، يُترجَم بخطابات مُعادية تنادي بتشويه فترة حكم المسلمين واعتبارها مجرد احتلال. ولئن تعوّد المؤرخون والمستشرقون التركيز على الفترة الكلاسيكية، فقد جهد صاحب "تاريخ إسبانيا" في ربط تلك الحقبة بأهم المتغيرات الآنية التي تسم إسبانيا اليوم مرورًا بما عرفته منذ القرن السادس عشر. فهي قراءة تمتد في الزمن وتغطي اثني عشر قرنًا، مع التركيز على القرون الوسطى.
وأما تبويب الكتاب فيبدو في ظاهره بسيطًا: مقدمة، عنونها بـ"من البوتيكا Bétique إلى الأندلس"، تطرق فيها المؤرخ الفرنسي إلى تحوّل هذه المنطقة من مقاطعةٍ ضمن الإمبراطورية الرومانية إلى ولاية أُموية طيلة العصر الوسيط، ثم مظاهر استعادة أوروبا لها ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. وبعدها، قسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء بحسب أسماء المناطق: تناول في القسم الأول الحياة في غرناطة، ثم في إشبيلية وختمه بقُرطبة. وخصص الخلاصة إلى دراسة وضع هذا الإقليم اليوم.
وفي كل جزء، يستعرض أهم الخصائص التي ميّزت هذه المدن التي شكّلت حواضر الأندلس واحتضنت ثقافته الزاهرة، فقد غدت غرناطة بمعمارها وحدائقها منشأً لنزعة رومانسية استشراقية، صبَّ فيها الغرب رغبته في ابتكار "شرقٍ سحري خلابٍ" ولكن ضمن حدود أوروبا. وأما روح إشبيلية فإلى الغرب أقرب، فمنها سيرَ إلى اكتشاف الأميركيتين وفي شوارعها نشأت ظواهر مثل الكوريدا وموسيقى الغَجر ورقصة الفلامنكو.
وخصص المؤلف فصل قرطبة إلى تحليل الإشكالية- الأم التي تتعلق بالثنائية الحادة: أسلمة إسبانيا أم أسْبَنَة الإسلام؟ ومفادها السؤال هل تأثر الإسلام بخصائص هذه المنطقة الثقافية والجغرافية، فنجم عن هذا التأثر ازدهار العلوم الصحيحة (مع ابن زَهْر مثلاً) والفلسفة (ابن رشد) والفقه المالكي والظاهري (القُرطبي وابن حزم)؟ أم إن الإسلام، رؤيةً للحياة، هو الذي طوَّع شبه الجزيرة لتعاليمه وشكّل حساسية أهلها وفق مبادئه؟ كما عاد بيريز، في هذا الفصل، إلى مساهمة حضارة الإسلام الأندلسي في نهضة أوروبا وإمدادها بجل النصوص الفلسفية والعلمية، تراثٍ تُرجم إلى اللاتينية، عبر العبرية أحيانا، فكان المنبع الأغزر لانطلاقة أوروبا الحديثة ونهضتها.
ومن بين الأساطير التي توقف عندها الكاتب، مُبينا سطحيتها وغلبة الأيديولوجية عليها، صورة التعايش المطلق بين المسلمين وغيرهم من الطوائف، كاليهود والنصارى، مما يقدم مثالاً لحياتنا المعاصرة. وهذا ما دفع بأنصار الكاثوليكية الفَرنكية (نسبة إلى الرئيس فرانكو 1882-1975) إلى اعتبار هذه المنطقة، تماما كما يعتبرها المسلمون، "الفردوسَ المفقود"، ناقدًا بذلك مغالطة تاريخية كبرى: تُسقط هواجس اليوم وهمومه على الماضي وهو منها براء.
وهكذا، يمكن عد هذا الكتاب تحولاً نوعيا في أسلوب الكتابة عن الأندلس، فقد شاعت في كتب المستشرقين والمستعربين الدراسات المعمقة حول العائلات الحاكمة، كمدونة المستشرق ليفي- بروفنسال (1894-1956) بعنوان "تاريخ إسبانيا المسلمة"(1950)، أو حول نصوص الأدب، شعرًا ونثرًا، التي صيغت بالأندلس ومنها كتاب هنري بيريز: "الشعر الأندلسي بالعربية الفصحى"(1939)، أو دراسة عفيف بن عبد السلام حول: "الحياة الأدبية في إسبانيا المسلمة في عصر ملوك الطوائف"، (2001).
وقد يُعلل هذا التحول النوعي بجهل المؤرخ بيريز باللغة العربية، على عكس جيل المستشرقين الأسبق، الأمر الذي جعل معرفته عن هذه الحقبة مقتصرة على الأبحاث المكتوبة باللغات الأجنبية، ولا صلة لها بتحقيق النصوص الأصلية. ونراه إذا احتاج إلى إضاءة مسألة حضارية تتصل بالإسلام، عاد إلى مراجع لا تتسم بمصداقية كبيرة مثل أعمال دومينيك أورفوا.
وهكذا، سعى الكاتب إلى إعادة تصوير التحولات العميقة التي طرأت على شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال) من نظام الخلافة الأموية إلى الممالك والجمهوريات الأوروبية، ومن الفلكلور إلى الحداثة، ناقدًا في ثنايا ذلك الفكرة التي يروج لها مؤرخو أوروبا الغربية والشمالية الذين جعلوا حقبة القرون الوسطى مرادفة للتخلف والتعصب.
ولعله من المفيد أن نستأنس بمثل هذا العمل، الذي صيغ لمساءلة الأساطير التي حيكت حول الأندلس في الغرب، في العودة إلى أساطيرنا العربية، وهي بلا شكٍ مجال للنظر خصيب، يمكن أن يفضي إلى نقد المنهج الذي نتداول به تاريخ الأندلس اليوم وأساليب مؤرخينا في صياغته، ومن أي الزوايا تناولوه. كما لدينا مادة ثرية في الأدب من أشعار أحمد شوقي إلى "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور، وأبعد من ذلك أعمال سينمائية ودرامية مثل فيلم "المصير" ليوسف شاهين أو الثلاثية التلفزيونية التي أنجزها الكاتب وليد سيف والمخرج حاتم علي. وهي تستأهل أن يعاد إلى تفكيكها لتمييز ما تمازج فيها من حقائق العلم ونفحات الأساطير.