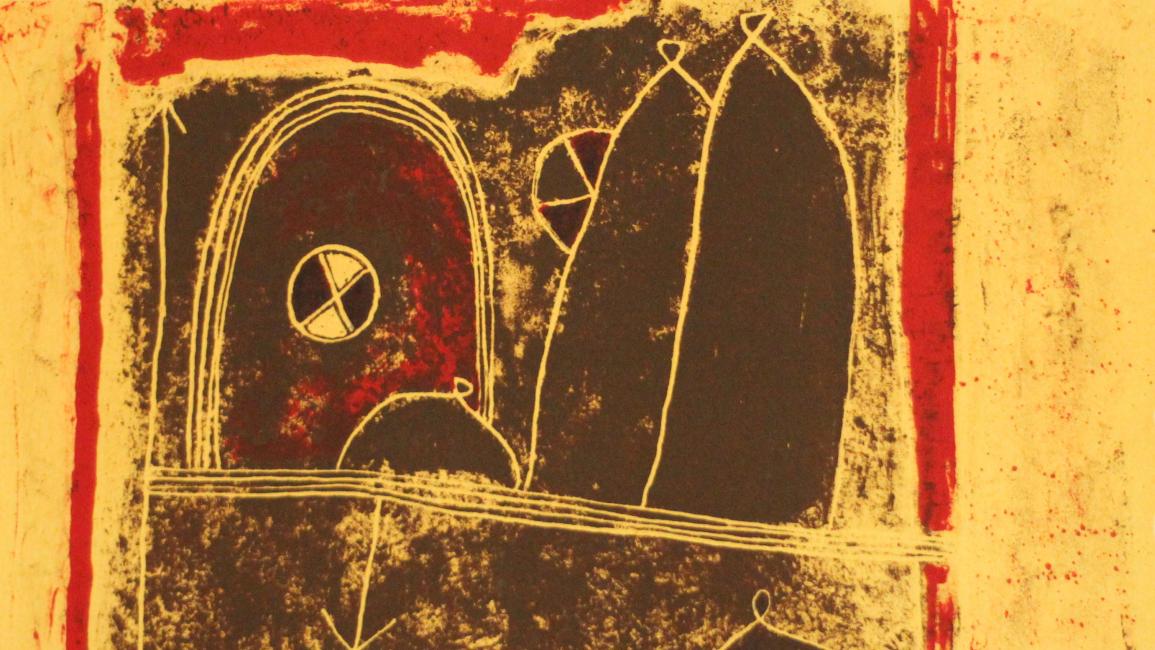محاولة فاشلة لإسكات ضمير
(فريد بلكاهية)
لا وقت ولا حاجة لزخرفة القول، ما دام الدم البريء يشاغب الحياة كلها في مدن قطاع غزّة. أتساءل كلما أردت الكتابة مجدّدا عن الذي يحدث هناك عمّا يمكن إضافته الى ما كتبته وكتبه غيري طوال أربعين يوما مضت. لكنني لست بحاجة لإجابة، فالسؤال مستمرٌّ ومتجدّد، وتبدو الإجابة عنه نوعا من الترف في سياق الموت بكل أشكاله المتاحة؛ تحت الأنقاض، وبالرصاص وبالقصف المباشر، وبانعدام الدواء، وبالجوع والعطش، وبالضياع في متاهة الحرب التي تتّسع يوما بعد يوم بلا كهرباء ولا إنترنت، ولا تواصل مباشر وحقيقيا بين الناس هناك.
في أحد المشاهد المصوّرة في غزّة لمن اضطروا للنزوح من الشمال الى الجنوب، رأيت مجموعة من الأطفال يستقلون عربة خشبية متهالكة يجرّها حمار، ويقودها رجل لا يبدو أنه يعرفهم.. اعترضتهم، بعد قليل، سيدةٌ اتضح لاحقا أنها والدتهم. كان المشهد مأساويا وسط الفرحة الصغيرة المقتنصة لهم من بين الدمار كله في المكان والزمان. من الصعب أن لا يكون مشهدٌ كهذا في شكله الرمزي عنوانا لما يحدُث في غياهب المتاهة. مشاهد كثيرة تصوّرها الهواتف الصغيرة لتبثّها في العالم كله نوعا من التواصل متى ما توفّر قليل من طاقة الإنترنت وطاقة الكهرباء لأولئك الذين يحاربون حكومات الغرب بكل ما توصلت إليه من تقدّم في مجال الأسلحة، ممثلة بجيش الكيان الصهيوني. هل كتبت "تقدّم"؟ يا لها من مفارقة أن يتقدّم البشر على صعيد ما يمكن أن يبيد فيهم بشريّتهم شيئا فشيئا. غزّة التي تقاتل المحتل اليوم وتدافع عن نفسها بعد حصار سنواتٍ أنهكها، ترسم لنا خريطة معقدة للبشرية في ما يمكن أن تصل إليه، بعدما جرّبت الحرب والسلام، والجهل والعلم، والموت والحياة، فانحازت للحرب والجهل والموت.. لينجو فيها، كما تظنّ، إنسانها المختار بعنايةٍ وإتقان؛ الأبيض الأوروبي الأميركي الذي ما زال منشغلا بوضع أسس الليبرالية والتقدّمية والديمقراطية والمساواة والحرية وحقوق الإنسان.. الذي يشبهه وحسب.
نعود إلى الكتابة عن غزّة التي تمارس حياتها المستحيلة عبر قوافل الموت الكامن حتى في حاضنات الأطفال الخدّج في مستشفياتٍ أصبحت الهدف المفضل للقصف والدمار الصهيوني. شعرتُ بتأنيب ضمير فتك بأعصابي بعد لحظة ارتياح خفي انتابني عندما قرأتُ خبرا عن موت الأطفال الخدّج في تلك الحاضنات، بعدما انقطعت عنها الكهرباء، وأصبحت قبورا زجاجية لهم. اكتشفتُ أنني وقعت في فخّ الحلول السهلة، والتي لا يمكنها أن تفعل سوى أن تجعلني أشعر بالارتياح، عندما تنتهي المشكلة المعقّدة أمامي بالموت، لأنني لا أستطيع أن أساهم بالحل.
ماذا يعني أن أستمرّ في الكتابة، المملّة أحيانا، عما يحدُث؟ أو أن أعيد نشر ما يكتبه الآخرون في وسائل التواصل الاجتماعي بحماسةٍ وإلحاح؟ أو أن ألتقط صورا لأطفال العائلة وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، ويلوّنون خدودهم بألوان العلم الفلسطيني؟ أو أن أصفق لهم وهم يردّدون الإجابات النموذجية عندما أسألهم عن فلسطين وعاصمتها ومدنها؟ أو أن أدخل في معارك عابرة، وتافهة أحيانا، مع الذين انحازوا للعدو بكل صفاقة منذ اليوم الأول للمعركة؟ أو أن أحضر ندواتٍ ومحاضراتٍ وفعالياتٍ عما يحدُث تعقد في ظروفٍ مثالية لألتقط الصور في سياق فلسطيني خالص؟ أو أن أشجّع على جمع التبرعات، رغم أنني أعرف صعوبة أن تصل كما نشتهي شكلا وزمنا ومضمونا؟ أو أن أزيح والديّ وأخي الراحلين قليلا عن مقدّمة دعائي في صلاتي الليلية لأضع أطفال غزّة بدلا منهم؟
لا شيء حقيقياً سوى مداهنة ضميري، ومحاولة لإقناعه أنني أشاركهم في ما هم فيه من جهاد واستشهاد! وقد فشلت المحاولة.