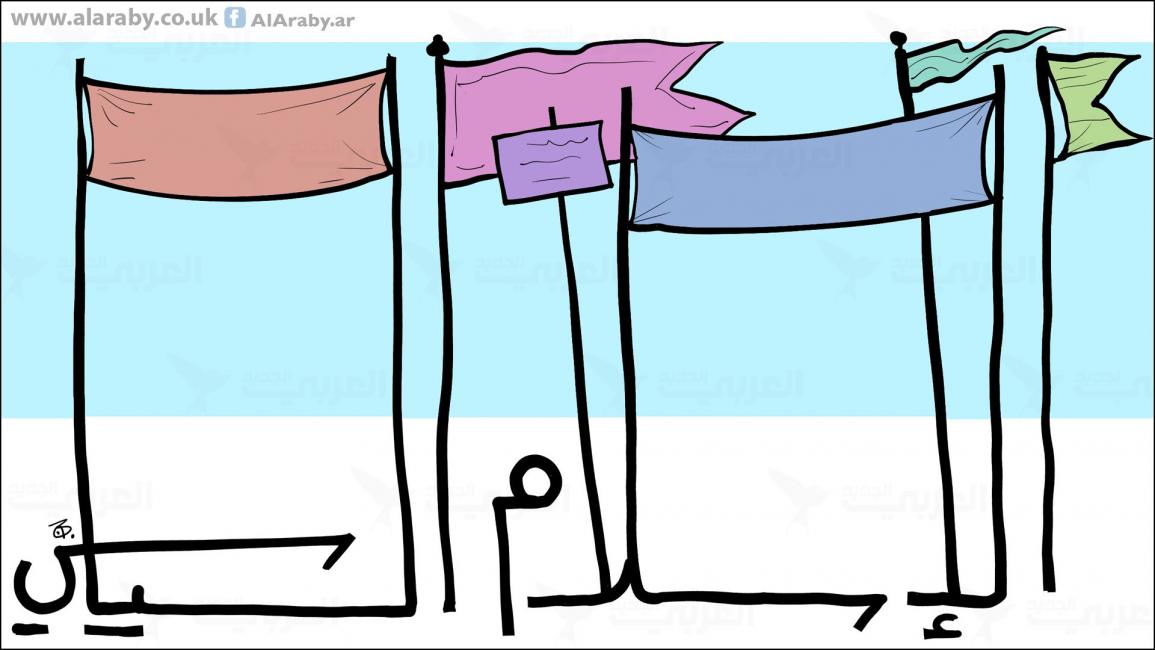11 نوفمبر 2023
عن "الإصلاح الديني" والإفساد الدنيوي

عبد الوهاب الأفندي
أكاديمي سوداني، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا. عمل بتدريس العلوم السياسية في بريطانيا منذ 1997، وكان قد عمل في الصحافة والدبلوماسية والطيران في السودان وبريطانيا. أحدث مؤلفاته "كوابيس الإبادة.. سرديات الخوف ومنطق العنف الشامل"
في سبتمبر/ أيلول من عام 2002، أي بعد مرور عام على أحداث "11 سبتمبر"، دعا مركز وودرو ويلسون في واشنطن إلى ندوة بعنوان: "ما هي الليبرالية الإسلامية"؟ وكان المبرّر، كما هو مشهور اليوم، الربط المبطن بين تلك الأحداث و"التطرّف الإسلامي"، والإيحاء بأن ما يسمى "الإصلاح الإسلامي" هو الحل لمشكلات العالم الإسلامي، بما في ذلك العنف وغياب الديمقراطية، ومعها مشكلات من يتعرّض لمثل هذه التهديدات من بقية البشر.
كنت من بين دعي إلى المشاركة في تلك الندوة التي نشرت مداولاتها في عدد خاص من دورية مختصة، ثم في كتاب. وكان تعليقي الأول أن الأساس الذي يقوم عليه السؤال خاطئ تماماً، ومن عدة أوجه. أولاً، لأن التيارات الليبرالية الديمقراطية التوجه في العالم الإسلامي لم تستق أفكارها من الإسلام، بينما التي كان لها أساس ديني، مثل الأحمدية في باكستان فنجدها معادية للديمقراطية. وفي المقابل، نجد أن حركات إسلامية عديدة تتحفظ على الليبرالية، كانت لها مساهمات معتبرة في دعم الديمقراطية، كما حركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في تركيا. إضافة إلى ذلك، فإن الحركات التي تصدت للنضال العنيف في المنطقة، إما من أجل تغيير الحكومات أو محاربة الاستعمار لم تكن في الغالب إسلامية أو مستندة إلى توجه ديني، متشدّداً كان أو معتدلاً. يكفي أن نتأمل الثورة الفلسطينية والثورات الأخرى (الكردية، الجزائرية، إلخ).
من جهة أخرى، ليس ما يسمى الإصلاح الإسلامي الذي يدعو إليه الداعون ضرورياً ولا كافياً لتأمين الديمقراطية. ولعل العبرة من تجربة الإصلاح الديني المسيحي أنها كانت فاتحةً للحروب الدينية التي مزقت أوروبا. وعليه، لو وقع في الإسلام "إصلاح ديني" مزعوم، فإن هذا سيكون فاتحة حروبٍ وصراعاتٍ لا أول لها ولا آخر.
تذكّرت هذا السجال، وسجالات أخرى مماثلة خلال السنوات الماضية، وأنا أتابع هذه الأيام ما تروجه بعض الزعامات الأكثر تمسكاً بالدكتاتورية والقمع من دعوة لانفتاح ديني. ولعلها
مفارقةً أن هذه الزعامات تنطلق من حجة مغايرة تماماً لحجة أصدقائنا في مركز وودرو ويلسون. فبينما كان الأولون يجادلون بأن الإصلاح الديني الإسلامي ونشر الليبرالية يقودان إلى الديمقراطية، فإن رأي الإصلاحيين الجدد هو أن "التطرّف الإسلامي" هو سبب نشر الديمقراطية و"الفوضى"، وأن الإخوان المسلمين هم المسؤولون حصرياً عن الربيع العربي وكل الثورات الديمقراطية في المنطقة. وعليه، فإن مقاومة التيارات الإسلامية، وترويج بديل ديني - سياسي "مخملي" هو الترياق ضد جائحة الديمقراطية ووباء الحرية.
وإذا كان هؤلاء "الإصلاحيون" عراة من ورقة توت الديمقراطية، فإن ما يتدثّرون به من تديّنٍ أقل ستراً وأكثر شفافية. فما ينفقونه في ساحة الدعوة لا علاقة له بالدين، وكل علاقة بالقمع والعنف من جهة، وبالدراهم والدنانير من جهة أخرى. فاستراتيجيتهم تقوم على قمع التيارات الديمقراطية أولاً، والإسلامية ثانياً، ثم بذل الملايين لكل ناعق وكل فئة تردّد ما يفصله هؤلاء من فتاوى.
وإذا نجحت هذه الاستراتيجية (والغيب كله لله)، فإن هذا سيكون أول إصلاح ديني في التاريخ قام به المنافقون. وقد تحدثت مرة في منبر إسباني (ويلاحظ أن إسبانيا، معقل محاكم التفتيش، كانت ولا تزال كاثوليكية، وهي أشد البلاد عداءً للإصلاح الديني، ومع ذلك تروج نقاشات عن "الإصلاح الإسلامي") عن تصور إمكانية نجاح مارتن لوثر في حركته الإصلاحية لو أنه كان يتحدث العربية، وتعلم في الأزهر. وقلت للجمع، تخيّلوا لو أن تاجراً أو فيلسوفاً ألمانياً كان قد سافر إلى القاهرة أو الأستانة أو بلاد الحرمين، ومكث سنواتٍ يدرس في الجامعات الإسلامية، ويتقن العربية والفارسية، ثم عاد بعد سنوات وهو يرتدي عباءةً وعمامة، وأطلق دعوته إلى الإصلاح، منبهاً مستمعيه إلى "الاستنارة" الموجودة في العالم الإسلامي. كم هي فرص أن يبقى الرجل حياً ليوم واحد، ناهيك أن يحقق النجاح، ويغير العقائد؟
فلماذا بربك يتخيّل بعض الواهمين احتمال نجاح أشخاصٍ ثقافتهم أجنبية بالكامل، وبعضهم لا يفهم من العربية حرفاً، في قيادة "إصلاح ديني"؟ ولعل ثالثة الأثافي هي ما شهدته مرة في العاصمة البريطانية من ترويج شابة كندية بنغالية الأصل، كتبت كتاباً عن "إصلاح الإسلام"، وهي تجاهر بأنها سحاقية، وتقدّم برامج في التلفزيون الكندي لترويج الظاهرة! وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن السيدة ضمّنت كتابها فصلين عن زيارتها إسرائيل، تتغزل فيهما بالدولة العبرية! فهل هناك استخفافٌ بالعقول والشعوب أكثر من هذا؟ كذلك نسمع هذه الأيام إن تجديد الدين في بلاد الحرمين يبدأ بفتح دور السينما والإكثار من حفلات الطرب ودعوة "السياح" الإسرائيليين إلى المدينة.
ولا أدري ما علاقة حب إسرائيل وكراهية عمرو موسى بظاهرة الإصلاح الديني المزعوم
عندنا، ولكن المروجين الجدد لهذا الانفتاح "الديني" يقتلهم الهيام بنتنياهو والوله بجاريد كوشنر، فليتهم يشرحون لنا ما الذي يحبّبهم في دولةٍ تمارس العنصرية ضد بني جلدتهم، ولو كانوا من سكانها لما تنازل أراذلهم، ناهيك عن سُراتهم، للتحدّث معهم. أي نوع من العلل هذا؟
مهما يكن، فإن أمر الدين، حتى الوثنية، ليس مما يتم حسمه عبر بذل الدنانير وشراء الذمم، أو حتى نصب المشانق والصلبان، وإحراق المتدينين في الأخدود والنار ذات الوقود. فكل حركةٍ دينيةٍ لا بد أن يكون لها مركب روحي أخلاقي. وإذا كان بعضهم يزعم أنه يتشبه بأتاتورك، فإن الأخير كان بطلاً قومياً، أنقذ تركيا من الاندثار، وتغنّى بمدحه الشعراء العرب، وكان يسمّى "الغازي" (أي المجاهد)، فما هو الرأسمال السياسي والأخلاقي لمن يروجون الإصلاح على نهجه (مع التذكير بأن الغازي أيضاً هو من أنتج ما نراه في تركيا اليوم، على الرغم من نجاحه الظاهري أولاً)؟
الخلاصة هي أن بناء إصلاح الدين على فساد دنيوي يبدأ بالكذب اليومي عبر إعلام مدجّن، ولا ينتهي بممارسة القمع وإسكات الأصوات، وتعذيب المعارضين من المؤمنين وغيرهم، هو من خطل الرأي. ونحن لا نرجم بالغيب، لكننا نرجّح أنه لن يحقق أدنى نجاح. وإذا نجح، فإنه سيكون بداية حروب دينية تأتي هي آخر ما تحتاج إليه البلدان المعنية.
كنت من بين دعي إلى المشاركة في تلك الندوة التي نشرت مداولاتها في عدد خاص من دورية مختصة، ثم في كتاب. وكان تعليقي الأول أن الأساس الذي يقوم عليه السؤال خاطئ تماماً، ومن عدة أوجه. أولاً، لأن التيارات الليبرالية الديمقراطية التوجه في العالم الإسلامي لم تستق أفكارها من الإسلام، بينما التي كان لها أساس ديني، مثل الأحمدية في باكستان فنجدها معادية للديمقراطية. وفي المقابل، نجد أن حركات إسلامية عديدة تتحفظ على الليبرالية، كانت لها مساهمات معتبرة في دعم الديمقراطية، كما حركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في تركيا. إضافة إلى ذلك، فإن الحركات التي تصدت للنضال العنيف في المنطقة، إما من أجل تغيير الحكومات أو محاربة الاستعمار لم تكن في الغالب إسلامية أو مستندة إلى توجه ديني، متشدّداً كان أو معتدلاً. يكفي أن نتأمل الثورة الفلسطينية والثورات الأخرى (الكردية، الجزائرية، إلخ).
من جهة أخرى، ليس ما يسمى الإصلاح الإسلامي الذي يدعو إليه الداعون ضرورياً ولا كافياً لتأمين الديمقراطية. ولعل العبرة من تجربة الإصلاح الديني المسيحي أنها كانت فاتحةً للحروب الدينية التي مزقت أوروبا. وعليه، لو وقع في الإسلام "إصلاح ديني" مزعوم، فإن هذا سيكون فاتحة حروبٍ وصراعاتٍ لا أول لها ولا آخر.
تذكّرت هذا السجال، وسجالات أخرى مماثلة خلال السنوات الماضية، وأنا أتابع هذه الأيام ما تروجه بعض الزعامات الأكثر تمسكاً بالدكتاتورية والقمع من دعوة لانفتاح ديني. ولعلها
وإذا كان هؤلاء "الإصلاحيون" عراة من ورقة توت الديمقراطية، فإن ما يتدثّرون به من تديّنٍ أقل ستراً وأكثر شفافية. فما ينفقونه في ساحة الدعوة لا علاقة له بالدين، وكل علاقة بالقمع والعنف من جهة، وبالدراهم والدنانير من جهة أخرى. فاستراتيجيتهم تقوم على قمع التيارات الديمقراطية أولاً، والإسلامية ثانياً، ثم بذل الملايين لكل ناعق وكل فئة تردّد ما يفصله هؤلاء من فتاوى.
وإذا نجحت هذه الاستراتيجية (والغيب كله لله)، فإن هذا سيكون أول إصلاح ديني في التاريخ قام به المنافقون. وقد تحدثت مرة في منبر إسباني (ويلاحظ أن إسبانيا، معقل محاكم التفتيش، كانت ولا تزال كاثوليكية، وهي أشد البلاد عداءً للإصلاح الديني، ومع ذلك تروج نقاشات عن "الإصلاح الإسلامي") عن تصور إمكانية نجاح مارتن لوثر في حركته الإصلاحية لو أنه كان يتحدث العربية، وتعلم في الأزهر. وقلت للجمع، تخيّلوا لو أن تاجراً أو فيلسوفاً ألمانياً كان قد سافر إلى القاهرة أو الأستانة أو بلاد الحرمين، ومكث سنواتٍ يدرس في الجامعات الإسلامية، ويتقن العربية والفارسية، ثم عاد بعد سنوات وهو يرتدي عباءةً وعمامة، وأطلق دعوته إلى الإصلاح، منبهاً مستمعيه إلى "الاستنارة" الموجودة في العالم الإسلامي. كم هي فرص أن يبقى الرجل حياً ليوم واحد، ناهيك أن يحقق النجاح، ويغير العقائد؟
فلماذا بربك يتخيّل بعض الواهمين احتمال نجاح أشخاصٍ ثقافتهم أجنبية بالكامل، وبعضهم لا يفهم من العربية حرفاً، في قيادة "إصلاح ديني"؟ ولعل ثالثة الأثافي هي ما شهدته مرة في العاصمة البريطانية من ترويج شابة كندية بنغالية الأصل، كتبت كتاباً عن "إصلاح الإسلام"، وهي تجاهر بأنها سحاقية، وتقدّم برامج في التلفزيون الكندي لترويج الظاهرة! وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن السيدة ضمّنت كتابها فصلين عن زيارتها إسرائيل، تتغزل فيهما بالدولة العبرية! فهل هناك استخفافٌ بالعقول والشعوب أكثر من هذا؟ كذلك نسمع هذه الأيام إن تجديد الدين في بلاد الحرمين يبدأ بفتح دور السينما والإكثار من حفلات الطرب ودعوة "السياح" الإسرائيليين إلى المدينة.
ولا أدري ما علاقة حب إسرائيل وكراهية عمرو موسى بظاهرة الإصلاح الديني المزعوم
مهما يكن، فإن أمر الدين، حتى الوثنية، ليس مما يتم حسمه عبر بذل الدنانير وشراء الذمم، أو حتى نصب المشانق والصلبان، وإحراق المتدينين في الأخدود والنار ذات الوقود. فكل حركةٍ دينيةٍ لا بد أن يكون لها مركب روحي أخلاقي. وإذا كان بعضهم يزعم أنه يتشبه بأتاتورك، فإن الأخير كان بطلاً قومياً، أنقذ تركيا من الاندثار، وتغنّى بمدحه الشعراء العرب، وكان يسمّى "الغازي" (أي المجاهد)، فما هو الرأسمال السياسي والأخلاقي لمن يروجون الإصلاح على نهجه (مع التذكير بأن الغازي أيضاً هو من أنتج ما نراه في تركيا اليوم، على الرغم من نجاحه الظاهري أولاً)؟
الخلاصة هي أن بناء إصلاح الدين على فساد دنيوي يبدأ بالكذب اليومي عبر إعلام مدجّن، ولا ينتهي بممارسة القمع وإسكات الأصوات، وتعذيب المعارضين من المؤمنين وغيرهم، هو من خطل الرأي. ونحن لا نرجم بالغيب، لكننا نرجّح أنه لن يحقق أدنى نجاح. وإذا نجح، فإنه سيكون بداية حروب دينية تأتي هي آخر ما تحتاج إليه البلدان المعنية.


عبد الوهاب الأفندي
أكاديمي سوداني، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا. عمل بتدريس العلوم السياسية في بريطانيا منذ 1997، وكان قد عمل في الصحافة والدبلوماسية والطيران في السودان وبريطانيا. أحدث مؤلفاته "كوابيس الإبادة.. سرديات الخوف ومنطق العنف الشامل"
عبد الوهاب الأفندي
مقالات أخرى
04 نوفمبر 2023
14 أكتوبر 2023
09 سبتمبر 2023