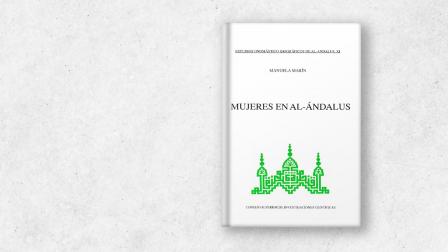كنت ذات يوم في بلد من "بلاد الله الواسعة"، بالقرب من شاطئ المتوسط، على أقدام أطلال الإسكندر المقدوني، ومولد "سيدي جابر"، أصعد مزهواً إلى حافلة شعبية، أذهب إلى لا شيء، سوى أن أجرّب وحيداً اكتشاف هذه المدينة، ومن عاداتي السيئة تلك، حبّ الاطلاع والتطفّل والتفرّج، كمشّاء لا يملّ من قطع المسافات ذهاباً وإياباً. عادةٌ أوقعتني في ورطة لم أتخيّلها.
كانت في تلك السنوات واقعة "أطفال الشوارع" (الحقيقيين) حامية الوطيس، تُكنس تحت سجادة "الوطنية في وجه المؤامرة". لم يقدني حظّي العاثر مثلما قاد ذلك الشاب الذي أراد أن يوثّق حقيقة وجود ما هو موجود. ويا لمفارقة زمننا الذي أيقظنا على أفلام عربية فيها ألف أوليفر تويست، ونحن "نقزقز اللب"، دون انتباه لما سيجري لاحقاً.
كأنني من تلك النافذة استللت بندقية، أو سيفاً، لا كاميرا تصوير، فرحٌ بها لأنها ستنقل لثقيلي الدم الغربيّين شيئاً آخراً عن عمران مدينة من مدننا، وهي تستنشق حياة المساء، حتى جاءتني الركلة الأولى من شابة (سيدة تضع في حجرها طفلاً) لم أكتشف بأنني أبدو أجنبياً إلا حين تلت الركلة صراخ استهجان: "هذا الأجنبي يصوّر ليشوّه". نصف ركاب الحافلة استنفروا تقريعاً وشتماً قبل أن أتفوّه بكلمة واحدة.
جمد الجمع حين سمعني أتحدث العربية وأقول لهم: لا أفهم ما هي مشكلتكم مع كاميرا تلتقط صورة عمران مدينة عظيمة؟
"أنت عربي؟"، وحتى لو لم أكن عربياً. ما هي مشكلة "المواطن الشريف المقهور في عيشته وفي حياته ومماته" مع الكاميرا؟ السيدة ذاتها التي بادرت بالصفع بدأت "تحوش الناس عني" حين دققت في لهجتي.
مساء ذلك اليوم من 2010 كان درساً لي: "يأتي الأجانب يصوّرون بلدنا على أنه بلد متخلّف وفيه أطفال متشرّدون" إلى آخر الموشح مكرراً، تذكّرت حينها "الجرسون"، وأنا أنطلق من المندرة، يقول: "حاذر يا صديقي. الكاميرا ستجلب لك مشاكل".
الإنسان المقهور في سيكولوجية غريبة التركيب أحياناً، والبعض يطلق عليها "متلازمة استوكهولم"، هو حجر زاوية صناعة "الفاشية الوطنية". هكذا تصنع عقله وتبرمجه "الدولة التي لا تخاف"، حتى من ظلها المكشوف وجسد الزعيم العاري...
لم أستطع أن أنسى تلك الحادثة، مراهناً على أن أياً منهم لم يحمل يوماً قوساً ولا نشاباً، ولا حتى سيفاً خشبياً، ولا من يكون علي الوردي الذي كتب عن سذاجة سريع التصديق والإنكار.
حلقوا شعر الشبان إذاً، فهم ينشرون "فكراً إرهابياً" إلى جانب "تكدير الصفو العام، وتوهين عزيمة الأمة"، كأني سمعت ذلك في دمشق ذات يوم، حتى تندّر الناس تنفيساً عن فتح الفم عند طبيب الأسنان؟ في ذلك الزمن، كانوا يوهمون الناس بأنهم يعرفون متى يتعاشرون.
رنّ فجأة صوت "الزعيم" وهو يكرّر حكاية، من مدينة عرفتُ شوارعها وحاراتها، حتى صارت مدينتي المفضّلة لولا زحمة الحقيقة الصامتة في شارع خالد بن الوليد. "أشباه دول"، والأصح أشباح، تصنع أكثر من كذبة على الكورنيش الجميل، عن "الشر والأشرار" و"الخوف ونقيضه من الشجاعة".
مرة واحدة فقط تألم القيصر في موسكو من فتيات احتججن عليه بالفن، قبل أن تفرط السبحة ويصبح هاجس القيصر أكبر من تبادل الكراسي مع رئيس وزرائه اليوم. لم أسمع في هذا الغرب ملكاً ولا رئيساً يهذي كثيراً عن الخوف والأشرار، إلا مرة حين كان رونالد ريغان يصنّف الدول، وبالطبع بوش من بعده. ولم أستطع خلال أيام تذكّر شيء بمثل هذا العبث المسرحي في تراجيديا التمثيل لإنسان مقهور يشكل مادة في حمل مكانس كنس الطرقات وكأن شيئاً لم يكن.
خلاصة درس "الزعيم"، الزاهد في كل شيء: الفن شر، والثقافة والصحافة والفكر والكلمة حتى... لذا، في "بلاد الله الواسعة" يستنفر الجمع لدرء الشر كله، من أوله إلى آخره.