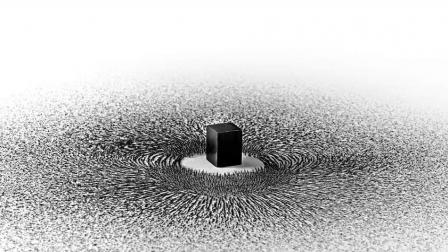إذا قلنا إن لكلّ كاتب مصنعه، فالمقصود أن لكلّ كاتب أسلوبه. لا يحتوي المصنع على جدران وتأمّلات في فراغ، ونافذة للإطلال على العالم فقط، إنما بالدرجة الأولى على أدوات، هي التي تصنع عمله الأدبي.
نفترض مثلاً، أن الروائي يجب أن يتميّز بالخبرة والمهارة والحرفية والذائقة والثقافة، إن لم يتوفّر شيء ملموس منها، فلن يحصل مثلاً على رواية جيدة، وهو ملخّص معقول، كي لا نخوض في المجهول.
أما عن الإلهام والموهبة، فلن يكون لهما الأولوية، والسبب أنه مشكوك بهما، نريد التحدّث عن أدوات نثق بها، لا عناصر غامضة، خاصةً أنه يمكن، بقدر من الجهد والعرق، الاستعاضة عنها بما يؤدّي إليها. فالكاتب ليس في انتظار ما قد يأتي أو لا يأتي، أو يتأجّل إلى يوم آخر، بل ما يُعِدّ له بتحضيرات تسبقه، اعتاد عليها؛ فنجان قهوة، سجائر، مزاج رائق، أو متوفز، وربما منشّطات، وإن كان أفضل ما يفيد الكتابة هو التنبّه والوعي، ولديه ما يقوله، ولو كان غير واضح تماماً، وهو أمر لا يجوز التهاون فيه.
يجلس الروائي وراء طاولته ساعات كي يكتب صفحة، وربما صفحتين، مع أنه يمكن كتابتها بأقلّ من نصف ساعة، أما الجهد الذي يصرفه على هذه الصفحة، ففي قدح الذهن تارة، والتأمّل تارة أخرى، خلالها تتشارك عدّة عوامل يصعب إحصاؤها، كمثال لها تلك التشكيلة المختصرة السابقة، وما يُضاف إليها من أشياء حتى الروائي نفسه قد يجهلها، مثل اللاوعي، العقل الباطن، الأحلام، التداعيات، الذكريات، وما يُدعى بالكتابة التلقائية والميكانيكية.. أخيراً قد يشطب في اليوم التالي، ما أنجزه في هذا اليوم.
وإذا كان لتلك الأشياء الغامضة المشاركة، نصيب في صناعة ما كتبه، ووصفها بالإلهام أو الموهبة، فقد يبني عليها شخصيات وأحداثاً، أو تتبدّد وتعود الورقة بيضاء. ولئلا نقلّل منهما، فربما كان الإلهام ومعه الموهبة، كناية عن اللاحم الذي يشبك هذه العناصر مع بعضها بعضاً، طبعاً مع إدراك ما يرغب في التعبير عنه، وينحو إلى توصيله للقارئ. فالكتابة لا يغيب عنها القصد ولا العمق وأيضاً الحذر، كذلك الدقّة والمداورة... كما لا بدّ من توافر الإرادة، مهما كانت، تطلّعاً إلى الشهرة أو المال أو البحث عن الحقيقة والمعنى، أو كلّها مجتمعة، خاصة أن الدروب إليها تتقاطع، ولا يهمّ إن كانت الحقيقة والشهرة والمال، وما يزيد عنها، ما دام هذا الخليط يرفد بعضه بعضاً. فالكاتب ليس مثالياً، وإن ادّعى ذلك، وأحياناً، إن لم يكن غالباً، يقبل على المنكرات أكثر من غيره، بحجّة قد تكون كاذبة؛ التعرّف إلى الحياة.
فالعمل الأدبي ليس تلقائياً بحتاً، ولا حصّة معلومة منه. إنه عملية بحث وتركيب وبناء وذائقة ومهارة وتوق.. وطبعاً عدم إغفال الثقافة. إن عدم توافرها أو ضعفها، يعني أن الكاتب متخلّف، ليس عن العصر فقط، بل عن البشرية في سعيها نحو المعنى، فهو ليس بوارد اختراع العجلة بدلاً من الاستفادة منها، فالقديم لا يموت في الأدب، بل تعمل الثقافة على تجديد استيعابه لا إلغائه، فالأمر ليس التقدّم كيفما اتفق، طالما الأشكال القديمة في قلب الأشكال الجديدة. إن النزعة نحو الإلغاء باطلة، لا يمكن إلغاء شيء إلا باحتوائه.
لا يكتب الروائي بمعزل عن البشر، رغم أنه يكتب في عزلة، لا تمنعه عن الإحساس بهم، إن فقدانه يُفقد روايته الإحساس بالحياة، ولا شكّ أن في حضور السؤال الأخلاقي وعدم تغيبه، العنصر الذي يبرّر العملية الكتابية برمّتها، سواء سلباً أو إيجاباً.
أما الأكثر، فليتنا نعرف.