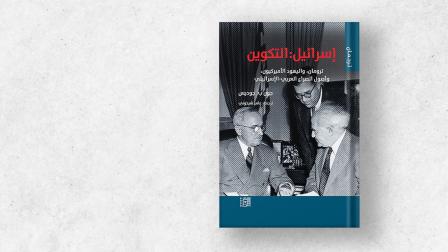في السنوات الأخيرة برزت لدينا الكثير من المقالات التي تستعيد ما حدث وما يحدث في القدس من مقاومة سكان المدينة القديمة للتهجير، أو التدمير للبيوت الفلسطينية من قبل أصحابها لعجزهم عن دفع نفقات تدميرها من قبل بلدية الاحتلال، والقليل من المؤلّفات الجادّة التي تحمل رؤية جديدة عن مكانة القدس في العقود الأربعة الأخيرة التي سبقت تقسيمها إلى شرقية وغربية في 1948. من هذه المؤلّفات القليلة كتابُ الباحثة نائلة الوعري، "القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية: 1908 - 1948"، الصادر حديثاً عن "المؤسّسة العربية للدراسات والنشر".
ومَن يتابع التاريخ الحديث للقدس وفلسطين، يقدّر لابنة القدس عملها المتواصل، وبخاصّة ما نشرته من كتب مثل "دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين، 1840 - 1914" (عمّان، 2007) و"موقف الوُلاة والعلماء والأعيان والإقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني: 1856 - 1914" (عمّان، 2011).
ويبدو أن الوعري، بعد أن غطّت الفترة المذكورة المهمّة في تاريخ فلسطين، عملت في السنوات الأخيرة على مشروع أكبر يغطي الفترة اللاحقة، التي اتّسمت بأمرين مهمّين: بروز الكيانية الفلسطينية، وتضخّم مكانة القدس، سواء في فلسطين أو في المحيط العربي والعالَم الإسلامي مع هبّة البُراق في 1929 ومؤتمر القدس في 1931 والثورة الفلسطينية (1936 - 1939)، حتّى أصبحت مقرّاً لثلاثين قنصلية لدول تمتدّ من الهند إلى أميركا اللاتينية.
أمّا الأمر الأوّل، فقد ارتبط بتأسيس متصرّفية القدس عام 1874، التي استقلّت عن جوارها وأصبحت مرتبطةً مباشرةً بالباب العالي، وأصبح المتصرِّف يُعرف باسم "حاكم فلسطين"، كذلك أخذت متصرّفية القدس تظهر في الخرائط العثمانية عشيّة 1908 باسم فلسطين، حيث إنها اشتملت على نحو 81% من مساحة فلسطين بحدودها المعروفة في 1918. ومن هنا، فإنّ تأسيس متصرّفية القدس نال ما يستحقّه من المؤلّفة إذا ما نظرنا إليه باعتباره نواة الكيانية الفلسطينية التي تفتّتت لاحقاً مع النكبة (1948) والخلافات بين القادة العرب حول مستقبل "فلسطين العربيّة".
قد يُفاجأ الجيل الجديد حين يقرأ أحوال القدس قبل 1948
أمّا الأمر الآخر، فهو النموّ السريع للقدس حتى أصبحت "عاصمة فلسطين السياسية والروحية"، بحسب تسمية المؤلّفة. وتوضّح الوعري كيف أن القدس بقيت محصورة ضمن الأسوار حتى 1856، أي ضمن مساحة تتجاوز بالكاد كيلومتراً مربّعاً، بينما نمت القدسُ الجديدة بسرعة، خارجَ السور، حيث وصلت مساحتها الإجمالية إلى 5 كيلومترات مربّعة حتى نهاية الحكم العثماني في نهاية 1917، ويمكن القول إن تطوّرها توقّف، أو أخذ ينكمش، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914، وما صاحبها من تجنيد وتهجير.
لكنّ التطوّر الأكبر للقدس حدث خلال 1920 - 1948، مع التطوّرات العمرانية والسياسية والثقافية والصِّلات وافتتاح العديد من القنصليات والممثّليات وغيرها، حتى وصلت مساحتها إلى 20 كيلومتراً مربّعاً في 1948، لتمتد في طريق يافا التي كانت تسمى "اسكلة القدس".
وقد يُفاجأ الجيل الجديد حين يقرأ في الكتاب أن "الإذاعة الفلسطينية" أُنشِئت في 1936 لتكون الثانية بعد إذاعة القاهرة (1935)، واشتهرت بلازمتها "هنا القدس"، واستضافتِها للكتّاب والفنّانين من بلاد الشام ومصر، كذلك أصبح مطار القدس (قلنديا) من أكبر المطارات في الشرق الأوسط، بينما كان "الجنيه الفلسطيني" عملة وازنة، وهو الذي بقي يُستعمل في شرق الأردن حتى 1946. وفي هذا السياق، أصبحت ضواحي القدس الجديدة تعجّ بالفيلّات والقصور التي تُبرز مكانة العائلات الفلسطينية التقليدية المتنافسة في السياسة كما في العمران.
وهذا الأمر لم يكن بالسهل تصوّره لولا وجود بلدية واعية لدورها، وهو ما تركّز عليه المؤلّفة في كتابها، باعتبار أنّ القدس احتضنت أوّل بلدية في الولايات العربية (1863)، أي بعد إسطنبول مباشرةً، وهو ما رتّب على البلدية مهامَّ عديدة لرعاية الحاجات المختلفة للمدينة المتنامية التي أصبحت من اختصاصها بعدما كانت مهملة أو متروكة لـ"المحتسِب".
ومع اعتبارها للقدس "عاصمة فلسطين السياسية والروحية"، تحرص المؤلّفة على توضيح أهمّية القدس للديانات السماوية الثلاث، فقد كانت تجذب إليها الكثير من أتباع هذه الديانات للزيارة والحجّ والمجاورة، وكانت هذه الأخيرة تؤدّي أحياناً إلى الإقامة الدائمة.
ومع التطوّر الاقتصادي والاجتماعي الكبير بعد عام 1920، انجذبت إلى القدس أعداد كبيرة من القرى المجاورة للدراسة والانخراط في الوظائف المدنية والأمنية (الشرطة الفلسطينية) والشركات الاقتصادية والمصارف التي دخلت في منافسة مع تلك اليهودية، ليقفز بذلك سكّان القدس إلى نحو ربع مليون (244,445)، في وقتٍ كان عدد سكّان فلسطين فيه يقترب من المليونين (ص 173).
صحيح أن هذا العدد كان يعزّز القدس باعتبارها "العاصمة السياسية والروحية"، ولكنّ الوعري تذكر أيضاً أن تل أبيب كانت قد نمَتْ بسرعة شمال يافا في الفترة المذكورة، حتى وصلت بسكّانها إلى العددَ المذكور. لكنّ الفارق بين المدينتين كان أن القدس كانت وبقيت "عاصمة فلسطين السياسية والروحية"، أي التي تمثّل كلّ الطوائف فيها، بينما خُطّطت تل أبيب لتكون "مدينة يهودية" بامتياز، حتى إنّ المهاجرين اليهود الذين جاؤوها من أوروبا الوسطى في ثلاثينيات القرن الماضي هرباً من الاضطهاد النازي وضمن سياسات الهجرة الصهيونية، فوجئوا بوجود هكذا "مدينة أوروبية في الشرق".
نظراً إلى أن عنوان الكتاب يُبرز القدس باعتبارها "عاصمة فلسطين السياسية والروحية"، فقد كان من المهمّ تركيز المؤلّفة على القيادة السياسية للشعب الفلسطيني بعد 1920، ومدى مسؤوليّتها عمّا آل إليه الحال في 1948. وكانت بريطانيا قد أخذت بتجربة النمسا بعد احتلالها للبوسنة في 1878 وشكّلت للمسلمين مجلساً يمثّلهم ويُنتخَب رئيسه من قِبَلهم مع تصديق الحاكم عليه، ليتولّى بشكل خاص أمورَهم الدينية والتعليمية والأوقاف.
تدرس مسؤولية القيادة الفلسطينية بعد 1920عن النكبة
وبهذا الشكل برزت، مع الحراك الجديد للشعب الفلسطيني منذ 1920، قيادة جديدة تمثّلت بشخصية الحاج محمد أمين الحسيني، الذي أصبح في 1921 رئيساً لـ"المجلس الإسلامي الأعلى"، مع تعيين منافس له من آل النشاشيبي على رأس بلدية القدس، ليصبح التنافس بين العائلتين (مع المتحالفين معهما) سمة الموقف حتّى تأسيس "اللجنة العربية العليا" في 1936 برئاسة الحسيني وتمثيل القوى السياسية الأخرى.
لكنّ المشكلة أن الحسيني، الذي تُقرّ المؤلّفة بفضله في تكريس البُعد العربي والإسلامي للقدس وفلسطين، بقي من 1937 حتى 1948 قائداً مقيماً في الخارج (لبنان والعراق وألمانيا النازية ومصر المَلكيّة)، بينما اندلعت في الداخل صراعات وصلت إلى حدّ الاغتيالات للتخلّص من المعارضين لـ"المجلسيّين"، كما كان أنصار الحسيني يُسَمّون.
وفي تقييمها للحاج الحسيني، بعد تقدير دوره في البداية، تأخذ الوعري عليه "تأخّره في توجيه الشعب الفلسطيني نحو المقاومة والمواجهة الميدانية مع حكومة الانتداب حتى 1929"، و"غياب عنصر المناورة في نشاطه السياسي"، و"تفرّده بالرأي وعدم استفادة المعارضة (...) ما أدخل فلسطين في نفق مظلم يعجّ بالإشاعات والاتّهامات والاغتيالات" (ص 256). ومن هنا تُرك الشعب الفلسطيني دون قيادة في أيار/ مايو 1948، حيث لم يبقَ في القدس من أعضاء "اللجنة العربية العليا" سوى أحمد حلمي عبد الباقي الذي عيّنه الملك عبد الله حاكماً عسكرياً على القدس بعد دخول القوّات الأردنية إلى المدينة.
ولكنّ المشكلة أيضاً كانت مع الجوار، وبالتحديد مع الزعامات العربية. فقد رأى الحسيني نفسه جديراً بأن يكون زعيماً لفلسطين وأن يُعامل كزعماء المنطقة الذين كانت لهم حساباتهم المختلفة حول "فلسطين العربية". وهنا كان التنافر بين الملك عبد الله الذي كان له مشروعه في المنطقة، والحاج الحسيني الذي "شكّل حكومة عموم فلسطين، ورأى فيها الأردن منافسة لسيادته على الضفّة الغربية وفي مقدمتها القدس (...) ممّا أدّى إلى توتّر العلاقات بين الملك عبد الله والحاج أمين الحسيني" (ص 224).
وفي الحقيقة، كان يجدر أن يتّسع الكتاب لفصل آخر عن "حكومة عموم فلسطين"، لأنها تبيّن الدور العربي في ما حصل للقدس وفلسطين في 1948. فحسب المؤلّفة، كان الحاج الحسيني هو مَن ألّف "حكومة عموم فلسطين" (ص 223-224)، ولكن من المعروف أن أحمد حلمي استقال من منصب "الحاكم العسكري للقدس" لكي يقبل بعرض الجامعة العربية ليكون رئيساً لـ"حكومة عموم فلسطين" التي أُُعلنت في غزّة في 1/ 10/ 1948.
ولكنّ "تسلُّلَ" الحسيني من القاهرة إلى غزّة وتدخّلَه للسيطرة على الحكومة، جعلَ الحكومة المصرية تشحنه بالقوّة في سيارة عسكرية إلى القاهرة، وتنقطع بذلك العلاقة بين الثلاثي (الملك عبد الله والحاج الحسيني وأحمد حلمي)، ليضع الملك عبد الله الضفّة الغربية تحت الحكم الأردني الانتقالي، ويبقى أحمد حلمي إلى وفاته في 1963 "رئيسَ حكومة فلسطين" التي لم تعد موجودة إلا في الجامعة العربية، بينما غادر الحاج أمين الحسيني مصر الناصرية (التي لم تكن تحتمل أكثر من زعيم) إلى لبنان، وبقي فيه حتى وفاته (1974) يحمل لقب "رئيس المجلس الإسلامي الأعلى".
في النهاية، لا بدّ من ذِكْر ميزة الكتاب في اعتماده على المصادر، وخاصّة سجلّات محكمة القدس الشرعية، وعلى أرشيف واسع للصحافة الفلسطينية (بين عامَيْ 1908 و1948) وفي اختيار المؤلّفة لصور وخرائط مناسبة، منها ما يُنشر لأوّل مرة، تدعم ما جاء في كتابها.
يحمل الكتاب جديداً في الرؤية والمعالجة، ويفيد بشكل خاصّ كمرجع عن تلك المرحلة الفاصلة التي حملت الكثير من الآمال وآلت إلى الاحباط في تمّوز/ يوليو 1948، مع تقسيم القدس إلى شرقية وغربية، ورسم الخطّ الأحمر الفاصل بينهما، مع ترك "منطقة محرّمة" أخذت نسبة 4.4% من مساحتها، بحيث لم يبقَ للعرب من إجمالي مساحة القدس سوى 11.48%، وحتى هذه أكمل المشروع الصهيوني الاستيلاء عليها في عام 1967.
* كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري